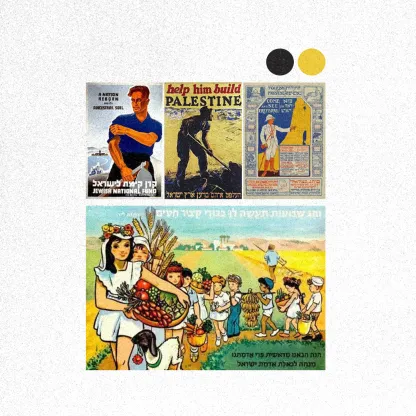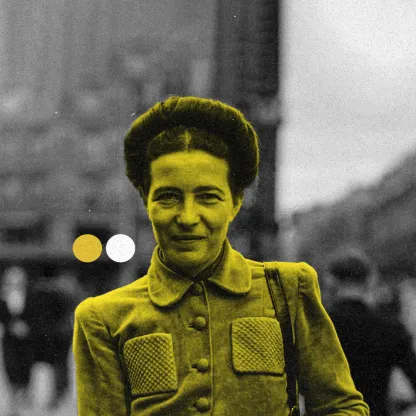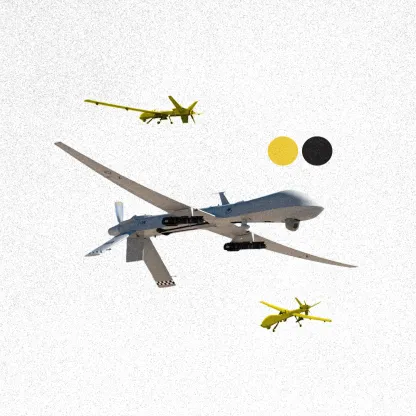هذه ترجمة لمقالة "Spaces between the Stars" لأستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة ييل، ديفيد بروميتش، الذي يستعرض فيها السمات الفريدة لتجربة المخرج الأميركي ستانلي كوبريك، الذي يُعد أحد أبرز المجددين في تاريخ السينما.
ـــــــــ
واجه كبار المخرجين الأميركيين تحديًا مشتركًا تمثل في اضطرارهم إلى الالتزام بالذوق العام نتيجة الولاء للديمقراطية، إضافةً إلى القيود المالية، الأمر الذي دفعهم إلى احترام ذوق الجمهور. لكن هذا لم يكن بالضرورة مطلبًا قهريًا، فالأفلام الصامتة في نهاية المطاف استُلهمَت من الأدب الشعبي لكُتّاب مثل بلزاك وديكنز، وهذا ما أضعف من معنويات معظم المخرجين، باستثناء المخضرمين والأكثر حنكة من بينهم.
كان هناك ضغط مستمر لاتباع صيغ مجربة وناجحة من خلال اختيار ممثلين يضمنون نجاح الفيلم، والبحث عن القصص التي لن تسيء إلى جمهور معين. في النهاية، لم يكن هناك مفر من تلك الخطوط العريضة. وعلى الرغم من أن مخرجًا مبدعًا وفريدًا مثل هاورد هوكس تمكّن من تجاوز التوقعات بأفلام مثل "الوجه ذو الندبة" (Scarface)، و"فتاة الجمعة" (His Girl Friday)، لكن أسلوبه تحل في النهاية إلى نمطٍ متكرر، ما جعل فيلم "النهر الأحمر" (Red River), يفسح المجال لأفلام مثل "ريو برافو" (Rio Bravo)، و"ريو لوبو" (Rio Lobo).
كان الخروج الجدي عن مسار الاستوديوهات الكبرى يعني الفشل الحتمي للمخرج. لكنه، مع مرور الوقت، قد يُكرّم بوصفه رمزًا في عالم السينما المستقلة. ويُعد المخرج السينمائي ستانلي كوبريك الاستثناء الأبرز لهذه القاعدة كما يوضّح روبرت كولكر ونيثان أبرامز في كتابهما "Kubrick: An Odyssey"، بفضل امتزاج حظه مع ثقته العالية بالنفس.
يُعتبر الكتاب صورة شاملة عن حياة كوبريك، حيث يقدم بتسلسل منتظم تقريبًا كل ما قد يرغب باحث أو معجب بمعرفته عن كوبريك، إذ يتتبع العديد من الموضوعات المتكررة والمشتركة بين أفلامه وتجاربه الشخصية وما أدرجه منها في أفلامه.
الصورة الفوتوغرافية انعكاس للحياة
خلال الثلاثين عامًا الأخيرة من حياته، أصبح ستانلي كوبريك رمزًا معقدًا يصعب التعمق فيه من الخارج. وبصفتي متابعًا عاديًا، قرأت إلى جانب سيرته الذاتية الدراسات النقدية الكاملة لديفيد ميكس وجيمس ناريمور، وشاهدت الفيلم الوثائقي الممتاز لجان هارلان "ستانلي كوبريك: الحياة في صور"، وتصفحت جميع محتويات "أرشيف ستانلي كوبريك" الذي حررته أليسون كاسل، وهو عمل ضخم يحتوي على مقالات مفصلة عن كل فيلم لكوبريك، بالإضافة إلى مقابلات متنوعة ومقتطفات من مذكرات ومراجعات منشورة وصور تم التقاطها في مواقع التصوير وخارجها. قد يكون من الصعب على الأشخاص غير المطلعين الخوض في ذلك، لكن التجربة في رأيي تستحق العناء.
ينقسم عشاق سينما كوبريك عادةً بين فيلمين: "دكتور سترينجلوف" (Dr. Strangelove)، و"2001: ملحمة الفضاء" (2001: A Space Odyssey). أنا أنتمي إلى المجموعة الأولى، لكنني أُقدِّر وجهة نظر المجموعة الثانية، حيث يعتمد اختيارك على ميولك بين الفيزياء والميتافيزيقا.
يتناول فيلم "2001"، كعمل خيالي، فكرة تجدد وتحول الحياة البشرية، وكان يُعد امتدادًا طبيعيًا للأفلام التي كانت تصوّر نهاية العالم بتقنية الأبيض والأسود. أما "دكتور سترينجلوف"، الذي ظل يُعرض في دور السينما بعد تعلمي عن آثار القنبلة الهيدروجينية، فقد لفت انتباهي ليس بسبب تحذيراته السياسية، بل بسبب مصداقية الرحلات المتوازية في القصة: التقدم المميت للطائرة (B-52) فوق البراري المتجمدة في القطب الشمالي، والبروتوكولات التي يلتزم بها الرئيس، والقرارات التي يتخذها مستشاريه العسكريين في غرفة الحرب المظلمة.
وُلد ستانلي كوبريك في حي برونكس عام 1928، كابن لطبيب ناجح في الحي. كان والده جاك كوبريك ووالدته جيرترود يهوديين علمانيين مثقفين، وكانت المكتبة في البيت مليئة بالكتب، كما كان لدى جاك كاميرا بحجم 16 ملم مناسبة لتصوير الأفلام المنزلية.
في عيد ميلاده الثالث عشر، وبدلًا من إقامة احتفال بار ميتزفه، حصل ستانلي على كاميرا "Graflex Speed Graphic"، وهي كاميرا كان يفضلها مصورو الصحافة آنذاك. في المدرسة، تفوق في مادة العلوم لكنه وجد معظم المواد المقررة مملة، كما لم تكن درجاته كافية للقبول في الجامعة بمتوسط تراكمي بلغ 67. لكن لم تكن خيبة الأمل تلك ذات تأثير كبير. ففي سنته الأخيرة في المدرسة الثانوية، بدأ كوبريك في نشر صوره في مجلة "لوك"، ووفرت له الوظيفة الثابتة هناك مصدر رزق للسنوات الأربع التالية، حيث تعلم الكثير عن العالم من خلال السفر والمهام المتنوعة التي كُلف بها.
تُظهر صور ستانلي كوبريك لمجلة "لوك" قوة وحدّة لافتتين، حيث كانت تُلتقط اللحظة فيها بشكل نهائي ومؤثر. لم تكن مجرد صور توضيحية، بل امتلكت سمة فريدة تجمع بين العشوائية والتنظيم المدروس، كما في أعمال المصور ويجي. في إحدى الصور، يظهر مدير السيرك جون رينجلينج نورث في الجانب الأيمن من الإطار، يوجه أوامره لشخص خارج المشهد، بينما على الجانب الأيسر العلوي، تتدلى فتاتان من إطار دراجة هوائية، يقسم بينهما عمود التوازن الذي يحمله راكب الدراجة. وفي صورة أخرى، يظهر عالِم يعمل على معدن أبيض ملتهب، محميًا من الضوء الساطع بواسطة نظارات قاتمة.
قام كوبريك أيضًا بتصوير شخصيات مشهورة مثل مونتغمري كليفت وروكي جرازيانو، وكان منهجه في التصوير يعتمد على الواقعية بدون استخدام الخدع، لكنه أضاف الدراما بمهارة عندما طلب من بائع جرائد أن يقف متأملًا أمام عنوان "وفاة روزفلت"، مُبديًا حزنًا أكبر. عندما تجاوب البائع، أصبحت الصورة مُعبرة عن "أمة في حداد". أخبر كوبريك جاك نيكلسون في وقت لاحق أن الصورة الفوتوغرافية هي مجرد انعكاس للحياة: "لكن في السينما قد يختلف الأمر بعض الشيء، فأنت لا تسعى إلى تصوير الواقع بل لتصوير تصورك للواقع". ربما كان يؤمن بأن الفيلم يعكس واقعية أعمق من خلال تجريده المتعمد، حيث اعتبر أن الواقع هو طابق سفلي غير مرئي من الصعب الوصول إليه. وعند بلوغه، يصبح من الصعب التعامل معه.
في حي برونكس الذي نشأ فيه كوبريك، كانت هناك دار سينما تقريبًا في كل زاوية. وكما ذكر في مقابلة مع جيرمي بيرنستين عام 1966: "كنت أذهب لمشاهدة الأفلام.. كل فيلم تقريبًا". في ذلك الوقت، لم تكن دور العرض المهتمة بالفنون موجودة بشكل كبير، لكن من الممكن شراء تذكرة لمتحف الفن الحديث، حيث كانوا يعرضون أفلامًا لأمثال تشارلي تشابلن وغريفيث وفون شتروهايم وأيزنشتاين ومورناو وبابست ولانغ.
يبدو أن كوبريك كان يشعر بتقدير كبير لعظماء عصر السينما الصامتة دون أن يمتزج هذا الشعور بالغيرة. أما الأفلام الأميركية النموذجية في الأربعينيات، فقد دفعته للشعور بشيء مختلف: كان متأكدًا من قدرته على صنع شيء أفضل. بالنسبة لكوبريك، وكما أشار مايكل هير، صديقه وشريكه في كتابة سيناريو "Full Metal Jacket": "كان هناك بالتأكيد ما يُسمى فيلم سيئ، لكن لم يكن هناك فيلم لا يستحق المشاهدة".
في لحظة مشحونة بالحماس، صرّح كوبريك بأن "العرّاب" قد يكون أعظم فيلم تم صنعه على الإطلاق. وعندما تم سؤاله عن ذلك، تراجع قليلًا ليقول إنه الفيلم الذي يضم أعظم طاقم ممثلين. وهذا يكشف نقطة مثيرة حول عمل كوبريك مع الممثلين. في أفلامه، يمكنك أن تجد أداءات استثنائية من ممثلين مثل جورج س. سكوت، وجيمس ماسون، وبيتر سيلرز، وكيرك دوغلاس، ونيكول كيدمان، وستيرلينغ هايدن. وفي الأدوار الأصغر، هناك سليم بيكينز، وبيتر أوستينوف، وسو ليون، وسيدني بولاك. ومع ذلك، لم يكن هناك شعور بالانسجام الجماعي. فالممثلين، وكذلك الشخصيات، بدوا وكأنهم أفراد مستقلون كل منهم يعيش في عالمه الخاص.
في عام 1951، قدّم ستانلي كوبريك فيلمه الوثائقي القصير الأول "يوم القتال" (Day of the Fight)، الذي تناول حياة الملاكم المحترف والتر كارتييه، بما في ذلك تفاصيل حياته اليومية وتدريباته، لينتهي بمشهد المباراة مع تسجيل كل ضربة بشكل واضح. وعلى الرغم من أن الفيلم لقي إشادة واسعة، إلا أنه لم يُثمر عن عروض جديدة لكوبريك.
في مقتبل العشرينات من عمره، وبشعور قوي بنفاد الصبر، قرر كوبريك أن يخوض تجربة إنتاج فيلم طويل، فكانت النتيجة فيلم "الخوف والرغبة" (Fear and Desire) في العام التالي. في هذا العمل، قام كوبريك بنفسه تقريبًا بكل المهام، من الإخراج إلى الإضاءة، والتصوير، والتشغيل، والإدارة، ووضع المكياج، وتصميم الأزياء، وتصفيف الشعر، وتنسيق الدعائم، وحتى قيادة فريق العمل. اتسمت مسيرته المهنية بهذا التفاني الشامل والسيطرة الكاملة. وقد أشار تيري ساذرن إلى أن عملية صناعة الأفلام عند كوبريك: "تبدأ بفكرة بسيطة، وتستمر عبر مراحل كتابة النص، والتدريبات، والتصوير، والتحرير، وإضافة الموسيقى، والعرض، وحتى التعامل مع الشؤون الضريبية".
يروي فيلم "الخوف والرغبة" قصة أربعة جنود في مهمة للسيطرة على طوف، وتوجيهه عبر نهر بغرض اغتيال جنرال عدو. يتميز السيناريو بجوٍ جاد وشاعري، حيث يعلن الراوي في البداية عن تقديمه للنص التالي: "لا حرب قد خيضت، ولا واحدة ستُخاض لاحقًا، بل هي أي حرب.. هؤلاء الجنود الذين ترونهم يحتفظون بلغتنا ووقتنا، ولكن ليس لهم وطن سوى العقل".
لم يُظهر كوبريك في مرحلة نضوجه أي شعور بالتفاخر تجاه الفيلم، معتبرًا أنه لم يعلمه سوى كيفية صناعة الأفلام، وإمكانية إنتاجها. ومع ذلك، تطلب الأمر منه شجاعةً كبيرة لمواجهة التحديات التي واجهت فيلمه. وفي خضم الحرب الكورية، تميز "الخوف والرغبة" بغياب أي لمحة من التفاؤل. عُرض الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، ثم في دور عرض في نيويورك. وكان من الممكن أن يُعتبر بمثابة انطلاقة لفنان معاصر ينتمي لمفهوم "لا وطن له سوى العقل".
كان لدى كوبريك خططًا مختلفة لأفلامه المستقبلية، فقد كان يهدف إلى أن يكون فيلمه التالي شيئًا ينتمي إلى نوع سينمائي يحظى بقبول جماهيري. كانت الدراما الإنسانية توفر ذريعة بسيطة للإثارة، وتمثلت عنده في مشهدين حركيين: مطاردة طويلة ومعركة يدوية. طلب من زميله في المدرسة، هوارد ساكلر، الذي كتب سيناريو "الخوف والرغبة"، أن يكتب نصًا بسرعة من أجل: "استغلال الفرصة للحصول على بعض المال".
تعكس هذه الكلمات ظروف كوبريك في عام 1955، حيث كان يعتمد على مساعدات البطالة لدفع فواتيره، إضافةً إلى دخله من لعب الشطرنج مقابل ربع دولار في ساحة واشنطن. قال إنه كان يكسب ما بين دولارين وثلاثة دولارات في اليوم، وهذا: "يكفي لمدى بعيد إذا كنت لا تشتري شيئًا سوى الطعام".
في مشهد المطاردة من فيلم "قبلة القاتل" (Killer's Kiss)، يركض البطل، الذي يطارده القاتل، حول حافة سطح مصنع بحثًا عن مخرج. في هذه الأثناء، تراقبه الكاميرا الثابتة لمدة دقيقة كاملة: يبدأ كالنقطة المتلاشية في الأفق، ثم يكبر تدريجيًا مرة أخرى. تُجسِّد هذه اللقطة شعورًا بالعبث. بعد ذلك بقليل، تأتي المعركة مع القاتل في غرفة التخزين، حيث تتضمن أسلحة الرَجلين أطرافًا وجذوعًا من الدمى، وفأسًا، ورمحًا.
استحوذ فيلم "قبلة القاتل" على انتباه جيمس هاريس، الكاتب والمنتج المستقل، ودفعه إلى الاتصال بكوبريك واقتراح شراكة فنية لإيجاد مشروع يستقطب مستثمرًا. بفضل تمويل شخصي من هاريس بقيمة 80.000 دولار، وقرض من والده بـ50.000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي متواضع من شركة "يونايتد آرتستس" بقيمة 200.000 دولار، نجحا في إنتاج فيلم "القتل" (The Killing) الذي صدر عام 1956. وقد ساهمت هذه الشراكة في تاريخ كوبريك المهني، إذ أبرزت أدفأ وأفضل تعاوناته السينمائية، كما يظهر في أفلام مثل "دروب المجد" و"لوليتا".
يتميز فيلم "القتل" بقصة مشوقة وأسماء بارزة، من بينهم ماري ويندسور وإليشا كوك الابن، ليضع بصمته في دائرة أفلام الجريمة الكلاسيكية في الخمسينيات. لكن كوبريك برع في سرد القصة من خلال ذكريات مرتدة تُعرض من زوايا متعددة، مستلهمًا نهجه من فيلم "الغابة الإسفلتية" (The Asphalt Jungle)، وخاصةً في اختيار ستيرلينج هايدن للبطولة. ومع ذلك، أظهر فيلم كوبريك تميزًا نفسيًا أعمق وقدم عنصرًا أبقى: شغفه بتحريك الكاميرا برشاقة دون لفت الانتباه، مستلهمًا من ماكس أوفولس، كما في اللقطة التتبعية الشهيرة لجيمس ماسون وباربرا بيل غيدس في مشهد راقص مزدحم حيث يتفاعل الثنائي ببهجة.
أما بالنسبة لجانب التصوير، تعاون كوبريك مع لوسيان بالارد، الذي سبق له العمل مع عباقرة السينما مثل جوزيف فون ستيرنبرج وجاك تورنور. ومع ذلك، لم يترك كوبريك شيئًا للصدفة، وتولى توجيه الكاميرا بنفسه عندما لاحظ عدم كفاية الإعدادات للمشهد الرئيسي، حيث يُقتل حصان على مضمار السباق لجذب الانتباه بعيدًا عن السرقة، فرّحب بإدخال كاميرا يدوية بواسطة صديق لتوثيق تفاعلات الحشود بشكل أفضل.
لم يتوانَ كوبريك أبدًا عن السعي وراء الأصالة والواقعية، حيث كان يحرص على معرفة مصدر الضوء في أي مشهد ليلي داخلي سواء كان من الشارع أو من غرفة مجاورة. كان استخدام كاميرا يدوية لتصوير الحشود يعكس رغبة كوبريك في تقديم تجربة بصرية فريدة تُحاكي الواقعية. تحدثت ويندرسور عن دقة توجيهات كوبريك، التي تصل حتى لتحركات العين أثناء قراءة مجلة، مما يبرز حرصه على أصغر التفاصيل ليحقق واقعية تامة.
حقق فيلم "القتل" نجاحًا باهرًا على الصعيد النقدي، رغم أنه لم يكن من الأفلام التي تحقق أرباحًا طائلة. لذلك، قرر كل من كوبريك وهاريس استغلال هذا النجاح، وأطلقا فيلمهما التالي بعد ثمانية عشر شهرًا فقط.
كان كتاب "دروب المجد" لهمفري كوب من الكتب القليلة التي أبحر فيها كوبريك بشغف في المدرسة الثانوية، والذي يسرد قصة هجوم فاشل شنته المشاة الفرنسية على موقع ألماني خلال الحرب العالمية الأولى. من المعروف، وبكل إنصاف، أن أفلام كوبريك تعكس اهتمامًا عميقًا بموضوع العنف، غير أن اهتمامه يأخذ طابعًا مميزًا لا يعرف الإثارة، سواء كان العنف يتمثل في قساوة حرب الخنادق أو المفاجأة العاصفة لمباراة ملاكمة أو مبارزة، إذ لم يسعَ كوبريك يومًا لعرض المشهد بغرض الإثارة، ولم يوجه دعوة للجمهور لرؤية لذة البشر وهم يُدمّرون بعضهم البعض. على النقيض، كان الشعور باهتًا ومنفّرًا.
يُصور الفيلم الجنرال الفرنسي، الذي يؤدي دوره جورج مكريدي، وهو يقود هجومًا على الموقع الألماني المعروف بـ"تلة النمل". وبعد تردد أخلاقي عندما عرف بأن 60% من رجاله يُحتمل أن يُقتلوا، يوافق على المهمة بإغراء ترقية من قائده العسكري الأعلى، الذي يؤديه أدولف مينجو.
يتقدم الكولونيل داكس، الذي يؤدي دوره كيرك دوغلاس، على امتداد الخندق قائدًا رجاله، وحدث هذا في لقطة تصويرية مذهلة، حيث تواجه كاميرا واحدة داكس فيما يتقدم تحت وابل من قصف المدفعية، بينما تلتقط كاميرا أخرى المشهد من زاويته الشخصية.
تستغرق اللقطة ما يقارب دقيقتين كاملتين. تتعرض الموجة الأولى من الجنود لهجوم كاسح من نيران الرشاشات والقصف والقنابل اليدوية، وعندما يحدث التراجع المحتم، يأمر الجنرال المدفعية الفرنسية بإطلاق النار على جنودها. تُعتبر هذه السلسلة بمثابة تعليم مكثف في كيفية تحول الرجال إلى أشياء، كما وصفتها سيمون فايل في "الإلياذة"، وتسهم الأصوات المدويّة للمعركة في تعزيز هذا التأثير. يأمر الجنرال بإعدام مئة من الجنود الذين تراجعوا أو رفضوا الهجوم، لكنه يساوم ليصل بالعدد إلى ثلاثة فقط، قائلًا: "دعونا لا نساوم". ثم يتنقل المشهد فجأة من نهاية المحكمة العسكرية إلى مسيرة فرقة الإعدام.
في فيلم "دروب المجد" (Paths of Glory)، برزت وبوضوح سمتان بارزتان في سلوك كوبريك، سواء داخل موقع التصوير أو خارجه. فقد كان يُظهر اهتمامًا دقيقًا وحرصًا لا نهائيًا في تجهيز مواقع التصوير، والإضاءة، ووضعيات الممثلين؛ ولم يتردد في جعل الطاقم والممثلين ينتظرون لتحقيق الكمال المنشود في المشاهد. وهذا المبدأ كان ينطبق أيضًا على عدد المحاولات التي كان يصر عليها لتصوير المشهد بالشكل المثالي.
في إحدى المرات، أثناء الساعات الأولى من الفجر، وبعد حوالي أربعين محاولة لأحد المشاهد، التي انتهت بطلبه 84 محاولة، طالب كيرك دوغلاس بأخذ استراحة للراحة، لكن كوبريك صرخ قائلًا: "الأمر ليس صحيحًا بعد، وسأستمر في العمل حتى يصبح كذلك". عادةً، كان انتقاد كوبريك للممثلين يأتي في شكل تلميحات بسيطة مثل "افعلها مرة أخرى"، وهذه كانت الحالة الوحيدة التي رفع فيها صوته، مما يجعل هذه الواقعة تستحق الذكر. ورغم كونه مخرجًا شابًا في العشرينيات من عمره، وكان دوغلاس نجمًا في أوج مجده، أظهر كوبريك سلطته بشكل واضح للجميع. كان ارتباط كوبريك بأفلامه صارمًا، كاملًا ولم يكن قابلًا للتفاوض.
في المشهد الأخير من فيلم "دروب المجد"، تُغني شابة ألمانية أغنية "Der treue Husar" بعد أن دُعيت إلى لمسرح في حانة قريبة لتُرفّه عن الجنود المتعبين. يسخر الجنود منها في البداية، لكن سرعان ما تذوب قسوتهم ويشاركونها الغناء، على الرغم من عدم فهمهم لكلمات الأغنية التي تدور حول الحب والحرب.
جاءت فكرة هذا المشهد الرائع من إلهام كوبريك بعد اقتراح سابق لمنح الجنود المُدانين عفوًا في اللحظة الأخيرة، مما جعل النهاية تبدو تجارية وقابلة للتسويق. لكن دوغلاس رفض ذلك الاقتراح. وبدلاً من ذلك، اقترح كوبريك حلًا بديلًا: شابة ألمانية تغني والجنود يتصرفون بوحشية ثم يبدأون في استعادة إنسانيتهم تدريجيًا. ورغم أن هاريس وجد الفكرة غريبة، إلا أن كوبريك أصر على تنفيذها، قائلًا: "لدي الشخص المناسب. إذا لم يُعجبنا المشهد بعد تصويره، فلا حاجة لاستخدامه". الفكرة كانت مناسبة تمامًا للممثلة الألمانية كريستيان سوزان، التي أصبحت فيما بعد كريستيان كوبريك، والتي أكملت الفيلم بمونتاج يبرز ملامح المرأة الحزينة ووجوه الجنود المتعبة.
يُعتبر "دروب المجد" فيلمًا بارزًا، لكنه ربما قدم صورة غير دقيقة عن كوبريك، فقد استُقبل الفيلم كعمل مناهض للحرب، وهو الانطباع الذي تعزز بفيلميه التاليين "سبارتاكوس" (Spartacus) و"دكتور سترينجلوف"، مما جعل كوبريك يُعتبر خليفة للمخرجين الليبراليين الأميركيين، مثل إليا كازان وفريد زينمان وجورج ستيفنز. هذا الأمر قد يفسر شعور بعض النقاد الليبراليين بخيبة الأمل في أعماله خلال العقود الثلاثة الأخيرة من حياته المهنية، خاصةً مع صدور فيلم "2001: أوديسا الفضاء"، الذي رآه البعض تجريديًا للغاية أو منعزلًا، أو مهووسًا بالتقنية. لكن المشكلة كانت في التوقعات المتعلقة بأعماله.
استعان دوغلاس بكوبريك مرة أخرى بعد ثلاث سنوات ليحل محل أنتوني مان كمخرج لفيلم "سبارتاكوس". كانت هذه خطوة جريئة ومحفوفة بالمخاطر. لكن في عام 1960، كان النجاح في إخراج ملحمة رومانية كافيًا لبناء سمعة تجارية قوية لأي مخرج، كما كان هناك عرفًا سائدًا في هذا النوع من الأفلام الذي يتطلب تجسيد شخصية المسيح. ومع ذلك، تمكن "سبارتاكوس" من تجنب ذلك بشكل مباشر، لكنه أشار إليه بطريقة ضمنية من خلال رمزية تمرد سبارتاكوس ضد الإمبراطورية، مشبهًا بذلك روح المتمرد الذي جسده المسيح.
أدار كوبريك المشروع بمهارة تليق بمخرج مخضرم، واكتسب احترام طاقم تمثيل كبير من بينهم لورانس أوليفييه الذي لعب دور كراسوس. وعلى الرغم من النجاح، فإن كوبريك لم يكن راضيًا تمامًا عن المونتاج النهائي للفيلم، مما دفعه للتعهد بألا يتخلى عن سيطرة أي مشروع مستقبلي لأي منتج أو استوديو.
بعد ذلك، وفي عدة مقابلات، صرّح كوبريك بأنه لا يشعر بالفخر إلا بمشاهد مصارعة المجالدين التي تمتد لـ45 دقيقة وتضخ الحياة في بقية الفيلم الممتد لثلاث ساعات، بتقنية سوبر تكنيراما 70. المشهد الآخر البارز الذي يبقى في الذاكرة هو المعركة النهائية الرهيبة خارج روما. تجاوز هذا المشهد نص دالتون ترومبو الأصلي، وتم تصويره في إسبانيا بناءً على طلب كوبريك، حيث لم يكن هناك شيء يضاهي عظمة مشاهد الجيوش الرومانية أثناء فصلها وإعادة تنظيم صفوفها بطريقة تشبه حركة الثعبان. اللحظة تطول في صمت تام إلا من صوت ارتطام الأسلحة، ومشهد الجيوش وهي تغطي الأفق.
على الرغم من انقياد كوبريك لمطالب الاستوديو بشأن إدخال لمسات عاطفية في الفيلم – مثل مشاهد الحب بين سبارتاكوس وفارينيا، ورقصات الفولكلور التي يؤديها المتمردون السعداء، والتي تُشبه معسكر صيفي اشتراكي في شمال هوليوود – لم يشكك أحد في من هو المتحكم الفعلي في تفاصيل العمل اليومي.
خلال إخراجه لفيلم "سبارتاكوس"، دخل كوبريك مجددًا في خلاف مع مصور السينما المعروف، راسيل مِيتي، الذي سبق له العمل مع أورسون ويلز ودوغلاس سيرك. مرة أخرى، تولى كوبريك السيطرة بشكل كامل، تاركًا مِيتي يراقب المشهد من الهامش وهو يشرب ويعلق. ومع ذلك، لم يكن بإمكان كوبريك تغيير الاعتمادات الخاصة بالفيلم، وكانت العقوبة المفروضة عليه مناسبة تمامًا لتصرفه الأناني، حيث حُرم فيلم "سبارتاكوس" من ترشيح الأوسكار لأفضل فيلم أو أفضل مخرج، بينما حصل مِيتي على جائزة أفضل تصوير.
تُعد جميع أفلام كوبريك، بعد الفيلمين اللذين أخرجهما بميزانية محدودة، اقتباسات من مصادر أدبية معروفة. على عكس رواية "حظ باري ليندون" الساخرة لثاكري أو "Traumnovelle" لشنيتسلر (التي تحولت إلى "عيون مغلقة على اتساعها")؛ تتمتع "لوليتا" لنابوكوف بهوية واضحة من حيث الحبكة والأسلوب. وقد دفعت "لوليتا" (Lolita) مفهوم الجمالية غير الأخلاقية إلى أقصى حد واختبرت بذلك تلك الحدود.
الراوي، همبرت همبرت، هو جامع للأحاسيس المتنوعة وبشكل خاص للمراهقات اللاتي يسميهن "نيمفيتس". يروي قصته الخاصة قائلاً: "يمكنك دائمًا الاعتماد على القاتل للحصول على أسلوب أدبي متميز". والتساؤل الذي يطرحه النقاد هو: هل يدين نفسه، أم يسحر القارئ ليبقى بعيدًا عن الحكم عليه؟ قام كوبريك بإزالة هذه الغموضيات من المعادلة، حيث قلل من الاعتماد على السرد بصوت الشخص الأول وحوّل الكوميديا المظلمة إلى قصة رومانسية عن حب محكوم عليه بالفشل. قد يكون تأثر بمراجعة ليونيل ترلنج للرواية، لكن ذلك كان تفسيرًا خاصًا به. كان يتعين على الفيلم أن يظهر كعمل مستقل تمامًا.
أُطلق فيلم كوبريك في عام 1962، حيث أبدع في خلق توازن رائع في السرد. وفي أحد المشاهد المبكرة بين همبرت ولوليتا، يتضح اهتمامه العميق بتعقيدات الحياة الطبيعية. تتسلق لوليتا السلم لتقدم الإفطار على صينية أعدتها والدتها، شارلوت هاز، بحب لنزيلهما. وعند دخولها غرفته، تضع الصينية وتقول: "لا تخبر أمي، لكنني أكلت كل البيكون الخاص بك".
في هذه الأثناء، يخبئ همبرت دفتر ملاحظاته في أحد الأدراج، حيث يعبر فيه عن شغفه بالفتاة وكراهيته لوالدتها، مما يدفع لوليتا للسؤال: "ماذا كنت تكتب؟"، فيرد كاذبًا: "قصيدة عن الناس"، فتجيبه بسخرية لطيفة: "موضوع مثير. من الغريب أنه بدا وكأنه مذكّرات عند دخولي".
توافق لوليتا على سماع كوبريك وهو يقرأ قصيدة لأحد الكتّاب الآخرين "الإلهي إدغار". كتب نابوكوف مسودة طويلة للسيناريو، لم يُستخدم معظمها، لكن لمسته كانت واضحة في اختيار هذه الفقرة الرومانسية التي تعبر عن المعاناة في الحب: "كان من الصعب عند البحيرة المعتمة (dim) في أوبر، في المنطقة الضبابية (mid) من وير".
يسأل همبرت، الذي يحب الأدب، لوليتا أن تُلاحظ كيف تتناغم كلمة "mid" مع "dim" في الأبيات. توافق على ما يقوله بينما تنحني على المكتب وتتذوق شريحة من الخبز المحمص: "آه، هذا جيد، ذكي حقًا". لكن عندما ينطق باللحن الرنّان "Ulalume ،Ulalume" مع تنهيدة مشحونة، تغيّر لوليتا رأيها: "حسنًا، أعتقد أنه يبدو مبتذلًا قليلًا، لأكون صادقة". يسأل همبرت بقلق عن أحد أصدقاء لوليتا، فتخبره أنها تعرف بعض الأمور، لكنها تحذره قائلةً: "أنت ستفضح الأمر".
يعدها بأنه لن يفعل ذلك، فتقول إن هذا يستحق مكافأة. وهنا، رغم استمرار الأجواء على حالها، يتغير المغزى بشكل خفي. تطلب منه أن يسترخي على كرسيه، "يمكنك أخذ لقمة صغيرة" من البيضة المقلية التي ترفعها فوق فمه المفتوح، لكنه يمسك بذراعها ويأخذ أكثر مما هو مسموح. تُمثل لعبة الغزل هذه جانبًا طفوليًا من شخصيتها، وتظهر بوضوح جاذبيتها الفطرية. أما هو؟ هنا تظهر خبرته كمخرج، حيث يعرف بالضبط اللحظة المناسبة لقطع المشهد.
تتميز نغمة فيلم "لوليتا" لكوبريك بأنها فريدة ومختلفة تمامًا عن أي شيء آخر في عصره أو في أي زمان آخر. فهو يقدم تلاعبًا بالمشاعر دون أن يخفي الألم الذي يشعر به الطرفان، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ، فهي في جوهرها قصة حب. إن دافِع لوليتا للارتباط بهمبرت يتمثل في رغبتها العميقة في الهروب من قيود والدتها، وقد سُنِحَت لها هذه الفرصة عندما توفيت شارلوت في حادث مأساوي غير متوقع.
يستعرض الفيلم سخرية حرة من الثقافة الشعبية الأمريكية والقيم البورجوازية، كما يظهر في الرواية. وهناك نوع آخر من السخرية: لفهم كيف كان صوت كوبريك في الحياة، يجب فقط الاستماع إلى استجواب همبرت على شرفة فندق من قبل خصمه كلير كويلتي. يظهر كويلتي بشكل ماكر، وهو شخصية تتسم بالفطنة والمعرفة الواسعة (مع لهجة خفيفة من برونكس)، حيث يبدو غير مُبالٍ ولكنه يركز على كل نقطة. وصف ديفيد لينش فيلم "لوليتا" بأنه من أفلامه المفضلة، وعندما سُئل عن السبب، قال: "إنه يلتقط شيئًا ما من تحت السطح في.. إنه يكشف عن الأشياء الخفية".
بدأ تصوير فيلم "دكتور سترينجلوف" بعد ثلاثة أشهر من أزمة الصواريخ الكوبية في تشرين الأول/أكتوبر 1962، لكن اهتمام كوبريك بخطر الحرب النووية يعود إلى فترة أبعد من تلك اللحظة. جاء التحول الذي شهده الفيلم، من نوع الإثارة إلى السخرية القاتمة، بعد انغماسه في كتابات الاستراتيجيين الدفاعيين في تلك الحقبة، ومن بينهم هيرمان كان وتوماس شيلينغ وآخرون. كان كوبريك معجبًا بشكل خاص بهيرمان كان، الذي أتيحت له الفرصة للتعرف عليه، إلا أنه اكتشف عيبًا في عبقريته الرياضية، حيث كان كان يحاول تحويل المخاوف البشرية والاختيارات الإنسانية إلى مخططات منطقية.
وعلى الرغم من أن حجج هؤلاء الاستراتيجيين كانت بارعة من الناحية الجمالية، حسب رأي كوبريك، لكنها كانت أقل مصداقية بكثير من الطريقة التي كان سيعبر بها كاتب مبدع حقيقي عن الموضوع. لذلك بدأ يصفهم بأنهم "واقعيون مجانين"، وهو تعبير أخذه من كتيب سي. رايت ميلز تحت عنوان "أسباب الحرب العالمية الثالثة".
قدّم بيتر سيلرز أداءً فذًا في أدواره المتعددة، بينما جسد سترلينغ هايدن دور الجنرال النفسي جاك ريبر، وجورج سكوت في دور الجنرال الطيب الجنرال بَك تيرغيدسون. جميعهم قدموا بعضًا من أروع أعمالهم، لكن أسلوب كوبريك منحهم طابعًا قريبًا من حدود الكاريكاتير، وكان هذا التأثير مقصودًا. طلب كوبريك من سكوت أن يؤدي كل مشهد بأسلوب واقعي أولًا، ثم بأسلوب مبالغ فيه؛ مما أثار قلق سكوت، نظرًا لاختيار كوبريك للإصدار المبالغ فيه كل مرة.
ورغم ذلك، كانت النغمة قد تغيرت بين النص الذي اطلع عليه الممثلون وما نتج عن تنقلات كوبريك في الليموزين إلى استوديوهات شيفرتون برفقة تيري ساوثرن. استدعى كوبريك ساوثرن بعد أن شعر بأن روايته "The Magic Christian" تحتوي على "دلائل واضحة" على الاتجاه الذي أراد أن يسلكه في كتابة السيناريو. وابتكرا معًا طريقة، من خلال تقديم هادئ وثقيل للأحداث الغريبة، كيف يُظهر الروتين الرسمي للحفاظ على الذات تفاعلًا مع جنون الكارثة المدمرة للعالم.
عبر فيلم "دكتور سترينجلوف"، تمكن كوبريك من وضع أسلوب جديد في استخدام الموسيقى. عملت هذه الموسيقى كإشارات للسينمائيين والنقاد المحنكين، كما في أغنية "Try a Little Tenderness" التي تُعزف خلال العناوين الافتتاحية بينما تُزوَّد طائرة B-52 بالوقود من طائرة ناقلة، أو أغنية "We’ll Meet Again" التي تُغنى فوق مونتاج الغيوم الطبيعية التي تختتم بها أحداث الفيلم، فضلاً عن أغنية الحرب الأهلية "When Johnny Comes Marching Home" التي رافقت القاذفة التي تملصت من رادار السوفييت.
ومع ذلك، تجاوزت طريقة عمله هذه الحدود التقليدية. ففي فيلم "2001: ملحمة الفضاء"، غاص كوبريك في عالم الموسيقى، حيث اختبر العديد من النسخ المسجلة لفالس "Blue Danube" إلى أن وجد النسخة المثالية لمشهد التحام المركبة بمحطة الفضاء. كما أن النغمات الافتتاحية من "Also sprach Zarathustra" جاءت لتضيف عمقًا فلسفيًا يعكس فكرة نيتشه حول تجاوز الذات، مما يعزز تماسك الحبكة. إن استخدامه للألحان المألوفة، وأحيانًا للأعمال الكلاسيكية النادرة، يتوازى مع طقسه الفريد المتمثل في تشغيل الموسيقى في موقع التصوير خلال فترات الانتظار بين المشاهد، حيث كان يؤمن بأن الموسيقى تلعب دورًا أساسيًا في خلق الأجواء، مما يعزز التفاعل بين الممثلين والطاقم الفني.
كان اهتمام كوبريك بالموسيقى دقيقًا ومستفيضًا، وكأنه يعمل كجامع مختارات فنيّة، مما جعله يتناغم بسلاسة مع تركيزه على المشاهد الطويلة والممتدة في أفلامه. ومع مرور الوقت، تزايد انحيازه نحو هذا الأسلوب، مما وضعه في مواجهة الاتجاه السائد في صناعة السينما الذي يفضل الإيقاع السريع القائم على التحرير المونتاجي. في اختيار الموسيقى، كان كوبريك يفضل استخدام المؤلفات الموسيقية الكاملة أو أجزاء كبيرة ومتكاملة منها، بدلًا من المقاطع العشوائية التي كانت سائدة في صناعة الموسيقى السينمائية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر استخدام "Dies Irae" وصداها في "سيمفونية العالم الجديد" لدڤورجاك، الذي يتأرجح نحو النشاز وعدم التناغم في بداية فيلم "The Shining"، بمثابة تمهيد وتحذير واضح لما سيأتي من أحداث.
وكذلك، كان استخدام الحركة البطيئة من ثلاثية البيانو في سلم مي بيمول لشوبرت في فيلم "Barry Lyndon" بمثابة توظيف تكراري ولكن ملهم وتوضيحي في الوقت نفسه. وفي فيلم "Eyes Wide Shut"، استخدم كوبريك فالس الجاز لشوستاكوڤيتش للإيحاء بإغراء جنسي طفيف، بينما أشار موضوع البيانو ذو النغمتين من "Musica Ricercata" لليجيتي إلى الخطر والإكراه.
قضى ستانلي كوبريك وقتًا طويلًا في تطوير فيلم "2001: ملحمة الفضاء"، وقد تخلل ذلك الكثير من الشكوك والتغييرات في المفاهيم الإبداعية. كان العرض الأول في أبريل 1968 تجربة كارثية، إذ غادر عدد كبير من الضيوف المدعوين قبل انتهاء العرض، مما دفع كوبريك إلى الخشية من أن تكون هذه نهاية مسيرته الفنية. غير أن هذا الجمهور كان مؤلفًا من نخبة مجتمع صناع السينما في نيويورك، بمعدل أعمار يناهز 55 عامًا. وكما اعتاد كوبريك في مثل هذه المواقف، لجأ لإجراء تعديلات تحريرية في اللحظات الأخيرة، ليتمكن الفيلم من اجتذاب جمهور الشباب في الساحل الغربي، وينطلق في رحلة تألق عالمي.
حمل فيلم "2001" روح الابتكار السلبية، متجاوزًا التوقعات التقليدية لأفلام الخيال العلمي بعدم إظهار القوة الفضائية بشكل مباشر، على الرغم أنه يتبنى سردًا عن آثار غامضة تؤكد وجود هذه القوة بشكل مُبهم. في حملته الدعائية الضخمة، عبّر كوبريك عن مشاعر العزلة البشرية في الفضاء، مستلهمًا ذلك من أعمال الكاتب آرثر سي. كلارك.
استمد الفيلم قوته وجاذبيته المستمرة من هذا الشعور الإنساني العميق: فنكاد نجد أنفسنا عاجزين عن القبول بفكرة الوحدة في هذا الكون الواسع، ومأخوذين بفكرة كيف يمكن ألا نكون وحدنا. وحتى مع كل ما يمثله الفضاء مترامي الأطراف من رهبة، فإن لا شيء يفوق في تأثيره مشهد نقاش رواد الفضاء حول شكوكهم في الذكاء الاصطناعي المتمثل في حاسوب HAL، والذي يفضي بنا، عبر قطع سينمائي دقيق، إلى اكتشاف أنه قادر على قراءة شفاههم، مما يجعل هذا المشهد واحدًا من أروع لحظات الإدراك المجرد في تاريخ السينما، مشهد قادر على إيصال رسالة قوية ولكن بلا صوت أو كلمات مفادها: الخطر يقترب.
وفي السياق نفسه، يطرح الفيلم فكرة مثيرة بشأن احتمال امتلاك الآلات لدوافع شبيهة بالبشر، وهو موضوع ظل يحتل فكر كوبريك حتى نهاية حياته. وما يزيد الأمر إثارة للقلق هو الميل البشري المتزايد لوضع الثقة في الآلات أكثر من الثقة في النفس. وتتجلى في قصص كوبريك التي تتحدث عن عن الحب والحرب وصعود السلم الاجتماعي، إغراءات التخلص من الأخطاء وخيبات الأمل عبر الانغماس في الآلية المطلقة.
انتقل ستانلي كوبريك إلى إنجلترا في عام 1965، واستقر أولًا في "أبوتس ميد" في هيرتفوردشاير، وهو "منزل عائلي كبير شبه ريفي" يقع بالقرب من استوديوهات إيلستري. ثم، في عام 1978، ومع تزايد حاجته لتخزين المزيد من المعدات، انتقل إلى "Childwickbury Manor"، أيضًا في هيرتفوردشاير. خلال هذه الفترة، استمر في قراءة موضوعين لطالما جذبا اهتمامه: الحروب النابليونية وألمانيا النازية.
كان لديه اهتمامًا متزايدًا بفيلم سيرة ذاتية عن نابليون، إذ لم يُثنه عن شغفه فيلم "Waterloo" الذي أخرجه سيرغي بوندارتشوك في عام 1970، والذي مثل فيه رود ستايغر، ولا فيلم "Eagle in a Cage" الذي أخرجه فيلدر كوك في عام 1972 مع جون جيلغود. لكن كم عدد الأفلام التي يمكن أن يتحملها هذا الموضوع؟ من الصعب أن نشعر بالأسف على قراره بإلغاء المشروع.
كان دور نابليون يتطلب ممثلًا رئيسيًا يتسم بقدرة هائلة على التعبير، لكن كوبريك بدأ يميل إلى اختيار ممثلين ذوي أداء مسطح، حيث كانت إدارته تجعلهم أكثر سطحية. وقد يتناسب هذا الأسلوب مع تصميم فيلم "2001"، حيث يتناقض كير دوليا، رائد الفضاء، مع الحاسوب الذي يتمتع بالطابع البشري بشكل مفرط. كان كوبريك يطلب ويحقق تقريبًا مشابهًا من عدم الشخصية من شخصية رايان أونيل في "باري ليندون". لكن الحقيقة أن علاقة كوبريك بفكرة الممثلين كانت متناقضة. هل ينبغي استخدامهم كدمى (كما وصف روبير بريسون ممارسته مع غير الممثلين)، أم يجب البحث عن ممثلين موهوبين وإتاحة الفرصة لهم للتألق؟
هذا النوع من الحرية أفضى إلى أداء سيلرز في "لوليتا" و"دكتور سترينجلاف"، وأدى – مع نتائج أكثر تباينًا – إلى أداء جاك نيكلسون في "البريق" (The Shining). واجه كوبريك تناقضه في هذا الصدد اختبارًا نهائيًا في فيلم "عيون مغلقة على اتساعها" (Eyes Wide Shut). هل كان توم كروز ممثلًا أم مجرد دمية؟ قد يكون تم اختيار نجم "توب غان" ليتناسب مع نوعية أداء دوليا وأونيل، لكن قدرة كروز وضعت له مكانًا في نقطة وسط بين هذين النمطين، والقرار بربطه مع نيكول كيدمان، الممثلة ذات العمق الفني، فتح إمكانية تحول الدمية إلى إنسان، وهو ما كان جوهر مغامرة البطل الليلية.
كان نفس اللغز يبرز اهتمام كوبريك بقصة "بينوكيو"، حيث قضى عدة سنوات في تطوير نص ورسومات تخطيطية لفيلم عن الذكاء الاصطناعي. في النهاية، قام بنقل مشروع الذكاء الاصطناعي إلى ستيفن سبيلبرغ، الذي شكر كوبريك بعد وفاته في شارة الفيلم. كانت النهاية العاطفية لفيلم "AI" متوقعة ولم يكن ليقبل كوبريك بها تحت اسمه كمخرج.
طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات، كان كوبريك يفكر في إعداد فيلم عن الهولوكوست. كانت الفكرة لا تزال تدور في ذهنه عندما تساءل كاتب سيناريو فيلم "عيون مغلقة على اتساعها"، فريدريك رافائيل، عما إذا كان فيلم "قائمة شندلر" قد يلبي تلك الحاجة. وقد سجل رافائيل الحوار الذي دار بعد هذا التساؤل:
ستانلي كوبريك: هل تعتقد أن ذلك كان عن الهولوكوست؟
فريدريك رافائيل: أليس كذلك؟ ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟
ستانلي كوبريك: كان ذلك عن النجاح، أليس كذلك؟ الهولوكوست يتعلق بستة ملايين شخص قُتلوا. أما "قائمة شندلر" فيتحدث عن 600 شخص نجوا.
لا يُتوَج أي بطل في أفلام كوبريك بالنجاح. فعلى سبيل المثال العقيد دكس في فيلم "دروب المجد" يفشل في إنقاذ الجنود الذين أُدينوا ظلمًا بالإعدام بسبب تهمة الجبن؛ وسبارتاكوس، رغم تقدمه نحو روما، يُهزم ويُصلَب؛ أما باري ليندون، فيُجبر على مغادرة إنجلترا ويقبل بتلقي راتب سنوي من ابنه غير الشرعي الذي أصابه برصاصة في ساقه خلال مبارزة.
عُنف الفرد مروّع.. لكن عنف الدولة أسوأ
يُحتمل أن يتذكر معظم الناس من فيلم "برتقالة آلية" (A Clockwork Orange) الذي صدر عام 1971، العين الماسكارية لمالكولم ماكدويل، الذي يجسد شخصية أليكس، الثائر وزعيم العصابة، وهو يتجول بفخر على ضفاف مجرى النهر الإسمنتي، ويعتدي على المتشرد، وينطلق بسرعات جنونية خلال الليل لاغتصاب المرأة الفنية-البوهيمية وإجبار زوجها على المشاهدة – ثم يسترخي بعد ذلك مع أصدقائه في "كوروفا ميلك بار".
كانت هذه الرؤية كابوسية لمنطقتي هايت-أشوري أو تشيلسي في أواخر الستينيات. ويعكس الفيلم، بطريقة غير مباشرة، اشمئزاز كوبريك من الجريمة المرتبطة بثقافة الهيبيز التي شكلت عنصرًا فريدًا من ثقافة المقاومة في الستينيات. لم تكن رسالة "برتقالة آلية" مؤيدة للعنف بل كانت مناهضة للدولة بشكل واضح لدرجة أن كوبريك كان يشعر بأنه تعرض لهجوم مفاجئ عندما وصف بعض النقاد الفيلم في الصحف الليبرالية بالفاشي.
تقول الرسالة التي يحملها هذا الفيلم إن العنف الذي يمارسه الفرد هو أمر مروع، لكن العنف التأديبي الذي تمارسه الدولة أسوأ. وتحت السطح التجريبي، يُعتبر "برتقالة آلية" بمثابة رمز تعليمي، حتى حد المبالغة، وطاقة الفيلم تخفت بسرعة وتفقد قوتها في وقت مبكر. يتكون النصف الثاني الطويل من الفيلم من العلاج السلوكي لأليكس على يد السلطات العقابية، وتظهر ذروته كيف وهو يستعيد روحه الحيوانية من خلال الوسائل المعتادة: خيال مفعم بالعنف الجنسي، يُحفزه عزف بيتهوفن لسمفونيته التاسعة. ولكن الآن، انصهرت اهتماماته مع مصالح الدولة، وأصبح هذا الحلم يتضمن إثارة استعراضية ناتجة عن كونه مراقبًا من قبل الحشد. لم يعد أليكس الثائر العنيف الذي كان عليه، بل تحول إلى منافق عنيف. مختل عقلي يتماشى مع السلطات. ولقد أدت الاعتداءات والجرائم المقلَّدة عن الفيلم إلى قرار كوبريك بسحب الفيلم من العرض في بريطانيا في عام 1974. ولم يُسمح للفيلم بالعودة إلى دور السينما إلا في عام 2000، السنة التي تلت وفاته.
كان يعتبر فيلم "برتقالة آلية" (A Clockwork Orange) خطًأ غير مُبرر بشكل غريب. فالعناصر الساخرة، كما في مشاهد الشرطة (التي استُلهمت، على سبيل المثال، من "مونتي بايثون")، جاءت بصراحة فظة تشير إلى نوع من الاضطراب الجوهري، وقد بدأ كوبريك بالتراجع عن ذلك تدريجيًا.
وكان فيلم "باري ليندون" (Barry Lyndon) خطوة أولى مدروسة. لكن كما هو الحال مع "لوليتا"، فالتكيف هنا يعني خلق عمل مختلف تمامًا. وتعتبر رواية "حظ باري ليندون" رواية هزلية مليئة بالمواقف والقصص التي تتميز بأسلوب Fielding-Smollett، بينما قام السيناريو بتقليصها إلى ستة مواقع منفصلة ومشاهد رئيسية. وكان بطل رواية ثاكراي مغامرًا ومستهترًا يروي حكايته الخاصة دون أي شعور بالمواعظ الأخلاقية، فيما أعاد كوبريك صياغتها وعدَّل إيقاعها ليصبح شبيهًا بمسيرة الموت.
يقوم الراوي "مايكل هوردن" بتوجيه الجمهور بأسلوب يتسم بلمسة من الحكمة والشرف، بأسلوب قريب من الكاتب الإنجليزي جونسون: "كان باري من أولئك الذين وُلدوا بذكاء يكفي ليكتسبوا ثروة، لكنهم غير قادرين على الاحتفاظ بها. فالمميزات والطاقات التي تقود الرجل نحو تحقيق الأولى غالبًا ما تكون نفسها سبب سقوطه في الثانية".
هنا، يعكس السرد من منظور الغير ثقل الأفكار بجدية، مما يضيف بعدًا جدليًا وكأنما هو موعظة. في المقابل، يمكن مقارنة ذلك بالأسلوب الجريء والخالي من الحياء الذي يستخدمه ثاكراي في روايته عن باري: "عندما سألت السيدة عن ميلادي وأصلي، أجبت بأنني شاب ثري (هذا لم يكن صحيحًا؛ لكن ما فائدة الشكوى من سمكة سيئة؟ والدتي العزيزة علّمتني منذ صغري أهمية هذا النوع من التحفظ)". كان سحر الجرأة الذي يتمتع به باري قد يجعله يتشابه كثيرًا مع شخصية أليكس.
نال فيلم "باري ليندون" إعجاب الكثير من الناس من أصحاب الذوق العام، لأنه عزز انطباعهم بأن القرن الثامن عشر كان يتميز بفترة زمنية طويلة وبطيئة. اختار كوبريك بعناية الخلفيات الرائعة بعد قيامه باستقصاءات دقيقة. ومن خلال سعيه المعتاد للدقة، قام بدراسة أعمال فنية لأسماء بارزة مثل غينسبرغ ورينولدز وجوزيف رايت من دربي، وأيضًا هوغارث. ومع ذلك، فإن الصورة الساخرة التي تعرض نبيلًا فرنسيًا بارزًا، يحظى بعشيقتين إلى جانبيه لتقديم العزاء له بعد خسارته في لعبة الورق، تميل في كثير من الأحيان إلى أسلوب رسومي كاريكاتيري لا يتناسب مع النية الجادة للفيلم. في النهاية، يبقى باري ضحية للظروف، مُقادًا بإرادة غامضة، وغير مدرك تمامًا لطبيعة نفسه، كما هو الحال مع الكائن البشري البدائي في بداية فيلم "ملحمة الفضاء: 2001" الذي يكتشف فجأة أنه قادر على قتل حيوان ثديي أكبر باستخدام عصا.
مع فيلم "The Shining"، عاد كوبريك مرة أخرى إلى نوع معروف بشكل جلي، وهو الرعب القوطي، ويتمتع الفيلم بلحظات غامضة تتسم بالعمق والإثارة. بدءًا من دوي كرة المطاط في بهو الفندق، حيث يشعر الكاتب جاك تورانس (الذي يقوم بدوره جاك نيكولسون) بالملل المتطرف ويقترب من حالة يأس أكثر سوءًا، وصولًا إلى الاكتشاف المروع للمخطوطة التي تثبت جنونه، والتي تتكرر فيها الجملة "العمل دائمًا دون لعب يجعل من جاك صبيًا مملًا" عبر صفحاتها بلا نهاية، وكذلك لحظة ركوب داني، ابنه الحساس، للدراجة الثلاثية في الفندق المهجور، حيث يتجول في المساحات الواسعة من الأرضيات حول الزوايا التي تقوده إلى أماكن غير مريحة نهائيًا.
لقد تميز استخدام كاميرا "Steadicam" المثبتة بشكل منخفض من خلفه والتي يتم تحريكها للأمام مع كل دورة من دراجته، بكونه دليل على الحرفية المتقنة. وعندما يُوقف داني من قبل أشباح الفتاتين الميتتين اللتين تدعوانه للعب، تكتسب تخيلاته مكانتها الحقيقية قبل أن يسود الرعب: إذ تعكس نظراته مزيجًا فريدًا من الخوف والفضول.
حقق فيلم "The Shining" مكانة بين أعلى الأفلام ربحًا في عام 1980، لكنه أيضًا عزز سمعة كوبريك في الإنفاق المبالغ فيه من الوقت والموارد، إذ كانت نسبة التصوير إلى النسخة النهائية في ذلك الوقت حوالي 10:1، بينما كانت في فيلم "The Shining" حوالي 102:1.
صدر فيلم "سترة معدنية كاملة" (Full Metal Jacket) بعد سبع سنوات، متأخرًا خطوة عن فيلم "فصيلة" (Platoon) وأفلام أخرى تتناول حرب فيتنام. ومع ذلك، كان كوبريك مبتكرًا من الناحية الشكلية إلى حد لم يتخيله أسلافه. ففي النصف الأول من الفيلم، تنغمر المَشاهد في معاناة تدريب المارينز الأساسي، وهي تجربة قاسية بقدر الحرب التي سيخوضها الجنود في النهاية تقريبًا.
استأجر كوبريك رقيب تدريب حقيقي، لي إيرمي، لأداء هذا الدور، مما أسفر عن أفضل أداء في الفيلم. وقد أكد هذا الاختيار التزامه القديم بالواقعية. قال كوبريك: "لا يمكن لأحد أن يختلق شجرة، لأن كل شجرة تحمل في تفرعاتها منطقها الفطري. واكتشفت أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل صخرة. لقد تعلمت ذلك في (مسارات المجد)".
كان ميل كوبريك لاستخدام الدقة متماشيًا مع اهتمامه الكبير بحل المشكلات، حيث كان الرقيب كونغ مشغولًا بحل مشكلة حين عبث بأسلاك لفتح الباب وتسهيل الإطلاق في غرفة قنابل طائرة B-52. يتناول النصف الثاني من "سترة معدنية كاملة" مهمة واحدة لحل مشكلة محددة وهي تطهير موقع قناص في المدينة المهجورة "هوي".
يسير تقدم هذه المهمة ببطء، مع استمرارية ورعب، لكن كوبريك لم يحدد موقفه بشأن البطل، جوكر (ماثيو مودين)، حيث تظل الابتسامة الدائمة على وجهه تمثل هروبًا يفتقر إلى السخرية. ومع ذلك، فإن قوة الفيلم تنبع من نوع مختلف من الرفض؛ إذ يتجنب "سترة معدنية كاملة" تحديد ما إذا كانت طبيعة الإنسان تُشوّه بفعل الحرب أم أن الحرب نفسها تمثل تجسيدًا لطبيعة الإنسان.
الشخصيات التي تسكن أفلام كوبريك غالبًا ما تبدو مجردة، محاصرة في قيود وظائفها الاجتماعية. ومع ذلك، يظهر عدد كبير منها وكأنها "وُلِدت بهذه الطريقة"؛ عنيدة، مكتملة ومحددة بدقة، وغير قابلة للتغيير.
الطفل الموهوب داني، الذي يستكشف الفندق الضخم بدراجته الثلاثية، والفيزيائي الألماني الذي يجلس على كرسي متحرك في فيلم "دكتور سترينجلاف"، وهو يحسب نهاية العالم باستخدام مسطرة دائرية، يختلفان عن بقية البشرية فقط في قدراتهما العقلية، لكنهما يكشفان أيضًا عن شغف خفي يتحرك داخلهم: رغبة غير أنانية في البحث عن الحقيقة، وتثبيتها ورسم آثارها. إنهما يسعيان للسيطرة على العالم، وهو هدف يختلف تمامًا عن معرفة الذات. ولا توجد أي إشارة إلى محاولة شخصية للوصول إلى معرفة الذات في أفلام كوبريك، ولا توجد لحظة واحدة يتعلم فيها أي شخصية شيئًا جديدًا. ومع ذلك، هناك كشف زائف، مطول ومضلل، يظهر في نهاية فيلم "عيون مغلقة على اتساعها".
تتمثل الشخصية الشريرة والساحرة في ذلك الفيلم في رجل الأعمال الثري فيكتور زيغلر (سيدني بولاك)، حيث يظهر في البداية كمضيف كريم لحفلة عيد الميلاد الباذخة، التي ستدفع بيل هارفورد إلى البحث عن تجارب جديدة: مشهد تلو الآخر من الفرص الحسية حيث يبقى فيها متفرجًا فقط. بحلول النهاية، اختفى صديق قديم لبيل، وحصلت حادثة وفاة غامضة لامرأة مرتبطة بزيغلر، واكتشف بيل مجتمعًا سريًا يمتاز بالنفوذ والقسوة غير المتوقعة. فيما يقوم زيغلر بتبرير كل ذلك في خطابه الختامي وكأنه مستشار نفسي. لكن هذا التبرير بدا وكأنه غير كافٍ: لقد أحاطتنا رومانسية الليل حتى أصبح من المستحيل على أي تفسير واقعي أن يزيل الوهم. كان كوبريك يعرف تمامًا ما يفعله عندما طلب من بولاك أن يقدم هذا الخطاب الذي سيحل الحبكة بأسلوب درامي يتجاوز حدود المصداقية. فالتفسيرات العقلانية لن تتفوق أبدًا على الغموض. هناك نظريات للمؤامرة، ولكن هناك أيضًا حقائق عن المؤامرات.
كان فيلم "عيون مغلقة على اتساعها" مشروعًا احتفظ به كوبريك لفترة طويلة إذ صدر في عام 1999، بعد اثني عشر عامًا من "سترة معدنية كاملة". ولقد كان كوبريك مترددًا بعض الشيء تجاهه بسبب هاجس في ذهنه بأنه ربما تؤدي هذه القصة عن الخيانة إلى لعنة على زواجه فيما بعد. ويُعتبر هذا الفيلم الأكثر إنسانية في مسيرته الإخراجية؛ وقد تم إنتاجه بتكاليف باهظة كعادته (خمسة عشر شهرًا من التصوير، متجاوزًا فيه الرقم القياسي الذي حققه فيلم "لورنس العرب").
تضع المشاهد الافتتاحية من الفيلم الحجر الأساس للحبكة المعقدة: حيث يواجه كل من الزوج والزوجة اختبارًا من خلال تطلعاتهما المتشابهة للخيانة. كلاهما يجد نفسه أمام إغراءات في الحفلة: الزوج من قبل عارضتين تقترحان مرافقته إلى غرفة خاصة، والزوجة من قبل رجل وسيم ينبعث من أسلوبه عبق العالم القديم، يشد بجمالها ويؤكد أنه يجب أن يراها مجددًا. ترفض أليس، وعندما يسألها عن السبب، تومئ بابتسامة وتريه خاتم زواجها. ينتقل المشهد إلى أغنية "Baby Did a Bad Bad Thing" لكريس إيزاك، حيث يظهر بيل وأليس عاريين أمام المرآة، غارقين في أفكارهما حول الشركاء الذين تركوهم في الحفلة، حتى فيما هما يحتفيان برابط الحب بينهما. ومع وصولهما إلى المشهد الختامي، نجدهما في متجر FAO Schwarz يشتريان ألعابًا لابنتهما، حيث حان الوقت لنقل مسارهما في الحياة إلى مرحلة جديدة، لتكون الكلمة الأخيرة في عمل كوبريك الأخير هي الكلمة الأكثر جرأة في اللغة. إنه ما يتوجب عليهما فعله، ألا وهو واجب الولاء.
تظل انطباعات ثابتة راسخة في ذهني كلما عدت لمشاهدة أفلام كوبريك مرة ثانية أو ثالثة. لقد كان يعني دائمًا ما يقوله. لا يُبعد تركيزه أبدًا عن الهدف، هناك جوهر وغاية وثقل في التعبير؛ حيث يعبر الفيلم عما يريد بوضوح دون انجرار خلف رفاهية الأداءات المسرحية. إن الشعور بذلك يُعد نادرًا جدًا حتى بالنسبة لفنان موهوب. فإذا كان كوبريك يتعامل مع الوجود أحيانًا كمشكلة تحتاج إلى حل، فإن النزاهة هي الكلمة المناسبة لوصف استعداده لمواجهة الإحراج الناتج عن النتائج. يمكن القول أنه استثمر ذاته بالكامل في أعماله.
ومع ذلك، لماذا كان يأخذ انشغاله بالتفاصيل إلى هذا الحد من الهوس؟ لماذا كان مُصِرًّا على العمل من داخل منزله؟ ولماذا كان يحرص على السيطرة الكاملة على جميع الأمور المالية، بدءًا من راتب مساعد الكاميرا وصولًا إلى الأجر بالساعة للممثلين الإضافيين؟ قدم كوبريك ذات مرة تفسيرًا من خلال تشبيه، حيث قال إن العمل اليومي على الفيلم عادةً ما يُنجز من قِبَل المحرر "أثناء إنتاج العمل"، بينما يكون المخرج في الخلفية، وعندما يُنهي الفيلم، ينظرون إليه ويقدمون ملاحظاتهم، ويحاول المحرر تنفيذ تلك الملاحظات، ثم قد يعاودون النظر في العمل لإجراء المزيد من التعديلات. لكن كوبريك اعترض على هذا النهج، مُشَبِّهًا إياه "بمحاولة إعادة تصميم مدينة من خلال قيادة سيارة من داخلها. يمكنك أن تلاحظ بعض التفاصيل وتقول: 'ضع تلك الإشارة الضوئية في منتصف الشارع' أو 'تبدو تلك المباني رديئة قليلًا أو نحو ذلك، ولكن إذا كنت ترغب في القيام بذلك بشكل صحيح، يجب عليك أن تفعل ذلك بنفسك".
لقد كان يخطط للقطات إلى درجة أنه كان يعرف تفاصيل كل زاوية منها، وكان حاضرًا في كل دقيقة من عملية التحرير. إذا بدا أن هذا الالتزام يستبعد أي شكل من الشراكة الحقيقية، وهذا كان صحيحًا بالفعل. وخلال الفترات ما بين المشاريع، كان كوبريك يضغط على أصدقائه والمعاونين في سبيل الحصول على المعلومات من خلال مكالمات هاتفية قد تستمر مدتها لأربع أو خمس ساعات، أو حتى سبع أو ثماني ساعات.
تزامنت ضغوط كوبريك الداخلية مع تزايد قيوده، ورافق ذلك اتساع شهرته المستحقة. ولقد أخرج كوبريك سبعة أفلام خلال عقده الأول، لكن عدد أفلامه في السنوات الخمس والثلاثين التالية لم يتجاوز الستة. أربعة من تلك الأفلام تُعتبر من أبرز الأعمال في تاريخ السينما: "دروب المجد"، و"لوليتا"، و"دكتور سترينجلاف"، و"عيون مغلقة على اتساعها". بينما يُعتبر فيلم "القتل" تحفة فنية في نوع فرعي أقل شهرة، في حين يبقى فيلم "2001: ملحمة الفضاء" نقطة مرجعية فريدة في عالم السينما، حيث يمثل تكوينًا سينمائيًا لا سابق له ولا لاحق، نسخة نفيسة من الرؤية الفكرية التي تخلو من التكرار.
من جهة أخرى، يُعد فيلم "سترة معدنية كاملة" المحاولة الوحيدة التي تسلط الضوء على الدوافع البشرية التي تؤدي إلى الحرب، دون أن تترك أي أثر من الشفقة أو الغطرسة. كما وكان كوبريك يحمل إعجابًا عميقًا بعمل "ديكالوج" (Dekalog) للكاتب كيسلوفسكي، حيث عبّر في مقدمة كتبها لسيناريواته عن رأيه بالقول: "يمتلكون القدرة النادرة على تجسيد أفكارهم بدلًا من مجرد مناقشتها"، وأضاف: "إنهم يقومون بذلك ببراعة مُذهلة تجعل الأفكار تظهر بشكل مفاجئ". تعد هذه الإشادة تعبيرًا دقيقًا عن ما يميز أعمال كوبريك بصفة عامة.
يبدو أن سعادة كوبريك في حياته الخاصة، كما يوضح كل من كولكر وآبرامز، أنها كانت سببًا وراء التراكم البطيء لأعماله خلال سنوات منتصف حياته. إذ كان يُحيط بناته الثلاث، كاثارينا وآنيا وفيفيان، بعناية واهتمام، ولم يتوقف أبدًا عن إضافة الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر، والكلاب والقطط، إلى مجموعته. ومع كل منافس بشري، كان يتعين عليه أن يكون متفوقًا، وكان يُبقيهم في خطه من خلال الفوز عليهم في لعبة الشطرنج. كان يرحب بفرصة إيقاف التصوير لتقديم مطالبات تأمين كبيرة عن الحوادث التي تقع في موقع العمل.
هذه الفترات كانت تتيح له التفكير في التعديلات العديدة التي يمكنه إجراءها. وقبل وفاته بوقت قصير، شعر بالسعادة عندما انتصر في دعوى تشهير ضد مجلة "بانش". صحيح أنها كانت مجلة هزلية، لكنها وصفت كوبريك بالمجنون، وكان يتبع نمطًا مألوفًا، حيث يمزح في المواقف الجادة ويكون جادًا في أمور المزاح.
في إحدى المرات، أثناء تصوير فيلم "سترة معدنية كاملة" (Full Metal Jacket)، وبعد أن قضى فترة طويلة في فحص الكاميرا، همس أحد الممثلين الإضافيين قائلًا: "ابتعد عن الرافعة." لم يُعر كوبريك الأمر انتباهًا واستمر في عمله حتى تدخل ممثل إضافي آخر قائلًا: "ابتعد عن الرافعة اللعينة!". عندها نظر كوبريك إلى الأعلى متسائلًا: "من الذي تحدث؟" رد أحد الرجال قائلًا: "أنا سبارتاكوس"، وانضم إليه آخر قائلًا: "أنا سبارتاكوس"، وهكذا استمرت هذه المزايدات، كعمل يُظهر مقاومة منظمة وتحية تبدو كمحاكاة ساخرة للحظة قام بتصويرها سابقًا من رافعة مختلفة. ستانلي كوبريك من ذا برونكس، الذي كان يصور في مصنع الغاز المدمر في بيكتون، والذي مثّل المدينة المدمرة "هوي"، حيث تخلى للحظات عن التظاهر بالانضباط؛ ضحك واستأنف عمله.