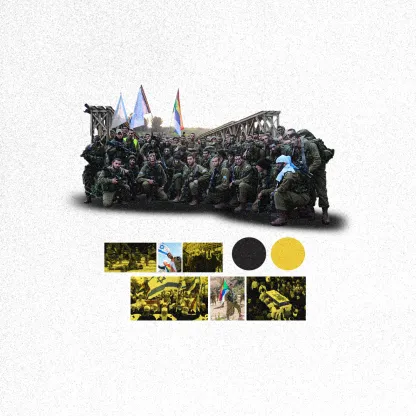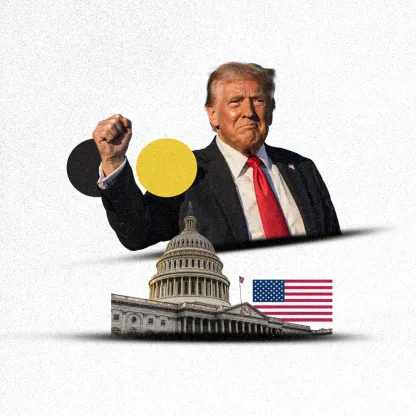مرّ عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي نجم عنها أكثر من 42 ألف ضحية في غزة وحدها، واليوم تتوسع الجرائم الإسرائيلية لتشمل لبنان بالتزامن مع حصار جباليا الذي يهدد ما لا يقل عن 400,000 شخص محاصر في المنطقة كما أكّد فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأونروا، وسط إفادات من شهود عيان تفيد بوجود جثث ملقاة في الشوارع، فيما يلتزم "الوسيط الأميركي" بدعوة إسرائيل إلى معالجة "الظروف الكارثية" في غزة ووقف "زيادة المعاناة" عنهم برفع القيود عن تسليم المساعدات بالتزامن مع إعلانه تزويد إسرائيل بمنظومة "ثاد" للدفاع عن إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.
وهنا يجب التوقف عند مفهوم "الوسيط الأميركي" فالوسيط هو طرف محايد يبذل جهودًا دبلوماسية لرأب الصدع بين طرفي نزاع والتوفيق بينهما، لكن عندما يكون منخرطًا بدعم لا محدود عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا لأحد الطرفين فلا يمكن أن يكون وسيطًا، ومن غير المفهوم النظر إليه كوسيط من الأساس، ومن الخطأ الافتراض أن هناك أي تحفظات لدى الأميركيين بينما يتبنى بايدن وفريقه أهدافًا مشتركة مع إسرائيل، بما في ذلك استهداف لفرض تغييرات تشمل القضاء على حماس وحزب الله، وأي جهة تتجاهل هذه الحقائق وتدعي أن هناك فرقًا بين ما تفعله إسرائيل وما تريده الولايات المتحدة، فهو إما يكذب على نفسه أو على العالم.
في كتابه "سماسرة الخداع: كيف قوّضت الولايات المتحدة السلام في الشرق الأوسط"، يقول رشيد الخالدي إن حرب عام 1967 كانت مشروعًا أميركيًا إسرائيليًا مشتركًا، وافقت خلاله واشنطن على ما كانت تفعله إسرائيل وحمتها في مجلس الأمن الدولي أثناء وبعد تلك الحرب؛ وما نراه من الولايات المتحدة في غزة، وما امتد الآن إلى لبنان، والخسائر الهائلة في صفوف المدنيين التي تُسبب عن قصد، تشكل تهديدًا للنظام القانوني الدولي بأسره، وإذا واصلت الولايات المتحدة ذلك بالتعاون مع إسرائيل، فإن الحواجز التي أقيمت منذ الحرب العالمية الثانية ضد هذه الأنواع من الفظائع سيتم تدميرها على يد ما يروّج لنفسه ويروّج له العالم على أنه وسيط، وسيكون في مقدور أي دولة أو جهة أن تفعل أي شيء دون حساب.
منذ ستينيات القرن العشرين، تبنت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا كصانع للقرارات السياسية في الشرق الأوسط على هيئة "وسيط"، ووفقًا لكينيث شتاين والدبلوماسي السابق صامويل ويليامز، لعبت واشنطن دور "الوسيط الأساسي والجهة الوحيدة القادرة على تقديم حوافز وضمانات موثوقة"، وتركزت هذه الجهود بشكل خاص على الصراع العربي-الإسرائيلي.
كانت أولى الخطوات البارزة نحو السلام في عام 1979 مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، بوساطة الرئيس الأميركي جيمي كارتر. ورغم أن الجهود توقفت في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن واشنطن نجحت في عقد مؤتمر مدريد عام 1991، الذي مهد الطريق لاتفاقيات أوسلو عام 1993. كما لعبت الولايات المتحدة دورًا حاسمًا في تحقيق السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وأشرفت على محادثات بين إسرائيل ولبنان وسوريا، رغم أنها لم تحقق نتائج ملموسة.
ومع دخول القرن الحادي والعشرين، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا في رعايتها لعملية السلام، مكتفية بمحاولات لم تثمر عن نتائج، كسعي بيل كلينتون إلى تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وسوريا في عام 2000 دون جدوى، وإعادة جورج دبليو بوش إحياء مسار السلام الإسرائيلي - الفلسطيني عبر "خريطة الطريق" ثم من خلال مؤتمر أنابوليس في عام 2007 دون أي نتائج تذكر.
واليوم، تحول التراجع إلى انسحاب كامل من دور الوساطة والإعلان رسميًا عن بواطن هذا الدور، فقد تخلت أميركا عن مبادرتها لإعادة السلطة الفلسطينية إلى إدارة الشؤون المدنية في غزة كحلّ لوقف إطلاق النار، وعن استراتيجيتها نحو تنفيذ حل الدولتين، وحتى عن دورها في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والسعودية؛ وتراجعت جهودها لتشغيل نظام فعال للمساعدات الإنسانية في غزة، وفشلت بإعادة فتح معبر رفح وإيجاد حل متفق عليه للسيطرة على محور فيلادلفيا؛ فيما يبدو أن إسرائيل تستعد لتولي توزيع المساعدات والسيطرة على الإدارة المدنية في غزة، وهي خطوة تعني احتلالًا إسرائيليًا مباشرًا وطويل الأمد دون استراتيجية خروج وسط عدم اعتراض أميركي.
صحيح أن مفهوم "الوساطة الأميركية" لم يأت من فراغ، وأن كثيرًا من الأحداث المفصلية في المنطقة تمّ فعلًا بوساطة أميركية، لكن المهم ملاحظة أنها نتجت حينها لأن الأهداف المشتركة تحققت في وقتها، فعلى سبيل المثال لم يتدخل رونالد ريغان لإجبار إسرائيل على وقف قصف لبنان بوحشية عام 1982 إلا بعدما تحققت الأهداف المشتركة وأصبح هذا القصف لا معنى له، فمنظمة التحرير الفلسطينية كانت قد وافقت على الانسحاب من لبنان والحرب الأهلية انتهت، وهنالك أطراف سياسية حليفة لأميركا وإسرائيل قريبة من الحصول على السلطة؛ وهذا ينطبق على اتفاقيات السلام مع مصر والأردن والتي جاءت بعد حسم العديد من الأهداف المشتركة.
لكن اليوم لم تتحقق بعد الأهداف المشتركة في لبنان وغزة، ولذلك لم ولن تكون أميركا وسيطًا بالمفهوم القديم الذي اعتاده الساسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بل هي طرف فاعل ومتورط حتى أذنيه فيها وما الحديث عن القضايا الإنسانية والخسائر المدنية إلا مجرد نفاق سياسي يخفي وراءه موافقة على إستراتيجية إسرائيل التي تتمثل في استهداف المدنيين عمدًا بغية إحداث تغيير ديموغرافي، وليس سياسيًّا فحسب، في لبنان وغزة.
نحن نشهد ليس فقط على أكبر مجازر التاريخ الحديث، بل على أكبر حفل تهريج أممي، فاللهاث وراء واشنطن للتوسط لدى إسرائيل بإيقاف الحرب يعني تصديق أنها مستعدة للتخلي عن إستراتيجيتها المتعلقة بالأمن القومي، ووقف تدفق مليارات الدولارات من الإنتاج المحلي للسلاح والاستغناء عن آلاف الوظائف في مصانع الأسلحة الأميركية التي تتلقى نحو 60% من حزمة المساعدات التكميلية لإسرائيل لتجديد المخزونات وتوسيع القدرات الإنتاجية، مما يُعزز من أرباح شركات الأسلحة الكبرى، حيث ينفق نحو 3.8 مليار دولار، وفقًا لأحدث اتفاقية تفاهم وُقّعت خلال فترة باراك أوباما، على مشتريات من شركات الأسلحة الأميركية دون أي رقابة تذكر.
وخلال العام الماضي، وخلال الحرب على غزة، كانت بوينغ وRTX أهم الشركات الأميركية التي قدمت معدات عسكرية لإسرائيل، وتشمل القنابل والذخائر والصواريخ الموجهة وصواريخ جو-أرض، والتعاون مع شركة رافائيل الإسرائيلية لإنتاج صواريخ لنظام القبة الحديدية، كما تُبرز شركة جنرال ديناميكس أيضًا دورها في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، حيث تنتج القنابل الثقيلة التي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.
لا يمكن بأي حال لإسرائيل استخدام أسلحة أميركية متطورة وتشغيل طائرات F-35 التي تشكل نقطة القوة الأكثر أهمية لجيشها دون موافقة الولايات المتحدة على ذلك، وهو أمر لا ينحصر بشخص جو بايدن، رغم أنه داعم مخلص لإسرائيل وتلميذ غولدا مائير النجيب، بل هو حال معظم النخبة السياسية في الولايات المتحدة المعزولة تمامًا عن الرأي العام الأميركي، بما في ذلك نسبة من الجمهوريين الذين يطالبون بوقف تلك الشحنات ويحملون نظرة سلبية تجاه سياسات نتنياهو، لكن كل هذا لا يساوي شيئًا في واشنطن التي قدمت أثناء وساطتها لوقف إطلاق النار أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل لتستخدمها بينما تكسب لها الوقت في مفاوضات عبثية.
لا يمكن أن تنجح وساطة في الحرب على غزة طالما أن الولايات المتحدة طرفًا فيها، سواء انتخبت كاميلا هاريس أم عاد ترامب، فمجرد وجود أميركا على طاولة المفاوضات يعني أن إسرائيل لها صوتين، هذا عدا عن غياب موقف عربي موحّد يشكّل ورقة ضغط، خصوصًا مع تقاطع عدد من المواقف الرسمية، ولو سرًا، مع الأهداف الأميركية والإسرائيلية في القضاء على حماس وحزب الله، وبالتالي فإن استمرار هذا الشرخ في الموقف العربي وعدم جديته يضيف صوتًا ثالثًا في صالح إسرائيل ولو بشكل غير مباشر.
في مقابلته مع مجلة جاكوبين، لفتَ رشيد الخالدي إلى أن تغييرًا كبيرًا ومؤثرًا في الرأي العام الأميركي يحدث بالفعل عقب الحرب على غزة، لكنه لن يؤدي إلى نتائج سياسية في المدى القصير، فمن سيُنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر، وأي حكومة ستحكم في السنوات القادمة في هذا البلد ستكون على الأرجح ملتزمة، كما كانت الحكومات السابقة، بالدعم الثابت للأهداف الأساسية لإسرائيل، حتى لو كانت هناك خلافات تكتيكية من وقت لآخر، ذلك لأن النخبة الأميركية لم تتغير على الإطلاق. والأشخاص الذين يملكون السياسيين والذين يعتمد السياسيون على ملايينهم وملياراتهم للبقاء في مناصبهم لم يتغيروا. هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم الذين يملكون الشركات الكبرى ووسائل الإعلام والمؤسسات والجامعات؛ ومن يدفع المال يحدد الاتجاه، والاتجاه الواضح والصريح هو استخدام القوم لتحقيق أهداف مشتركة، وهي سياسة كانت فعالة لغاية نهاية القرن الماضي ربما، لكن لا يمكن أن تنجح في القرن الحادي والعشرين.
هذه السياسة لن تنجح على المدى البعيد في أي مكان، لكنها بالتأكيد لن تنجح في حالة إسرائيل بالذات بحسب الخالدي، لأن مشروع إسرائيل يعتمد بالكامل على الدعم الخارجي، وكان كذلك دائمًا، ولم يكن أبدًا مشروعًا مستقلًا تمامًا أو فكرة قابلة للحياة بذاتها، وإلا لما ذهبوا إلى بريطانيا للحصول على وعد بلفور، أو إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار التقسيم، ولما ذهب شارون للحصول على موافقة هيغ في عام 1982 لشن الحرب على لبنان.