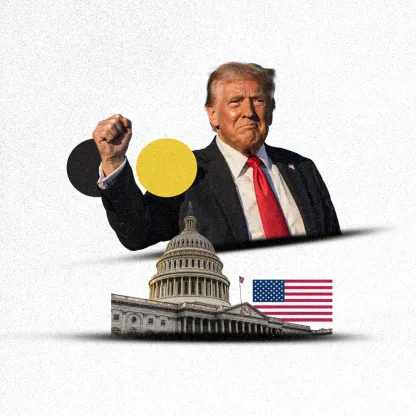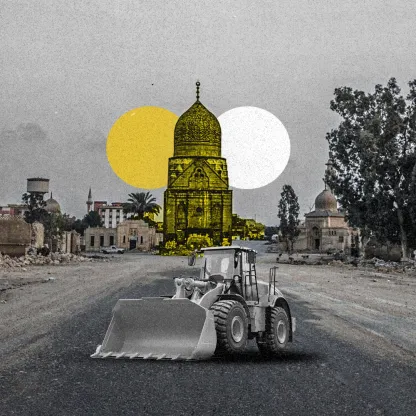يؤمن الفلسطينيون أن الكتابة في أي قضية من الممكن أن تغيّر شكل العالم، إذ تعد الأعمال الأدبية مصدرًا مهمًا لتوثيق الأحداث التاريخية التي مروا بها، وشكّلت مفصلًا من مفاصل الثورة الفلسطينية. ولا يكتمل أي عمل أدبي في سِيَر الفلسطينيين دون ضمه إلى فصول الحركة الأسيرة، ذلك أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني تعرض للاعتقال، ولو لمرة واحدة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ولكل من هؤلاء حكايته التي يجب أن تُسجّل عبر الصنوف الأدبية لتخرج على شكل كلمات من وراء الأسلاك الشائكة متخفيةً عن بارودة الحرس، معتبرين القلم أداةً للمقاومة بعد الاعتقال، والورقة ساحة المعركة على كل الجبهات. وعليه، فهو أيضًا أدب شهادة ينقل عبرها المعتقل ما يعانيه داخل السجن ليكون شاهدًا يحمل إلى العالم صوتًا صادقًا يحكي حقيقة ما يجري هناك، حيث الكتابة فِعلٌ مُحرّم.
ويشتهر أدب المعتقلات في التراث الفلسطيني، المليء باليوميات والمذكرات الشخصية والسير الذاتية، نتيجة استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ 7 عقود اعتقل خلالها، ولا يزال، أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين. وتعد الحالة الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من هذا الأدب الذي يغلب عليه طابع المقاومة ويدوِّن أصعب المراحل التي يمر بها مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأدب الوطني، وبالتالي الأدب العربي المعاصر، والأدب العالمي الحديث، عدا عن أنه جزء من القصة الفلسطينية الكاملة.
ينفرد أدب الأسرى الفلسطينيين بين غيره من الأجناس الأدبية الأخرى، كما يحتل مكانة بارزة في المنتج الأدبي الفلسطيني، كونه كتابة حُرة خطّها المقاومون من داخل الزنازين. وهذه الأعمال الكتابية لا تشترط أن تكون مُدرجة تحت لونٍ أدبي، أو أن يكون كاتبها متمكنًا من أدوات الكتابة الإبداعية. ففي زنزانته الضيقة، يُطلق المحكوم الفلسطيني العنان لمخيلته، فيُنتج أدبًا استثنائيًا يحمل خصوصية معينة ويجب أن يُعامل بانفرادية في مختلف أنواع القراءة: العادية، الانطباعية، النقدية. وبالمثل في عملية نشره وترجمته والترويج له، سواء كُتب خلال فترة الاعتقال أو بعد نيل الحرية. وأمام كل ما سبق، بات هذا الأدب من أبرز علامات الأدب الفلسطيني المقاوم ليس تبعًا لمضامين موضوعاته فقط، وإنما للمغامرة الكُبرى التي يتحمل أخطارها كُتّابه بالدرجة الأولى.
على هامش الحرب
لم تكن الكتابة رغبة مشروعة للأسير الفلسطيني، في ظل سياسة السجان الإسرائيلي، حتى منتصف الثمانينيات وبعد أن دفع لقاء الحصول عليها ثمنًا نضاليًا كبيرًا، ليكون القلم والورقة والكتاب أول إنجازاته التي قاتل بأمعائه لتحقيقها عبر الاحتجاج المباشر من خلال الإضراب عن الطعام مطلع السبعينيات. قبل ذلك، قمع الاحتلال الإسرائيلي معتقليه الأسرى، ومارس عليهم قهره بفرض سياسة الحصار الثقافي من خلال الحظر التام على كل وسيلة ثقافية في عام 1967، ليمنعهم من أبسط الحقوق الإنسانية مثل الحق في القراءة عبر منع إدخال الورق، والحق في الكتابة بمنع إدخال القلم.
وما كان ليُستجاب لهم لولا الإضراب الكبير الذي عم المعتقلات عام 1970، حيث أدرك المعتقلون خطورة الوضع الذي يعيشون فيه وشعروا بالفراغ المعرفي، تحت ضغط عدم تواصلهم مع العالم الخارجي، وفهموا أنهم في عزلة مقصودة ومبرمجة بخطة مسبقة، فقاموا بوضع مطلب القدرة على الكتابة قبل مطالب أساسية أخرى، وأصرّوا على إدخال المواد التثقيفية التي ماطلت إدارة السجون الإسرائيلية في إدخالها، حتى عبرت بعض المطبوعات المختلفة والقرطاسية المتنوعة من خلال الصليب الأحمر الدولي، والتي كان المعتقلين في الزنازين يحمونها بدورهم من المداهمات الفجائية، حتى يأتي الوقت الذي يستطيعون فيه أن يخرجوها من أسرها هي الأخرى.
وفي المقابل، وضعت إدارة السجون قيودًا من نوع آخر لاستجابتها المشروطة تمثلت في إخضاع المواد المقروءة للرقابة التي تعمل على تدقيق محتواها وفحصها أمنيًا، بحيث يتمكن من تحديد نوعية الكتب المسموح بإدخالها، ثم فرضت على كل معتقل ألا يقتني أكثر من كتاب واحد. وفي حالات كثيرة، كانت تمارس عقابها الجماعي بمصادرة تلك الإصدارات من زنازين المعتقلين، التي كانت تتعرض لتفتيش يتم من خلاله قلب الغرفة وتحطيم محتوياتها والعبث في أغراضها، في محاولة لتطويع إرادتهم وكسر المقاومة لديهم وإحباط عزيمتهم وزعزعة صمودهم.
وعندما كان الحصول على ورقة أو قلم حلمًا مستحيلاً، استخدموا مغلفات الزبدة والجبنة واللبنة للكتابة عليها. وبعد الكثير من الخطوات النضالية لانتزاع حق مراسلة عائلته، حصل الأسير على صفحة واحدة مطبوع على أحد وجهيها أقل من عشرة أسطر ليكتِب فيها إلى أسرته التي ترد عليه في وجهها الآخر، ما أتاح له رفاهية الاحتفاظ برسائله وردود أهله عليها.
وقد شكلت رسائل المعتقلين إلى ذويهم نواة الأعمال الأدبية لأنهم اضطروا إلى استخدام مجازات في الكتابة للتعبير عن أحوالهم هربًا من عيون الرقابة العسكرية على أسطرهم المكتوبة، وهذا التمويه أنتج مع الزمن الأدب الذي انتُزِعَ من السجان انتزاعًا.
ومع كل إضراب جماعي كان الأسرى الفلسطينيون يفتحون مكتبات لهم في سجون إسرائيل، فزادت ثقافة المعتقلين ليصدروا عدة نشرات أدبية كانت تكتب بخط اليد وتوزع فيما بينهم، ما أدى إلى تطور مضمون الأدب الذي ينتجونه من مجرد ممارسة تفريغ أو تحريك هواية إلى مشاركة نضالية في أحداث الانتفاضة الأولى عام 1987، فتمكنوا من إصدار مجموعة من الأعمال الأدبية وتهريب مسوداتها الأولية التي حملت بصمات التجربة لرواياتهم التسجيلية التي عايشوها، من الخواطر إلى الشعر والقصص القصيرة فالروايات ثم المسرح حتى الدراسات التي أخذت الصحف والمجلات ودور النشر تطبع نسخها وتروج لها.
الكتابة كفعل نضالي
على امتداد المعاناة الفلسطينية منذ نكبة عام 1948، لجأ العديد من الأسرى إلى وصف تجربتهم الاستثنائية عن الغد المأمول والواقع المعاش عبر الكتابة التي فضحت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القاسية بحقهم، بين المنع والعزل والترويع والإهمال، وما كان لأحد أن يصدقها لولا أنها كُتِبت في تحدي السجان كميدان جديد للقتال، معتبرين الأدب المقاوم جزءًا لا يتجزأ من معركتهم التحررية التي يتعين عليهم خوضها على كافة الأصعدة ومنها الميدان الثقافي.
ومثلت الكتابة قيمة نضالية يمكن من خلالها الوقوف على مراحل تجربة الاعتقال وخصائصها والتعرف على مستوى تطور المعتقلين. وتبدأ هذه الحكاية بتفاصيل تضغط على الأعصاب وتسحق للحظات بعضًا من الأمل، ثم تجميع الأفكار وتمرير الأقلام وتأمين الورق للكِتابة، تحت ضغط نفسي كبير بين فقدان الخصوصية والمراقبة الإسرائيلية التي تقطع حبل الأفكار، ذلك أن الإبداع الكتابي هناك لا يولد في أجواءٍ مريحة، فالأسير لا يكتب على طاولةٍ في غرفة بيته، بل داخل بيئة تفيض بالتوتر في ظل سيطر إدارة السجون وتفتيش الجنود المستمر.
ولم يأت هذا تنفيسًا عن لحظة اختناق أو تخليدًا للحظة بطولة، وإنما تعبيرًا عن حالة إنسانية وأبعاد فكرية ورؤى نضالية حتى تُبلع الكبسولة، واحدة من أشهر الطرق التي ذاع صيتها في مطلع التسعينيات التي ابتكرها الأسرى الفلسطينيين لمواجهة مصادرة الإنتاج الفكري من الجنود الإسرائيلين عبر أمعاء أحد الأسرى المحررين. فكانت الكتابة تتم بسرية تامة وبخط صغير وفي ورقة واحدة متراصة، تُلف إلى أصغر حجم يجعلها أشبه بحبة دواء، وتغطى بقطعة بلاستيكية لتصبح قابلة للبلع، ثم تُنقل عبر أمعاء الأسير المحرر لتهريبها خارج قضبان الزنزانة، وترى السماء قبل صاحبها الذي يخاطر بحياته من أجل نقل قضيته الداخلية إلى العالم الخارجي، فكم كبسولة يتم بلعها في عملية التهريب ليكتمل العمل الأدبي الواحد؟
إن تهريب الكتابة كانت ولم تزل مغامرة متفردة، وهو ما يضيف لها بُعدًا آخر يجعلها تحمل قيمة استثنائية تفوق حدود الأدب نفسه، لتصبح حديث الطاولات الأدبية في الحلقات النقاشية المختلفة عبر البلاد العربية. فهذه التضحية لا تتم دون مُخاطرة تمر على الجميع: الذي كتب وهرّب وجمع ونشر وروّج وقرأ. فكانت الكتابة معركة صمود سجلها الأسرى الفلسطينيون، إذ كان الأمر أقرب للعبقرية، ذلك أنه كلما طالت فترة التأليف فإن الاحتفاظ بالمادة يكون صعبًا والخوف من ضبطها ليتم مصادرتها يزداد.
وواحدة من الأساليب التي مُورِست على الكاتب الفلسطيني في المُعتقل سياسة الإفراغ الفكري التي تهدف إلى زرع ثقافة مشوهة بديلة، تعمل على صياغة نفسية المعتقل وتطويعها وفق إرادتها، ليصبح العمل الثقافي داخل المعتقل عبارة عن ضرورة قصوى لاستمرارية الحياة الفلسطينية المكافحة. فالأسير الفلسطيني ليس رقمًا يُنادى به أو صورة تُعلق على الجدار، إنما حالة مُنتِجة ما قبل الاعتقال، وفي الأسر، وبعد التحرر.
نماذج حية للمقاومة
ثمة أسماء عديدة كتبت في الأدب خلف الزنازين. ومع ذلك، تتفرد نتاجات الأسرى عن غيرها، سواء من العربية أو حتى تلك العالمية، بحبكتها وما تتضمنه من أوصاف غنية وشموليتها من حيث الكيف بين تجارب مختلف الثقافات، خاصةً في ظل الاحتلال الإسرائيلي الأطول في تاريخ البشرية، إذ لم يبق شعب من شعوب العالم تحت الاحتلال غير الشعب الفلسطيني. فالسجن من أكثر الموضوعات التي تناولها الكاتب الأسير في أولى تجاربه، حيث كتب عن مساحته الضيقة على جسد واحد فيها، وقضبان الزنازين التي تمنع عناق الأصابع، وعقوبة العزل الانفرادي التي ينسى فيها الأسير ما كان اسمه قبل أن يُنادى برقم طُبع عليه.
في المقابل، خرج سرد البعض الآخر عن النظرة التي تؤطر أدب الأسرى داخل السيرة الذاتية والسيرة التوثيقية، وقدّموا حكايات تجعلنا ننظر من الداخل إلى الخارج، حيث تكون رؤية الأمور مختلفة طالما أننا نطل برأسنا من عالم السجن بكل ما فيه من عتمة. وما يلفت هنا هو الانفتاح على مضامين أخرى في الموضوعات المتناولة عبر السؤال الجوهري: ماذا يعني أن تكون إنسانًا حرًا؟
الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالمؤبد 67 مرة، مثلًا، اختار جنس أدب الرسائل في كتابه "أمير الظل: مهندس على الطريق" مدونًا تجربته بنفسه لما يتمتع به من قدرة على التعبير، ليرد في 165 صفحة على رسالة ابنته الكبرى التي عبئتها بالاستفهام: "من أنت؟ ولماذا أنت؟"؛ تسأل عن الأب الذي لم يحملها إليه في لحظة اعتقاله، وعن سفره إلى المؤبد الذي لا يُعرف موعد الرجوع منه. فقرر أن يعرض تجربته بعودته إلى فلسطين في نهاية التسعينيات، والصدفة التي جمعته بالمقاومة، ليصير خليفة الشهيد يحيى عياش بخبرته في تفخيخ السيارات وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.
واتجه الأسير حسن سلامة لكتابة اليوميات في عمله "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ"، الذي سلط فيه الضوء على مرحلة الحبس الانفرادي التي تُمارس كعقاب شديد القسوة على المعتقل الأعزل، وهو المحكوم بـ48 مؤبدًا قضى منها 27 عامًا في السجن، منها خمسة آلاف يوم في العزل الانفرادي. وعلى امتداد صفحات الكتاب، يصف سلامة ما يعانيه من الناحية النفسية بشكل أكبر من الناحية الجسدية وإن كان الجانب الأخير حاضرًا في الكتاب، مثل كيف تخلق إدارة السجون النزاعات بوضع الأسرى الفلسطينيين مع معتقلين إسرائيليين محكومين بقضايا جنائية داخل غرفة واحدة، ووجود محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
وعلى المنوال نفسه، كتب الأسير ناصر أبو سرور السيرة الذاتية في عمله "حكاية جدار"، عبر عصف ذهني مدعم بالتجربة الشخصية وممتد على مدار 324 صفحة، مستعرضًا مرارة الاحتجاز بسرد يظهر الحسرة في العيش دون أن يكون له التأقلم وحيدًا مع ما أمامه من جدار، عبر التجريب ولمس الشعور وليس مجرد الحديث عنه أو نقله للإحساس به، لتنبعث رائحة الجدار العازل وجدار المعبر وجدار المخيم وجدارالسجن.. بيته الأخير، ويغطوا على الرائحة التي في داخله؛ عاجزًا عن تخطيها. فحياة الفلسطينيين محاطة دومًا بالجدران، وبحرفة يستطيع الإسرائيليون عزلها عن بقية العالم.
أما الأسير وليد دقة الذي غادر العالم من داخل معتقله، فاختار أن يبقى الأثر النضالي الفلسطيني، بحيث لا يتخلف عن الرحلة الثورية التي كان جزءًا منها في كتابه "حكاية سر الزيت" المكتوبة لليافعين. وهو رسالته التي كان يخشى أن يموت قبل إيصالها إلى الناشئين، لتبقى القضية في طريق طهارتها ذاته. فكتب من سجن جلبوع عن جود الطفل الذي هرب من نطفة أبيه في المعتقل، وعقابًا له حرمه الاحتلال من زيارة والده إلى الأبد، حيث يصبح سؤال "كيف يرى الابن أباه دون أن يقدم على تصريح أمني"، سؤالاً إنسانيًا وسياسيًا في الوقت نفسه.
كما ذاع صيت رواية "ستائر العتمة" للأسير وليد الهودلي التي تحكي عن تجربة التحقيق في السجون، ولاقت رواجًا لتُطبع 12 مرة ثم تتحول إلى فيلم سينمائي. وعبر هذه الرواية، ينقل الهودلي عبرها تجربة الاعتقال ورحلة التحقيق وظروف السجن، مستعرضًا أساليب التعذيب التي يواجهها الأسرى على يد المُحققين الإسرائيليين بهدف الضغط عليهم لسحب الاعترافات منهم، مثل عمليات الشبح المتواصلة التي تتم عبر تقييد الأسير على كرسي وربط يديه وقدميه إلى الخلف لساعات طويلة وحرمانه حتى من النوم، إلى جانب ممارسة اعتقال ذويه كوسيلة للضغط عليه كي يعترف بما يُمليه عليه المحقق الإسرائيلي.
أما حكاية "العاصي" للأسير سائد سلامة، وعلى خلاف سامة، فقد طُرِحَ فيها سؤال البطولة في الزمن الصعب، عن فعل النضال في وسط يعاديه، ساردًا ما جرى معه لحظة اتخاذه قرار بطعن مستوطن، دون أن يركز على الفعل نفسه وإنما جاءت لتظهر تأثر من حوله ممن هم أهل المكان. كما يتحدث عن كيف ظلت يده تنزف من دون أن يجد أحدًا يسعفه حتى أصبح مطاردًا، وحلل كذلك ما قام به كفعل ثوري يشتبك مع الحياة تحت الاحتلال. ولأن الاعتقال بات متوقعًا للجميع عنده، يحفزنا بالتفكير حول السجن الأكبر في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يوازيه في المعاناة بالعيش داخل سجونهم الأصغر حيث حُكم المؤبد يطال الجميع.
وكان لوليد دقة منهجًا مغاير في انتزاع حقه بالكتابة، ليكتب دراسة "صهر الوعي أو إعادة تعريف التعذيب" التي وصف فيه طرق التعذيب التي تأتي في عصر ما بعد الحداثة ويجري فيها استهداف العقل، وهو تعذيب كما يقول أشد وطأة بحضاريته ويهدف إلى إعادة صياغة البشر عبر صهر وعيهم. ليأتي هذا العمل كمحاولة فكرية مكشوفة تبحث في تفسير ما يعجز الأسير عن استيعابه حول ما يجري له ذهنيًا، لا كقضية إنسانية وإنما كحالة سياسية. ويربطها بوسائل القوة المفرطة في ملاحقة المطاردين أو هدم بيوتهم التي عاشوا فيها بأيديهم، الأمر الذي يرفع من كلفة الفعل المقاوم وبالتالي إعادة تشكيل المحيط الحاضن له.
وغيرها الآلاف من أعمال أخرى لفلسطينيين ذاقوا مرارة ما فرضته عليهم إسرائيل المحتلة.
تبني النص الفلسطيني
دخل أدب الأسرى الفلسطيني، أخيرًا، مرحلة جديدة تتسم بالاحترافية في الكتابة والقصدية في تمرير الحبكة السردية، وتعزيزها بأدوات فنية لم تكن متوافرة في الماضي. وهو ما يضع التجربة الأدبية تلك في مكانة مختلفة، ومرتبة متقدمة في سياق الأدب الفلسطيني. فمنذ ولادة الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نجح أدباؤها بفضح زيف الرواية الإسرائيلية وتثبيت الرواية الفلسطينية التي توضح تشبُث الفلسطيني بأرضه. وهناك أعمالاً أدبية أخذت شهرة ومكانة لتطبع أكثر من مرة، ويتم ترجمتها إلي لغات أخرى، وأخذت رقمًا في وزارة الثقافة الفلسطينية، وتم إجراء الأبحاث عليها وتحويلها إلى دراما تلفزيونية وأفلام سينمائية أو أعمال مسرحية.
وقد دفعت تجاربهم في الكتابة وزارة الثقافة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة مشتركة تنشر المواد التي ينتجها أبناء الحركة الأسيرة، وبدوره قام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في استحداث دائرة الأسرى في أمانته العامة تثبيتًا للسردية الفلسطينية أمام ادعاء رواية الاحتلال الإسرائيلي. فيما تبنت عائلة الأسير باسم خندقجي، الذي يقضي حكمًا مدته ثلاثة مؤبدات إطلاق مبادرة "صندوق الأسير باسم خندقجي" لدعم أدب الحركة الفلسطينية الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال المكتبة الشعبية بمدينة نابلس التي نشرت العديد من مؤلفات الأسرى، وعملت على توزيع هذا الأدب في كافة أنحاء فلسطين التاريخية وبعض الدول العربية. فأثبتوا أن الأسرى ليسوا أرقامًا مُسجلة، وإنما فيهم الأدباء المبدعون الذين باستطاعتهم إمداد التاريخ الفلسطيني بمواد أدبية مختلفة.
ويبقى هناك ما هو مجهول من إبداعات الأسرى الأدبية، وما تم مصادرته من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وهو أكثر بكثير مما نعرفه.
وفي حين أن الأرض تتسع لكل أحلام الفلسطينيين، رفض أسراهم أن تُقص أجنحتهم وأن يبقوا داخل القفص، حتى لو قضوا عمرهم بين الزنازين يصفون لحظتهم الأخيرة مع فلسطين، بحبر لا يستجيب للتذويب في مكان مقيدين به ضد إرادتهم. بل تواصلوا مع مجتمعهم الفلسطيني وشغلوا بال كل فلسطينيٌ بمفهوم التحرر بفعلهم النضالي الكتابي، وتثبيت ورقة مهمة من أوراق الحكاية الفلسطينية، لتصبح دليلاً آخرًا على أن أرضها لم تكن خالية من الشعب، إنما كانوا أسرى لدى إسرائيل.