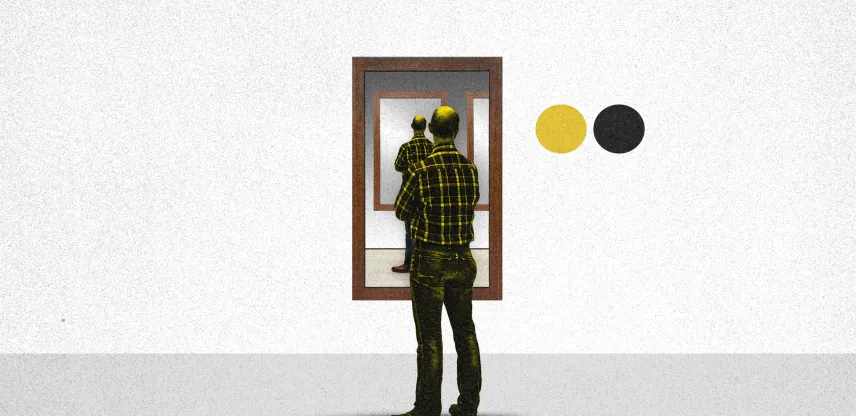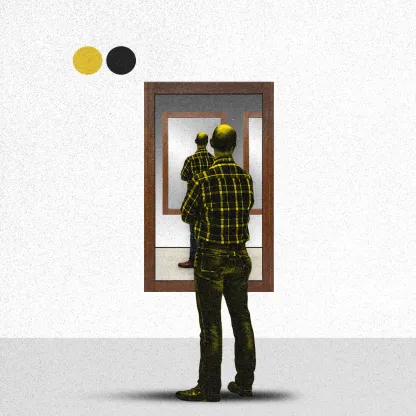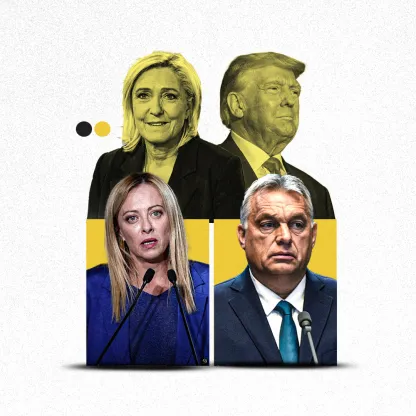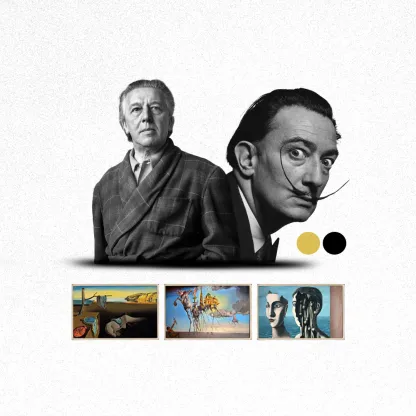بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل من شأنها زعزعة الاستقرار العالمي، احتُلَّ العراق بحشدٍ دولي قدّم نفسه بوصفه حريصًا على الدفاع عن الأمن والاستقرار الدوليين المقوّضين من قِبل العراق، لكن الحقيقة هي أن نية هذا التحالف المبطنة كانت التخلص من دولة عربية إقليمية لديها تأثير نسبي في حبك المعادلة السياسية في المنطقة على نحوٍ مستقل. غير أن العراق، أمام ادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل وما رافق ذلك من سرديات ودعاية وضغط دبلوماسي، تحول إلى خصم "متوحش" يفتقد شرعية الوجود أمام حلف غربي ينطلق نحوه بعدة وعتاد قلّ انتقاده من قِبل الدول الأخرى بحجة أن التحرك ضده شرعي لأن الهدف منه ضمان الاستقرار الدولي.
إنها حرب الشرعيات التي يخوضها الخصوم ضد بعضهم قبل الاشتباك المباشر. حربٌ يخوضونها سعيًا لنيل أعلى مستوى من الشرعية على نحوٍ يمكّنهم من استخدام كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية دون التعرض للانتقاد، على اعتبار أن هذه التحركات شرعية تأتي في إطار حق الدفاع عن النفس أو حفظ الاستقرار الدولي، عبر ردع دولة ما أو غزوها أو عبر التعامل مع قضية ما بحزم. وبينما تختلف هذه الذرائع من دولة إلى أخرى، إلا أنها تلتقي عند الهدف نفسه: كسب الشرعية لتبرير أي تحركٍ أمني أو عسكري تُقدم عليه دولة ما. وتُعد هذه الشرعية جزءًا من استراتيجية "الأمننة". فما هي أسس وتفاصيل هذه الاستراتيجية؟
شيطنة الآخر لكسب الشرعية
ربما اتضحت فكرة المقال بالمثال الذي افتُتِح به، فالهدف الأساسي من استراتيجية الأمننة إضفاء الشرعية على التحركات التي تقوم بها دولة ما لتحقيق هدف معين، وبالتالي عدم الانشغال بتبرير طبيعة الإجراءات المُتخذة أثناء القيام بهذا التحرك، الذي لا بد أن تنشغل دول وجهات سياسية بالغوص في مناقشة شرعيته ومبدأ التناسب في تحقيق الهدف، وبالتالي قد تنتهي الدولة من تحقيق هدفها المنشود بينما لا تزال الدول الأخرى تُناقش منطلقات التحرك. وفي هذا الإطار، غالبًا ما يوفّر وصم الخصم بأنه "شيطان" أو يمثّل "شرًا مطلقًا"، نصف الطريق للمحاججة في دواعي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المعنية ضده.
لقد نُسجت استراتيجية الأمننة في أروقة جامعة كوبنهاغن، من خلال دراسة صدرت عن الجامعة عام 1985. كان الهدف الأساسي لهذه الدراسة حينها تطوير المفهوم الأمني وصياغة أركانه وفق التغيرات الطارئة على الساحة الدولية، لا سيما تلك المتعلقة باتساع نطاق نفوذ المنظمات الدولية وزيادة روابط التشاور الشفاف بين الدول، ما أوجد حاجة ملحة لإطار جديد يمكّن الدول من تحقيق مصالحها والتعامل مع التهديدات الأمنية بطريقة من خلال مبررات مقبولة على المستوى الدولي، وبمعزل عن التحركات الأحادية التي لا تستند إلى مبررات قانوني تواكب شيطنة الخصم، وتحول أيضًا دون التعرض لعقوبات متعددة. بإيجاز، من الواضح أن أساس استراتيجية الأمننة تطويع المهارات الإعلامية والخطابية، إلى جانب القانون الدولي، كأداة لشيطنة الخصم والتحرك ضده بهدف تجنب العواقب السلبية.
عندما طُرحت استراتيجية الأمننة، لم يكن الهدف منها فقط استحداث سبل شرعنة تحركات الدولة عسكريًا أو أمنيًا خارج حدودها، بل هدفت أيضًا إلى تسليط الضوء على التهديدات غير العسكرية التي يمكن أن تهدد أمن الدولة، مثل: تيارات فكرية متطرفة، أو احتكار اقتصادي/إنتاجي، أو استهداف الذاكرة الجماعية إعلاميًا، أو التلوث البيئي.
وبناءً عليه، يُلاحَظ أن هذه الاستراتيجية أرادت لفت انتباه الدول الأوروبية، تحديدًا، إلى تهديدات متعددة الأبعاد مصدرها تطور وسائل التواصل، وارتفاع معدلات الهجرة مع سهولة تنقل الأفراد. وهنا يتضح أن الأمننة تقوم على تحويل بعض القضايا العامة من سمة اقتصادية أو سياسية، على سبيل المثال، إلى منظور أمني صارم، وذلك بغية دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية ضد أي قضية عامة من شأنها أن تصبح مشكلة أمن قومي.
ولكسب الشرعية في الساحة الدولية، وتبرير تحرك الدولة ضد المخاطر الأمنية الداخلية، تقترح استراتيجية الأمننة 4 خطوات تمكن الدول من تحقيق هدفها في مواجهة التهديدات:
1. إعلان طرف ما بأنه خصم يشكّل تهديدًا وجوديًا، أو تحديد أمر على أنه خطر جسيم مع التعريف بحجم الارتدادات السلبية لهذا الطرف أو ذاك الخطر على الأمن القومي. وهنا يتم تحويل حدث ما إلى قضية عامة محاطة باهتمام سياسي كبير يعرّفها في نهاية المطاف بأنها قضية أمنية فادحة يضمر من يقف ورائها الشر لأمن البلاد واستقرار العالم ككل، وبالتالي تستدعي مضافرة الجهود لمواجهتها.
2. إقناع الكيان المرجعي، الشعب والساحة الدولية، بضرورة تدعيم جهود الدولة في صد هذا الخطر.
3. إجراء تحركات استباقية من قبيل سبق الخصم في الاتجاه نحو مجلس الأمن واتخاذ تحركات حقوقية مثل المقاطعة أو الاستنكار.
4. اكتساب شرعية التحرك باسم المصالح القومية العليا بداعي الحفاظ على بقاء الدولة.
تعقيبًا على هذه الخطوات، ربما من السهل الالتفات إلى ما هندسته دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب عملية طوفان الأقصى، حيث "أمنَنَت" تحركها ضد قطاع غزة والفلسطينيين عمومًا. وقد تجلّت خطوات الأمننة في إعلان "حماس"، وسكان قطاع غزة بأكملهم في تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، تهديد وجودي لأمن إسرائيل، بل و"حيوانات متوحشة" تُهدد الاستقرار العالمي ومكتسباته في الحرية والديمقراطية.
كانت هذه الخطوة الأولى التي شيطنت أهالي قطاع غزة وعدَّتهم تهديدًا وجوديًا. أما الخطوة الثانية فتُرجمت عبر سرديات تقنع الإسرائيليين والدول الغربية بدعم الجيش الإسرائيلي (المُقدم على ارتكاب إبادة جماعية)، عبر الادعاء بأن أهالي قطاع غزة ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الإسرائيليين تشمل قطع رؤوس الأطفال واغتصاب للنساء. ورغم أن هذه الاتهامات مجرد شائعات وأكاذيب لا تستند إلى دليل، إلا أن نشرها، وكذلك التشدق بـ"حق إسرائيل في الوجود" باعتبارها دولة ديمقراطية تحتضن ضحايا الهولوكوست، وُظف كخطوة ثانية لحشد التأييد الإسرائيلي والغربي مع للجيش الإسرائيلي.
الخطوة الثالثة تمثّلت في الاتجاه فعلًا إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبة كثير من الدول بإدانة بل ولعن ما حل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. أما الخطوة الأخيرة، فجاءت بكسب شرعية زُعِمَ بأن إسرائيل تمتلكها بالركون إلى ركيزتين: الرد على هجوم إرهابي، واستخدام حقها في الدفاع عن نفسها.
ولعل هذا ما سبق يمثل نموذجًا عمليًا وقريبًا من استناد دولة ما إلى "الأمننة" لحشد الدعم بهدف مواجهة أمر يشكّل، بالنسبة لها، خطرًا وجوديًا أو جسيمًا، وسط تجميلها أو تخفيفها لفظاعة الانتهاكات تحت ذريعة أن ما تقوم به أمر شرعي. والتاريخ حافل، تحديدًا ما بعد تسعينيات القرن الماضي، بمثل هذه النماذج.
نماذج عملية.. حياكة التبرير بحبال التمرير!
يمثّل غزو العراق والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كما ذكرنا سابقًا، نموذجًا عمليًا أقرب ما يكون إلى ترجمة لمفهوم الأمننة على أرض الواقع. لكن لا بد من الإشارة إلى أن ذلك لا يعني أن الأمننة تنطوي بالضرورة على شيطنة الخصم، بل قد تُطوَّع أحيانًا في لفت الانتباه إلى المخاطر المُحدقة بالدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي لحشد الجهود في التصدي لها. وكما سلف الذكر، قد تكون هذه المخاطر اقتصادية أو اجتماعية، لكن بعض الحكومات تجعلها قضايا أمنية من أجل الحصول على سلطة مطلقة في مواجهتها.
وفي خضم الحديث عن الأمننة بجوانبها المختلفة، من الجيد الإشارة إلى التحرك التركي شمال سوريا، ما يُعرف بعملية "درع الفرات"، كمثال عملي على هذه الاستراتيجية التي دَرَجت عالميًا منذ نهاية تسعينات القرن الفائت. وفي معرض تحليل التحرك التركي في عملية "درع الفرات"، تُشير بعض الجهات السياسية، النظام السوري تحديدًا، إلى أن العملية بمثابة احتلال. لكن اتهام أنقرة بأنها محتلة لم يتمخض عنه نتيجة قانونية عملية ضدها لأنها اتبعت استراتيجية الأمننة.
قبل إجرائها العملية، ساقت أنقرة، على لسان مسؤوليها ومؤسساتها، خطاب تعرض مواطنيها لخطر داهم من قِبل "داعش"، ذلك الخصم الشرس المعادي للإنسانية، وروَّجت هذا الخطاب عبر سرديات إعلامية جعلت من محاربة "داعش" أولوية تركية لا بد منهها، وإلا تعرض جنوب شرق البلاد للاختراق من قبل المتطرفين.
وبهذا الخطاب، تعاطت أنقرة مع الفواعل الأساسية في سوريا، واشنطن وموسكو، لإقناعهما بأنها القضية العامة الأساسية بالنسبة لتركيا، وذلك تثبيتًا لقاعدة "ليس من المنطقي أن تتفاعل أنقرة مع أي طرف داخل سوريا وهي تواجه تهديدًا وجوديًا". وأيضًا، لتثبيت عرفٍ أمني في تعاملات أنقرة داخل سوريا، أفصحت وزارة الدفاع التركية عن رغبتها الواضحة في الحيلولة دون تمدد نفوذ قوات "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، على اعتبار أن ذلك يشكّل خطرًا هائلًا على أمنها القومي وتماسكها المجتمعي، وهذه النقطة كانت مهمة جدًا لإقناع الكيان المرجعي الممثل بالشعب التركي ذاته.
وفي سياق الخطوة الأولى من الأمننة، شددت تركيا على تحركها ضمن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنحها حق الدفاع المشروع عن حدودها في ظل غياب سلطة قائمة في سوريا، والمادة الأولى من بروتوكول حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية المضاف لاتفاقية جنيف 1949 الخاصة بحماية حقوق الإنسان، إذ تنص هذه المادة على السماح لأي دولة ما بالتدخل لحماية مواطني دولة أخرى في حال كان هناك خطر على حياتهم نتيجة هيمنة جماعات مسلحة أفقدت دولتهم سلطة حمايتهم شرط أن يكون النزاع داخليًا وليس دوليًا.
إضافًة إلى ذلك، اعتمدت تركيا على التقرير المُرسل إلى مجلس الأمن بتاريخ 24 تموز/يوليو وفق المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقضي بإعلام مجلس الأمن، أو الجمعية العامة، بوجود خطر على الأمن الدولي في بقعة جغرافية ما، حيث استندت إلى التقرير المُسند إلى المجلس حول ضرورة إجرائها تحرك لحماية أمنها القومي أمام الخطر الوجودي الذي يشكّله تنظيم "داعش"، موضحةً أن هذا التحرك إجباري في ظل عدم قدرة ورغبة النظام السوري في التحرك ضده فعلًا.
وأشارت وزارة الدفاع التركية أيضًا إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ذكر في المادة الثانية من ميثاقه أن عبد الله أوجلان هو قائده، وبما أن تركيا وكثير من الدول تعتبر "حزب العمال" الكردستاني منظمة إرهابية، فإن الاتحاد الديمقراطي يُعدّ إرهابيًا.
بهذه اللغة الخطابية والأسس القانونية، بررت تركيا تحركها في عملية "درع الفرات" باعتبارها عملية عسكرية لا بد منها، فلم يكن هناك اعتراض دولي، إذ لم تعترض موسكو لكنها طالبت بأن يكون التحرك وفق أسس القانون الدولي، وهذا ما جاء عليه موقف طهران.
أما واشنطن وتل أبيب وباريس، فعبرت عن تأييدها للعملية، وحققت تركيا بذلك الخطوة الثانية من الأمننة القائمة على إقناع شعبها والأطراف الدولية بضرورة إجراء العملية، وأجرت الخطوة الثالثة بإجراء تحركات استباقية برفعها تقرير إلى مجلس الأمن قبل إجراء العملية، وأيضًا استنكارها تقاعس النظام السوري في محاربة التنظيمات الإرهابية. وفي نهاية المطاف، اكتسبت شرعية لتحركها باسم المصالح القومية العليا وتفادت فرض عقوبات دولية عليها.
خاتمة
ولدت استراتيجية الأمننة في المعاهد الأمنية الأوروبية، وتحديدًا جامعة كوبنهاغن. وترمي الاستراتيجية بصورة أساسية إلى حيازة الدولة شرعية راسخة في التصدي للتهديدات المتعددة التي طرأت على الساحة في الآونة الأخيرة.
تقوم هذه الاستراتيجية على شيطنة الخصم، أو التعريف به أو بأي أمرٍ ما، بأنه خطر وجودي يدفع مؤسسات الدولة وحلفاء هذه الدولة نحو مضافرة جهودها للتصدي له بضمان اقتناء شرعية التحرك دون التعرض لعقوبات، أو على الأقل تقديم تبريرات متعددة للتحرك ضد طرفٍ ما كي تُصرف الاعتراضات على هذا التحرك باعتباره تحركًا لصالح حماية الأمن القومي، أو بقاء الدولة ضد خصمٍ شرس أو قضيةٍ خطيرة.
وإن تعرضت لانتقاد، فيكون حول مناقشة مدى شرعية التحرك بمعزلٍ عن العواقب أو الانتهاكات الناتجة عنه، لأن أي انتقاد موجه ضد تحركات الدولة سيُوصف بأنه مساندة للخصم أو التهديد المتربص بأمن هذه الدولة وحقها في الوجود. باختصار، تقول استراتيجية الأمننة: رسخ شرعية التحرك ومن ثم افعل ما يحلو لك!