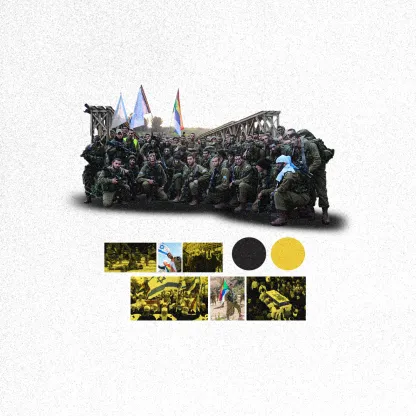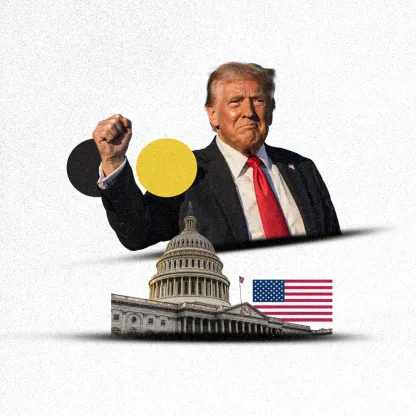يُعدّ مفهوم القوة من أهم مفاهيم النظرية الواقعية في تفسير عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبحسب وجهة نظر الواقعيين، تدور كل أشكال الصراع بين القوى الدولية حول تحصيل أكبر قدر من القوة والمصالح الممكنة، فبذلك وحدَه تستطيع الدولة القومية أن تضمن بقاءها في ظل نظام عالمي فوضوي لا وجود فيه لسلطة عليا، أعلى من سلطة الدولة، قد تَلجَأ إليها هذه الأخيرة إذا تورّطت في المشاكل (واضح هنا أنّ الواقعيين لا يقيمون وزنًا كبيرًا للمؤسسات الدولية كحَكَمٍ وفيصل وسلطة ذات قوة تعلو سلطة الدول القومية على غرار الأمم المتحدة، القانون الدولي.. إلخ).
هذا من جهة. ومن جهة ثانية، يعود السبب في سباق الدول المحموم نحو التسلح ومراكمة عناصر القوة المادية إلى عدم قدرة الدولة على التنبؤ والتأكّد من نوايا الدول المجاورة لها، والتي تمتع بقدرة عسكرية هجومية محدودة أو كبيرة. وبالتالي، فإنّ الوضعية المثالية لأي دولة تطمح للبقاء والفعالية ضمن هذا النظام الدولي الفوضوي هي أن تكون قوية قدر ما تستطيع، ما يعرف بـ"سياسة الاعتماد على الذات".
انطلاقًا من هذه الافتراضات، يحتلّ مفهوم "القوة" الصدارة في تحليل النظرية الواقعية للنظام الدولي باعتباره نظامًا فوضويًا يتحكّم فيه الأقوى عسكريًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا من ناحية، وبوصفه نظامًا يهيمن عليه التنافس من ناحية أخرى.
لكن ما مدى نجاعة هذا المفهوم في تفسير واقع العلاقات الدولية في عالم ما بعد القطبية الثنائية والحرب الباردة؟ وهل يمكن القول إن المفهوم فقد قوته التفسيرية بشأن سلوك الدول وطريقة سيْر السياسة الدولية في ظل معطيات العولمة المتمثلة في: الشركات العابرة للجنسيات، والحركات والأفكار والمؤسسات العابرة للحدود والدول، والقائمة في مجملها على منطق التعاون والتكامل بدل منطق الصراع الذي سخّرت النظرية الواقعية كل مجهودها لتحليله؟
لماذا كلّ هذا الشّره للقوة؟
وبعبارة أخرى، ما هي الدّوافع الجذرية أو الأصلية التي تجعل الدول تتصرّف على هذا النحو العدواني التنافسي؟ حول هذا السؤال بالضبط، تنقسم النظرية الواقعية إلى اتجاهين رئيسيين؛ الأول هو اتجاه "منظري واقعية الطبيعة البشرية أو الواقعية الكلاسيكية"، والثاني هو اتجاه "الواقعية البنيوية أو الواقعية الجديدة".
يعدّ هانس مورغنتاو الممثل الأبرز للاتجاه الأول، حيث يؤكد على أنّ الطبيعة البشرية هي طبيعة شريرة، متفقًا في ذلك مع توماس هوبز. وبناءً على ذلك، يرى مورغنتاو أن البشر مجبولون على حبّ السيطرة حتى الموت، وحين يصلون إلى القوة، فهم يتمسكون بها للنهاية. وبالتالي، فإن هذه الطبيعة البشرية هي السبب في كل النزاعات على صعيد النظام الدولي.
تختلف هذه الرؤية اختلافًا بيّنًا عن رؤية الواقعيين البنيويين مثل جون ميرشايمر وكينيث والتر الذين يركزون في تفسير سلوك الدول العدواني والتنافسي على بنية النظام الدولي، على اعتبار أن هذه البنية هي العامل المؤثر وليس طبيعة البشر الشريرة. فما يدفع الدول إلى الدخول في سباق تسلّح هو عدم وجود سلطة عليا أعلى من الدول، وعدم امتلاك الدول ضمانًا بعدم اعتداء دول أخرى، أقوى منها عسكريًا، عليها. وبالتالي، فإن هذا الخوف هو ما يدفع كل دولة على حدة إلى الدخول في سباق على مراكمة القوة وتحقيق المصالح على حساب بعضها بعضًا.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين الاتجاهين حول الدوافع الأصلية لحب القوة والسيطرة، فالتحليل في كليهما يقود إلى النتيجة نفسها، وهي أن الدول تتصرف على نحو عدواني وتنافسي.
انطلاقًا من هذه الافتراضات، يدّعي الواقعيون القدرة على التنبؤ بسلوك الدول ولا سيما الكبيرة منها. ففي حالة مثل حالة الصين، يعتقد ميرشايمر أنّها إذا استمرت في النمو اقتصاديًا فإنها سوف تُحوّل قوتها الاقتصادية تلك إلى قوة عسكرية، ثم ستسعى للهيمنة على آسيا مثلما هيمنت الولايات المتحدة على غرب العالم. فالصينيون فهموا الآن، وسيتأكدون مستقبلًا، أنّ السبيل الوحيد للبقاء هو التمتع بالقوة الاقتصادية والعسكرية معًا. وبالإضافة إلى ما سبق، يجادل الواقعيون بأنّ الصينيين تعلّموا درسًا نموذجيًا مما فعلته بهم القوى الكبرى (اليابان وأوروبا) في الفترة ما بين 1850 – 1950 حينما كانوا ضعفاء. ويتمثّل هذا الدرس، ببساطة، في أن يسعوا مستقبلًا إلى أن يكونوا أكثر قوة مما كانوا عليه في أي وقت.
لكن سعي الصين إلى الهيمنة على آسيا يقابله موقف أميركي رافض للهيمنة الصينية على آسيا، ولظهور أي منافس محتمل على الصعيد الدولي. فمن منطلق واقعي بحت، ستفعل الولايات المتحدة المستحيل لمنع الصين من التّسيّد والسيطرة على منطقة آسيا. كما أنّ جيران الصين، لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفيتنام والهند والفلبين، وحتى روسيا، لن يسمحوا للصين بالهيمنة على آسيا.
وبالتالي، ستعمل هذه القوى على خط الولايات المتحدة لاحتواء الصين، وسيكون هذا الاحتواء شبيهًا بسياسة احتواء الاتحاد السوفييتي من طرف أوروبا الغربية وحلفائها الآسيويين أثناء الحرب الباردة، وهو سيناريو من المحتمل أن يتكرر، حسب ميرشايمر، مع الصين حاليًا.
السؤال المطروح ههنا هو: لماذا الولايات المتحدة معنية باحتواء الصين في منطقة بعيدة عن منطقة نفوذها التقليدي؟ الإجابة، ببساطة، أنّ الوسيلة الوحيدة التي تجعل حظوظ القوى العظمى في البقاء كبيرة هي الهيمنة الإقليمية على نطاقها من جهة، ومنع محاولة أي دولة أخرى من الهيمنة على محيطها الإقليمي من جهة أخرى. فمتى ما هيمنت الصين على آسيا مثلًا، ستكون الخطوة الموالية هي التدخل في منطقة نفوذ الولايات المتحدة في الجزء الغربي من العالم، تمامًا كما تفعل أميركا الآن في آسيا لاحتواء الصين ومنع بسط سيطرتها على تلك المنطقة، وكما تفعل مع روسيا في أوروبا الشرقية، وكما فعلت سابقًا تجاه ألمانيا النازية في أوروبا، والإمبراطورية اليابانية في آسيا.
لكن هذه السياسة التدخّلية الأميركية أخذت، منذ 1989، طابعًا خطيرًا نتيجة توهم واشنطن أنه بمقدورها أن تصل إلى الهيمنة العالمية، فكانت النتيجة أن أقحمت نفسها في دوامة من المشاكل بغزو أفغانستان والعراق. والسبب في نظر الواقعيين بسيط، وهو استحالة تحقيق الهيمنة العالمية في عالم شاسع كعالمنا، فحسبُ القوى العظمى أن تبسط هيمنتها على إقليمها وتمنع القوى الأخرى من تحقيق ذلك في مجالها الحيوي.
بات واضحًا، انطلاقًا من التحليل الواقعي، أن السباق الأمني المحتدم يضمّ في أحد طرفيه الصين الساعية إلى الهيمنة على آسيا. وفي الطرف الآخر، نجد الولايات المتحدة وجيران الصين الذين يريدون منع بكين من تحقيق هيمنتها على المنطقة.
كما بات واضحًا أيضًا، من خلال هذا التمشّي، أن الإجابة على السؤال الكبير المتمثل في: هل يمكن للصين أن تنهض سلميًّا؟ هي بالضرورة لا. وهذه الإجابة، كما يقول ميرشايمر، مدعّمة نظريًا على النحو المبيّن أعلاه في افتراضات ومبادئ النظرية الواقعية في شكليها الكلاسيكي والبنيوي، ذلك أنه يستحيل أن: "تتوقع المستقبل دون إطار نظري".
انتقادات تمهّد لتجاوز الواقعية وفكرة الصراع العبثي على القوة؟
السياسة الدولية، بالنسبة إلى الواقعيين، هي عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول تبحث عن مصالحها بشكل منفرد. وتتجلّى الأهمية المعطاة لفكرة القوة في التحليل الواقعي من خلال جعل القوة محور عملية السلام والحرب معًا، حيث إنه من شأن توازن القوى أن يمنع من الصدام.
لكن، على العكس، من شأن اختلال موازين القوى أن يدفع الدول الأقوى لغزو الدول الأضعف منها. وما دامت القوة تحظى بكلّ هذه الأهمية المحورية، فمن البديهي أن تكون الدول التي تتمتع بأكبر قدر من القوة – عسكريًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا وحتى ديمغرافيًا – هي نفسها الدول المهيمنة والمسيطرة في النظام العالمي.
لكن منتقدي النظرية الواقعية يجادلون بأنّ إعطاء كل هذه الأهمية لمفهومي القوة والمصالح – لفهم طبيعة النظام الدولي وكيفية سيْر العالم – ساهم في تكريس شكل من أشكال فكرة الصراع العبثي اللانهائي بين دول كل غايتها مراكمة أكبر قدر من القوة بشكل لا محدود، وهي فكرة نمطيّة تقدّم لنا الدول كوحدات تدور في حلقة مفرغة من الصراع على القوة والمصالح.
كما أن تركيز التحليل الواقعي على الدولة، كوحدة تحليل لفهم النظام الدولي، جعل هذا التحليل يُهمل جوانب أخرى مهمة من الوجود الاجتماعي أدى إهمالها إلى اتهام النظرية الواقعية بالعجز عن توقع نهاية الحرب الباردة. فإهمال النظرية الواقعية لقدرة الخطاب والأفكار والحركات الاجتماعية على التأثير في توجهات الدول والزعماء، جعل من قدرتها التفسيرية محدودة، خاصةً في رصد التغيرات والظواهر الجديدة في النظام الدولي.
ومن هنا، تمكنت النظريات المستندة لأنطولوجيا اجتماعية كالنظرية البنائية والنظريات البنيوية أن تقفز للصدارة، حيث ركزت هذه النظريات على الخطاب وقدرته على صياغة الكيفية التي يحدد بها الفاعلون هويتهم ومصالحهم، ويقومون تبعًا لذلك بتعديل سلوكهم الذي غير المحكوم بالضرورة نحو التوجه لخيار الصراع كما تفترض النظرية الواقعية.
وفي هذا الإطار، كانت للدعوات التي أطلقتها منظمات دولية وحركات اجتماعية، نهاية الثمانينات، دور كبير في قلب خيارات الدول العظمى من خيارات الصراع والحرب إلى خيارات التعايش والتعاون والسلام. وهذا ما لم تكن النظرية الواقعية تضعه في اعتباراتها.
لقد تمكنت البنائية من قلب مفاهيم الواقعية فاستطاعت أن تعطي لمفهوم المصلحة نطاقًا أوسع في التفسير عندما ربطته بالعمليات الاجتماعية التاريخية، مركزةً على الخطاب السائد في المجتمع باعتباره هو ما يشكل المعتقدات والمصالح، ويؤسس في الوقت ذاته للسلوكيات التي تحظى بالقبول.
الأمر نفسه بالنسبة لمفهوم القوة، فبدلًا من التعامل مع القوة بشكلها المادي التقليدي، كما تفعل الواقعية، تم التركيز مع – الليبرالية والبنائية – على قوة الأفكار، حيث كان من شأن اعتناق غورباتشوف لفكرة "الأمن المشترك" تغيير توجهات روسيا ليتخلص العالم، ولو مؤقتًا، من تجاذبات الثنائية القطبية، ويُفتح الباب على مصراعيه لفرص السلام والتعاون، وبالتالي إنهاء الحرب الباردة.
إن كل هذه الانتقادات الموجهة للنظرية الواقعية تعطينا انطباعًا بأن هذه النظرية ركزت على ما هو ظاهري وخارجي في الدول وفي العلاقات الدولية، وأهملت العناصر الداخلية وقدرتها على التأثير، حيث أهملت جوانب مهمة من الوجود الاجتماعي متعلقة بالمجتمع والخطاب والمعتقدات والأفكار والحركات، وركزت على الدولة فقط كوحدة تحليل نموذجية لطبيعة العلاقات الدولية، وهو ما أدى لإخفاقها في تفسير العديد من الحالات والظواهر الدولية الجديدة، خاصةً في ظل تصدّر فاعلين جدد للمشهد الدولي كمنافسين للدولة القومية ومصالحها التقليدية التي اختصرتها الواقعية في البحث عن القوة والهيمنة.
ومهما يكن، لا يمكن إلا أن نعترف للتحليل الواقعي بعناصر قوة عديدة، أبرزها قدرته على تقديم تفسيرات بسيطة – تنتمي للسهل الممتنع – لأحداث كبيرة جدًا من قبيل: لماذا وقعت الحربان العالميتان الأولى والثانية؟ ولماذا تقع الحروب بصفة عامة؟ ولماذا يسود السلم في فترات أخرى؟