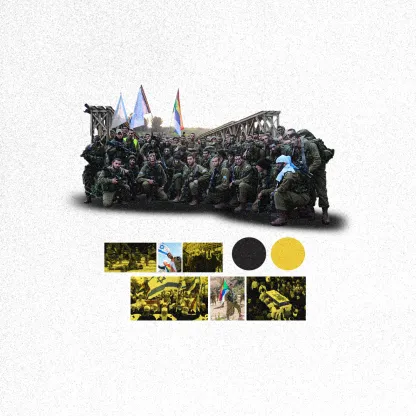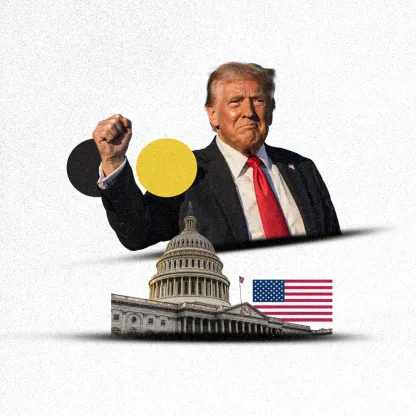في الرابع عشر من شباط/فبراير الفائت، نجح مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" بالحصول على أصوات الغالبية العظمى في مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مجتازًا أولى خطوات قونَنَتِه قبل تمريره على مجلس الشيوخ وتوقيعه من قِبل الرئيس الأميركي جو بايدن ليصبح مُلزمًا، وهو الأمر المتوقع حدوثه قبل تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وركّز القانون، في إحدى أهم جزئياته، على تمديد العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون "قيصر" حتى عام 2032، مع التشديد على من "يحاول سرقة أموال الشعب السوري" عبر إعادة الإعمار، أو محاولة عقد صفقات تحقق امتيازات للنظام السوري، بعدما كان مقررًا أن تنتهي مع نهاية العام الحالي. كما يتضمن توسيع العقوبات لتشمل الكيانات التي تحول المساعدات الإنسانية، أو تصادر الممتلكات من السوريين لتحقيق الرفاهية أو المكاسب الشخصية، إلى جانب مجلس الشعب السوري وكبار مسؤولي حزب "البعث العربي الاشتراكي"، وقطاعات الطاقة والتنمية.
وتعليقًا على هذا الجانب، يقول الباحث الاقتصادي في "معهد نيولاينز" الأميركي، كرم شعار، لـ"ميغازين"، إن تشديد الحجب على إعادة الإعمار في سوريا يحقق في الواقع حمايةً لبعض المظالم، على اعتبار أن مشاريع مثل "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" في العاصمة دمشق، هي في الأساس استثمارات على أراضٍ منهوبة ضمنيًا. ويضيف: "ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار وقف إعادة الإعمار أمرًا جيدًا فقط في حال وجود إجراءات وقرارات أخرى تدفع باتجاه الحل السياسي".
من جانبه، يستمرّ الأسد بالتبجّح بضآلة تأثير العقوبات عليه، في الوقت الذي يحمّلها إعلامه والناطقين باسمه مسؤولية الانهيار الحاصل في البلاد، إذ قال في مقابلة العام الفائت إن: "قانون قيصر هو عقبة لا شك، ولكن تمكنا بعدة طرق من تجاوز هذا القانون، هو ليس العقبة الأكبر". وعاد ليسخر من العقوبات في مقابلته مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، بقوله: "ربما يكون لقائي المقبل مع الرئيس بوتين لكي نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في المصارف الأميركية، هي مشكلة كبيرة، الغرب مضحك وغبي أحيانًا".
الآن، بعد مرور ثلاثة عشر عامًا على اندلاع الثورة السورية عام 2011، وانزلاقها سريعًا إلى حربٍ أهلية، وعلى الرغم من النهج الغربي الموسع للعقوبات الذي يستهدف قطاعات اقتصادية بأكملها؛ فإن هذه العقوبات لم يكن لها تأثير يذكر في دفع النظام إلى تقديم تنازلات سياسية، أو الانخراط جديًا في تسوية سلمية للصراع، أو تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، ساءت الظروف في سوريا بشكل مطرد، حيث أدت العقوبات، إلى جانب الآثار المدمرة للحرب، والانهيار البنكي في لبنان، وجائحة كورونا، إلى تغذية الانهيار الاقتصادي الذي رمى أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

وقد دفع هذا المأزق العديد من النقاد إلى المطالبة بسيناريوهات تساعد فيها الولايات المتحدة في حل الصراع السوري من خلال تقديم تنازلات للنظام - أو داعميه الأساسيين، روسيا وإيران - مقابل إصلاحات سياسية بسيطة.
كما استغل النظام ووسائل إعلامه كارثة الزلزال الذي ضرب شمال شرق البلاد في السادس من شباط/فبراير 2023 لتكريس حملة تلقي بالفشل بأكمله على العقوبات وتطالب برفعها لحاجات إنسانية، وهو ما حصل جزئيًا في نهاية المطاف لمدة ستة أشهر، لم يلحظ فيها الشعب السوري أي تحسّن في ظروفهم الاقتصادية، بل العكس.
تاريخ سوريا مع العقوبات
منذ إدراج سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" في عام 1979، اتبعت الولايات المتحدة العقوبات كأداة أساسية في سياستها تجاه البلاد. كما أصدرت إدارة جورج دبليو بوش سلسلة من العقوبات بموجب أوامر تنفيذية تهدف إلى الحد من نفوذ سوريا "المزعزع للاستقرار في العراق". ومع ذلك، بعد عام 2011، فرضت إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب عقوبات على نظام الأسد على نطاق غير مسبوق بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبلغت هذه العقوبات ذروتها بإقرار "قانون قيصر" في عام 2019، والذي يسمح بعقوبات أولية وثانوية تستهدف كل من مرتكبي الجرائم الخاضعة للعقوبات، وأولئك الذين يمكّنونهم من ارتكابها من شركاء ومتعاونين.
وقد سعت الولايات المتحدة لتطوير الأدوات اللازمة لجعل عقوباتها "أكثر ذكاءً"، مثل فرض "عقوبات ثانوية" بموجب قانون قيصر. لكن تأثير قانون قيصر لم يطل سوى حفنة من رجال الأعمال السوريين، الذين سرعان ما وجدوا طريقهم للالتفاف عليه من خلال خلال الشركات الصورية، وتغيير أسماء سفن الشحن وغيرها من الأساليب التقليدية، أو طرق أخرى تفرّد بها النظام، مثل تكثيف الدعم الروسي والإيراني - وإن كلّفه ذلك سيادته - وتبديل ديناميكيات السلطة الاقتصادية وتغيير وجوهها كل بضعة سنوات، وإنشاء وإدارة شبكات التهريب العابرة للحدود. لكن كل ذلك يأتي بثمنٍ إضافي على السلع يُعوّض من جيوب السوريين، الذين لم يعودوا قادرين ببساطة على تحمّل مفهوم "التجربة والخطأ" في العقوبات.
ومن الناحية المثالية، تخدم العقوبات وظيفتين: الأولى، هو تغيير سلوك المستهدف وداعميه، مثل عناصر النظام السوري المشاركين في قمع الاحتجاجات السلمية أو الشركات التي قد تتعامل مع أهداف خاضعة للعقوبات من خلال إدراجها على القوائم السوداء وتقويض أعمالها، كما حصل مع شركتي "بلو مارين" للشحن و"سكيرون القابضة" ومقرهما سويسرا، حيث أوقفت الشركتان شحن النفط إلى النظام السوري استجابة لتلك العقوبات. أما الثانية: فهي ردع انتهاكات الحقوق في المستقبل، سواء من قبل النظام نفسه أو من قبل الأنظمة الأخرى التي تعتقد أنها يمكن أن ترتكب انتهاكات دون عقاب.
ومع ذلك، وعلى الرغم من فشل العقوبات في تحقيق هاتين الوظيفتين الأساسيتين، إلا أن الحكومات الغربية أبقت عليها إلى حد كبير. وانطلاقًا من ذلك، يشير باحثون في مركز "المجلس الأطلسي للأبحاث" إلى أن العقوبات قد تخدم وظيفة أخرى، وهي: إقناع العالم والناخبين بأن الحكومات الغربية تهتم بسوريا وتتصرف بناءً على التزامها بمحاسبة النظام السوري.
آثار سلبية "غير محسوبة" للعقوبات
من المهم التمييز بين الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات، وتلك التي ترتبط بها ببساطة. على سبيل المثال، ساهمت أنظمة العقوبات المتعددة بلا شك في تأزيم الضائقة الاقتصادية التي تعيشها سوريا. ومع ذلك، وعلى الرغم من خطاب النظام، فإن العقوبات ليست السبب الوحيد لهذه المحنة؛ إذ دخل قانون قيصر حيز التنفيذ بعد سنوات من الفساد المؤسسي، واقتصاد الحرب، ونهب المساعدات، وسوء الإدارة، وتفشي جائحة كورونا، والأزمة المصرفية في لبنان.
ويجادل اقتصاديون داخليون وخارجيون، بأنه حتى لو أراد النظام استيراد بعض السلع التي يستهدفها قانون قيصر، فليس من الواضح ما إذا كان لديه الأموال اللازمة للقيام بذلك. فما مدى سهولة حصول النظام على قرض من البنوك الأجنبية، حتى لو لم تكن هناك عقوبات، عند أخذ مكانته الائتمانية المنخفضة بعين الاعتبار؟
في دراسة تحليلية شاملة صدرت عن "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، بعنوان "مراجعة شاملة لفعالية العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي على سوريا"، اعتمدت على كم هائل من البيانات؛ خلص الباحثان كرم شعار ووائل علواني إلى قائمة من الآثار السلبية المنحصرة في خمس نقاط.
على الصعيد الإنساني، كان للعقوبات تأثير سلبي على المنظمات السورية غير الحكومية العاملة داخل الحدود السورية وخارجها، إذ أُغلقت الحسابات المصرفية للعديد منها، ومُنعت من فتح حسابات جديدة، ولم يُسمح لهم بإرسال أو تلقي تحويلات مصرفية. واضطرت بعض المنظمات خارج سوريا إلى التعامل فقط مع البنوك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
ولم تتضمن هذه التدابير أي مبرر معلن سوى الحذر وفرط الامتثال للعقوبات؛ وفي حالات قليلة، تراوحت المبررات المعلنة بين كون السوري عضوًا في مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية، إلى عذر غامض مفاده أن الوضع في سوريا غير مستقر، بحسب تقرير نشرته مؤسسة "إمباكت" لأبحاث وتطوير المجتمع المدني.
كما تسببت العقوبات في مشاكل كبيرة للمدنيين السوريين الذين يعيشون في الخارج، إذ تأثروا هم كذلك بإجراءات فرط الامتثال للعقوبات في العديد من البلدان حول العالم، مثل إغلاق حساباتهم، ومنعهم من فتح حسابات جديدة، وعرقلة الحوالات المالية فيما بينهم، دون تفسير في كثير من الأحيان.
إضافةً إلى ذلك، هناك إجماع أكاديمي، شبه كامل، على أن العقوبات الاقتصادية، بغض النظر عن نوعها، لها تأثير سلبي على الاقتصادات الوطنية. ولا يقتصر الأمر على الحالة السورية، لكن تتجلى هذه الحالة بوضوح أكبر في البلدان حيث تختلط الدكتاتورية بالاحتكار، ورأسمالية المحسوبية، والتوزيع غير العادل للثروة، حيث يكون الأفراد والكيانات الذين يتمتعون بقدر أكبر من الوصول إلى الموارد والسلطة أكثر قدرة على تحمل العقوبات، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تكون أكثر عرضة للفشل عندما يصبح الوصول إلى الموارد حصريًا.
وأخيرًا، أعاقت العقوبات خدمات إعادة التأهيل في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام، إلى جانب أنها جعلت من المستحيل تقريبًا على المنظمات غير الحكومية الدولية المساهمة في "إعادة تأهيل البنية التحتية على نطاق صغير"، وتطبيق حظر واسع النطاق على التقنيات الغربية، سواء تلك التي تقع في قلب العمل والإنماء، مثل Google WorkSpace وOracle Java. أو الترفيهية منها، مثل منصات البث التلفزيوني. علمًا أن كابلات الإنترنت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام متصلة بشبكات إما في تركيا أو العراق، وليس سوريا.
آثار إيجابية
رصدت دراسة "معهد الشرق الأوسط" تأثيرات إيجابية للعقوبات في عدة جوانب رئيسية؛ أولها إجبار الكيانات على تغيير سلوكها و/أو قبول التنازلات كما في مثال الشركتين السويسريتين أعلاه، إذ إنّ إجبار الكيانات الخاضعة للعقوبات على إجراء تغييرات سلوكية في هذه الحالة أفضل من خيار عدم فرض عقوبات على الإطلاق. لكن يشير الباحثون إلى أن التغيير المنشود يعتمد جزئيًا على مكان تواجد الكيانات الخاضعة للعقوبات والمكان الذي تقوم فيه بمعظم أعمالها. على سبيل المثال، من المرجح أن الكيانات في سويسرا لم تكن ترغب في تعريض علاقاتها في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للخطر، لذلك امتثلت. بينما قد لا تخيف العقوبات الجهات الفاعلة ذات المشاركة المحدودة في تلك الأسواق.

كما أن العقوبات هي أداة ردع، حيث ترسل إشارات صريحة إلى الأفراد والكيانات المشاركة في الأهداف الخاضعة للعقوبات بأنهم يخضعون للمراقبة. ويمكن أن يكون اسمهم التالي على القائمة إذا قاموا بتطبيع علاقاتهم مع أهداف العقوبات، أو لم يتبرأوا من أي أنشطة سرية أو علنية. ويشير الباحثون إلى أن هذه الفائدة لا تحصل على ما يكفي من التقدير في كثير من الأحيان: "لأننا لا نستطيع رؤية تأثيرها على أرض الواقع، أي أننا لا نعرف متى تقرر الشركة عدم اتخاذ إجراء في سوريا؛ نحن نعرف فقط عندما يتخذون إجراءً".
عقوبات أكثر ذكاءً؟
في ورقة بحثية بعنوان "معاقبة النظام وحماية السوريين: معضلة العقوبات على سوريا"، الصادرة عن "مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي" البحثية، من إعداد الباحث الاقتصادي في مركز تشاتام هاوس زكي محشي، يقول إن: "لدى المجتمع الدولي مجموعة من الخيارات السياسية تتجاوز الانقسام التبسيطي المتمثل في الإبقاء على العقوبات الحالية أو رفعها بالكامل".
أحد أبرز تلك الخيارات التي تطرحها الورقة هي توفير الدعم المالي المباشر لرجال الأعمال التقليديين والشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا من خلال فتح قنوات مالية موازية معهم كبديل للقنوات الرسمية، التي تسيطر عليها كيانات وأفراد موالون للنظام وتخضع للعقوبات، فيما يشبه آلية الدفع السويسرية لإيران التي تم إطلاقها في كانون الثاني/يناير 2020، والتي تسمح بتداول السلع الإنسانية مع إيران دون الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.
وبالنسبة إلى سوريا، قد تشمل الآلية، إلى جانب المساعدات الإنسانية، السلع والخدمات الأخرى اللازمة للأسواق المحلية مثل المواد الخام والمعدات للقطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعات النسيج والأدوية والصناعات الغذائية الزراعية، وذلك من خلال مكتب فني مستقل يتمتع بصلاحية اتخاذ القرار والموافقة على المعاملات التي يمكن إجراؤها مع سوريا دون التأثر بالعقوبات.
وفي مقالة رأي عنوانها "العقوبات الأمريكية على سوريا لا تجدي نفعًا. لقد حان الوقت لنهج عقوبات جديد يقلل من المعاناة الإنسانية ويزيد من النفوذ"، يقدم الدكتور كرم شعار والباحث سعيد الدمشقي (اسم وهمي) مجموعةً من التوصيات لـ "إذكاء العقوبات"، منها الاستفادة من العقوبات الثانوية التي تكون بمثابة رادع ضروري وفعال، والعمل مع السوريين لمراجعة وتصحيح قوائم العقوبات لتشمل الشركات الوهمية التي تم كشف ارتباطها بنظام الأسد، والتنسيق مع الشركاء في أوروبا للتحقق من المعلومات وتبادل المعلومات الاستخباراتية. إذ يجب أن تحل هذه الأدوات محل فرض عقوبات على قطاعات بأكملها، مثل القطاع المالي، الذي يضر بالمدنيين والاستجابة الإنسانية في حين لا يفرض أي تكلفة تقريبًا على النظام الذي أصبح ماهرًا في التهرب من هذه العقوبات.
ويختتم شعار حديثه لـ"ميغازين" بالتوصية بوجوب التفكير دومًا بحجم الضرر والنفع على المدَيين القريب والبعيد لتلك العقوبات على سوريا وحياة السوريين. ومن وجهة نظره، فإن ضرر تجميد أنشطة إعادة الإعمار إلى حين ولادة حلّ سياسي دون وجود أي خطواتٍ فعلية تشي بتقدم نحوه، أكبر من نفعها بكثير: "أما إن رافقت تلك العقوبات استخدام أدوات سياسية أخرى تدفع نحو الحل السياسي، حينها يمكنك القول إن ذلك يصبّ في صالح السوريين".
القاسم المشترك بين كل هذه التوصيات، بحسب الكاتبين، هو: "أخذ سوريا على محمل الجد وتخصيص المزيد من الموارد للحد من العواقب السلبية غير المقصودة للعقوبات". ونظرًا للقصص المؤلمة التي لا تعد ولا تحصى عن السوريين غير القادرين على الوصول إلى الضروريات، جزئيًا بسبب العقوبات الاقتصادية، يجب على الولايات المتحدة أن تقلل من معاناتهم، بينما تركز جهودها على استهداف النظام القمعي الذي يُمدّد بؤسهم.