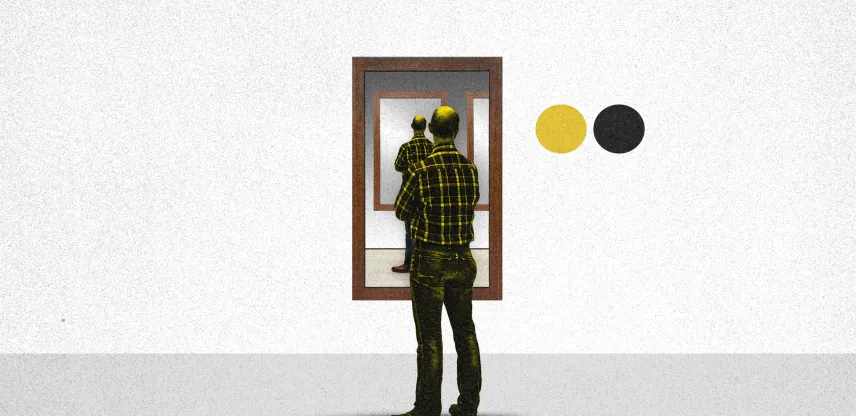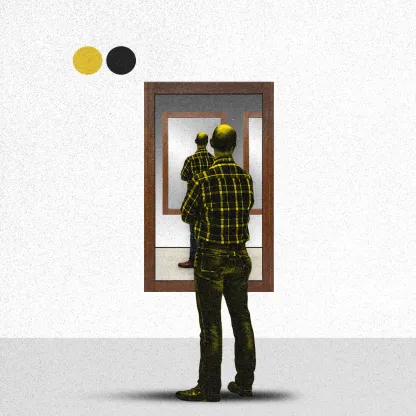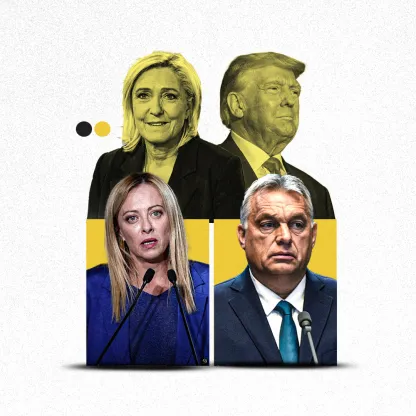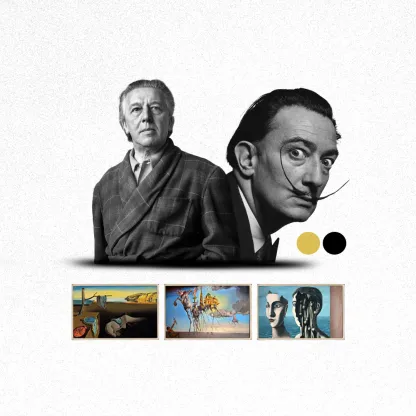منذ عقود، وخلال فترة الاستقلالات تحديدًا، دار نقاش كبير حول تجنيس العلوم الإنسانية وتكييفها في البيئة الاجتماعية العربية، وعلى وجه الخصوص تلك العلوم التي كان لها دور بارز في تبرير الاستعمار في مرحلة تاريخية معينة، مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع.
وعلى الرغم من تحرر هذه العلوم من الطابع التبريري للاستعمار والنظرة الدونية لمجتمعات بعينها، إلا أن النقاش حول هويتها يعود الآن من جديد، وإن بمنظورات مختلفة.
وفي هذا الإطار، يأتي المشروع المشترك بين كلّ من ساري حنفي ونورية بن غبريط ومجاهدي مصطفى حول ما يسمونه "مشروع علم الاجتماع العربي"، الذي ينبغي أن ينهض بأدوار معينة، وأن يُسهم بشكل فاعل في السياسات، ويلامس هموم الناس ويحتك بالجماهير بعد أن ظل حبيسًا للجدران الأكاديمية والمكتبية.
لكن قد يتساءل البعض عما يعنيه الحديث عن علم اجتماع عربي؟ وألا تتنافى الهوية الكونية للعلوم مع إرادة إلصاقها بهوية محددة؟ وبما أن المشروع يتحدث عن أنماط معينة من تناول العلوم الاجتماعية مع قضايا المنطقة، وعن أنماط سائدة من الإنتاج المعرفي في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الوطن العربي، فما هي الاختلالات التي تستدعي العودة إلى التفكير في علم اجتماع عربي من جديد؟
إن فكرة الحديث عن سوسيولوجيا عربية تعيدنا إلى براديغم هوية العلوم، الذي استنفد نقاشه جهد الجيل الأول من الباحثين في العالم العربي من أمثال أنور عبد الملك والطيب تيزيني وعبد الكريم الخطابي. ويمكن القول إن هذه المرجعيات شكلت النواة الأولى لممارسة عربية لعلم الاجتماع الحديث. وربما كانت دواعي هذا التوجه كامنة أساسًا في السعي إلى مجابهة الطروحات الأيديولوجية والتحيزية في العلوم الإنسانية في تلك المرحلة، باعتبارها إنتاجًا غربيًا يكرس فكرة المركزية الغربية ودونية المجتمعات الأخرى. وربما كان أيضًا للانشغال بهذا الجانب دور في إهمال القضايا الجوهرية للعالم العربي، على الرغم من تصنيف هذه الممارسة حسب المشروع ضمن السوسيولوجيا العربية.
أما النواة الثانية من بحوث المرحلة التأسيسية لعلم الاجتماع العربي، فتمثلت في البحوث التي حملت على عاتقها المساهمة في مشروع تحديث الدولة الوطنية الوليدة، ولذلك شكلت مواضيع التنمية والسياسات العامة محور اهتماماتها إلى حد اعتبار البعض منهم، مثل عالم الاجتماع التونسي عبد الوهاب بوحديبة، أنه لا يُوجد علم اجتماع إلا سوسيولوجيا التنمية. ومثّل هذا التوجه، وخاصةً المبالغة فيه، أحد اختلالات التأسيس لأنه أهمل مساءلة الظواهر الاجتماعية والاقتراب منها لصالح حل المشكلات وخدمة مشاريع الدولة.
وحتى وقت قريب، اعتقد معظمنا أن براديغم هوية العلوم أصبح متجاوزًا بعد أن أخذت العلوم الاجتماعية مشروعيتها كعلوم تخلصت من شوائب النزعة الأيديولوجية. لكننا نجد في مشروع "من أجل علم اجتماع عربي" إعادة طرح للموضوع لكن بطريقة مختلفة تحاول أن تشخص واقع علم الاجتماع في الوطن العربي ممارسةً وبحثًا وقضايا، ومدى نجاح هذه الممارسة في نيل الاعتراف والقدرة على الاشتباك مع الرأي العام، وفتح أبواب السوسيولوجيا للجماهير وقضاياها.
وتمثّل مقاربة هذه الإشكالات الفكرة الرئيسية لهذا المشروع، وهي فكرة يمكن التعبير عنها كالتالي: "الطوق السوسيولوجي أمام ممارسة علم اجتماع عربي، والإمكان الإبداعي لما قد يصبح سوسيولوجيا عربية". ولشرح هذه الفكرة الرئيسية، يمكن القول إن ما يناقشه المشروع يشمل ثلاثة مستويات؛ يتمثل الأول منها في المواضيع التي أسّست لمشروعية ممارسة علم اجتماع عربي، وانحصرت الممارسة في هذا المستوى في شكلين أحدهما جبهوي (غربلة العلوم الاجتماعية من طابعها الأيديولوجي بغربلة مفاهيمها نقديًا).
أما الآخر، فكان "دعمويًا وتعبويًا" (أي جرى فيه تسخير السوسيولوجيا لتكون إحدى آليات التحديث في مشروع الدولة الوطنية الوليدة). وهذان الشكلان من السوسيولوجيا العربية في لحظة التأسيس، على الرغم من أهميتهما، إلا أن تسيّدهما، في الممارسة السوسيولوجية العربية جعلهما طوقًا وعاملًا في ضمور الإمكان الإبداعي في هذه الممارسة.
أما المستوى الثاني في فكرة المشروع الرئيسة، فقد تمثلت في إشكالات مأسسة العلوم الاجتماعية بوصفها تخصصات أكاديمية من جهة، ومَهْنَنَة الباحثين فيها مما أسهم في عزلتها عن الجمهور أكثر من جهة ثانية.
وتمثَّل المستوى الثالث من الفكرة الأساسية للمشروع في مستوى الإنتاج المعرفي العربي في مجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا كمًا ونوعًا، وهذا المستوى الأخير هو ما تم التركيز عليه أكثر.
لكن لئن تطرق كتّاب المشروع إلى المسائل المهمة المتعلقة بالإنتاج المعرفي العربي ومشاكله المتعلقة بالبيئة الحاضنة وتدني مكانته عالميًا ومحليًا وغلبة الوصف فيه على النقد والعمق، إلا أن المشروع - وبإسقاطه لنموذج معين يحدد ما ينبغي أن تسلكه السوسيولوجيا العربية - شارك في عملية التعسف نفسها التي شخّصها باعتبارها إحدى العوائق النوعية أمام ما يسميه سوسيولوجيا عربية.
وتعبير السوسيولوجيا العربية نفسه يثير إشكالًا كبيرًا يتمثل في: ما الذي يمكن اعتباره سوسيولوجيا عربية؟ هل هو أي إنتاج ينتجه باحث عربي؟ أم هل هو كل بحث يتخذ من قضايا الوطن العربي موضوعًا له؟ وما معنى الحديث عن سوسيولوجية عربية ضمن منطق عابرية العلم للهويات؟
إن إسقاط تصنيف بوراوي على ممارسة علم الاجتماع في الوطن العربي لتشخيص إشكالية الإنتاج المعرفي لا تعطي إضافة كبيرة في معاينة مواطن الخلل في السوسيولوجيا العربية. فالحديث عن مستوى مهني نقدي وآخر عمومي سياسي ومحاولة جعل هذا التصنيف مدخلًا لمشاكل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، يمثل إهمالًا لقضايا أساسية في إشكال السوسيولوجيا العربية تتمثل أساسًا في عدم قدرتها على الانفكاك من قيد التقليد وإعادة الاجترار والإسقاط، وهو ما يجعل الإمكان الإبداعي فيها ضامرًا وقدرتها على الاشتباك مع الظواهر واشتقاق آليات الفهم منها، ومن ثم مساءلتها، مسألةً صعبة.
فالمتأمل في الإنتاج السوسيولوجي العربي يرى أنه يغطي جوانب عدة من قضايا الحياة الاجتماعية، ومن ثم فإن عيوب الممارسة أعمق من أن تكون متمثلة في كم الإنتاج أو مدى توزعه بالتساوي على جوانب الحياة الاجتماعية، لأن ما يمثل مشكلة ليس الممارسة وإنما إبداعية الممارسة وعمقها، خاصةً في الجوانب المنهجية والنظرية وتقنيات إخراج النص وكتابته. فداخل الحقل الأكاديمي تكاد تغلب لغة واحدة وتمشٍّ واحد يعاد تكراره في دراسة الظواهر الاجتماعية دون مراعاة لطابع التغير فيها، ومن ثم ضرورة تجديد المنهجيات وتعميق أساليب التناول.
وقد أدّى ذلك إلى ما يسميه الأنثروبولوجي الفلسطيني إسماعيل ناشف بـ"صمت الظواهر"، أي إخفاق النظرية والمنهج في الفهم، ما يستدعي فتحهما أمام أصوات الواقع الفعلي، ولن يكون ذلك إلا بتثويرٍ نظري ومنهجي يتمثل عمليًا في قلب شريط المعرفة العلمية التقليدية التي تنطلق من النظرية لتصل إلى الظاهرة (طريقة الإسقاط وإهمال الخصوصية) لا العكس.
ظلت الأعمال النوعية في السوسيولوجيا العربية قليلة، كما ظل تأثير العلوم الاجتماعية بمقتضى ذلك ضئيلًا، كما أن الاستئسار للتفكير النسقي وعدم القدرة على التعامل مع الجزئي ورصده بدقة، وتطوير معرفة عميقة به، تظل إحدى المعوقات الجدية لممارسة سوسيولوجيا عربية جادة.
ومهما يكن، فقد أثار مشروع "من أجل سوسيولوجيا عربية" قضايا حيوية، وسلط الضوء على جوانب مهمة في ممارسة علم الاجتماع في الوطن العربي، محاولًا حصر نماذج تلك الممارسة وعوائقها، إضافةً إلى محاولة تقديم حلول لمشاكلها، وإن ظل كتّاب المشروع حبيسين لنماذج حلول عمومية تصنيفية أكثر مما هي تعميقية تلفت النظر إلى القدرة على صياغة المواضيع والمشكلات النموذجية، والتساؤل المحترف والعميق حولها.