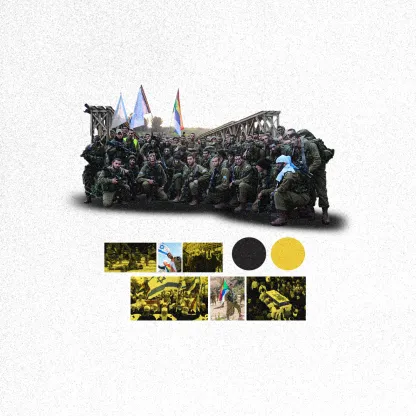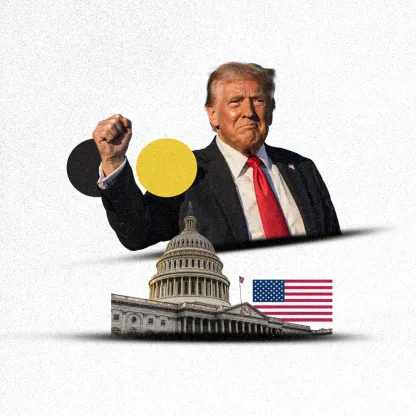في وقت مبكر من عام 2002، أعلن جورج بوش الابن في خطاب أمام الصحافة، الـ22 من كانون الثاني/يناير يومًا وطنيًا للحياة الإنسانية المقدسة National Sanctity of Human Life Day. في هذا الخطاب، أكد الرئيس الجمهوري بأن الأمة الأميركية تأسست على حقوق لا تنازل عنها، وعلى رأسها الحق في الحياة. كانت هذه البلاغة جزءًا من مجادلة محافظة أعلن من خلالها دعمه لحركة محاربة الإجهاض، أو "نصرة الحياة". أصر بوش على أن الحق في الحياة يشمل "المواطنين" الأميركيين الذين لم يولدوا بعد، الأطفال المحتملين الذين قد يتعرضون للإجهاض، والذين وفق الخطاب، يجب حمايتهم بالقانون.
ما ميز هذا الخطاب على نحو خاص، هو تنقله السريع والسلس بين الحرب على الإجهاض والحرب على الإرهاب، باعتبارهما معًا دفاعًا عن الحياة الأميركية. فأحداث 11 أيلول/سبتمبر، حسب الرئيس المحافظ "دفعت الشعب الأميركي إلى حرب غير محددة المدة للحفاظ على الحياة نفسها وحمايتها". كما تقترح ميليندا كوبر في كتابها بالإنجليزية "الحياة كفائض: التكنولوجيا الحيوية والرأسمالية في زمن نيوليبرالي"(2008)، فإن هذا الخطاب ينتهي إلى صورة صادمة، يظهر فيها الأطفال الذين لم يولدوا بعد، وكأنهم ضحايا أبرياء لعمل إرهابي محتمل. ستنتهي هذه "الحرب العادلة" كما هو معروف، إلى مآسٍ هائلة. سيموت مئات آلاف الأطفال العراقيين والأفغان، في حرب تدافع، ربما بشكل رمزي، عن حق أطفال آخرين، لم يولدوا بعد، في الحياة.
بالتأكيد فإن خطاب بوش طرح سؤالًا أوليًا ومباشرًا عن حملات "نصرة الحياة" والسياقات العنصرية والعرقية التي نشأت فيها، وهو حياة من تلك التي تستحق النصرة؟ في هذا الخطاب المليء بالمفارقات، يصبح الأطفال الذين لم يولدوا بعد ذوات دستورية، لها حقوق على الدولة وفي القانون، وتأمين صحي، ترتبط أجسادهم التي لم تتشكل بعد، بقيم الدولة الأميركية. وكما أعلن بوش بخليط من الفخر والحماسة، صار هؤلاء الأطفال الذين لم يولدوا بعد المواطنين الوحيدين في الولايات المتحدة الذين لهم حق الرعاية الصحية المجانية، على الأقل حتى يولدوا.
أما المفارقة الأكبر فأن هذا كله حدث في لحظة تاريخية مركبة؛ اللحظة التي قامت بها السياسات الأميركية بنزع أي صفة قانونية عن ملايين البشر، في حالة استثناء مفتوحة، إذ تم تبرير الجرائم باعتبارها لا تخضع للنظم القانونية الأميركية. فُتحت سجون من الأبشع في العالم خارج الحدود والقيم الأميركية، في غوانتنامو وأبو غريب وغيرهما، وتدرب المحققون الأميركيون والجنود المبتدئون الأوروبيون والأستراليون كما تظهر تقارير، على تقنيات القتل والتعذيب من خلال أجساد المعتقلين العارية من أي صفة قانونية. وفي نفس الوقت الذي أصبحت فيه أجساد الأطفال الأميركيين التي لم تتشكل من لحم ودم بعد، أجسادًا دستورية لها حقوق وقيم، تم نزع القانون والحقوق والقيم عن أجساد أخرى من لحم ودم.
أجنة ألاباما وأطفال غزة
يعود خطاب بوش إلى الذاكرة مع الكثير من الحديث عن الأطفال الذين لم يولدوا بعد، على مقربة من انتخابات أميركية استثنائية، فالاستقطاب بخصوص الإجهاض يصبح أشد مع الوقت، وبينما يتجادل صناع السياسية الأميركيون بشأن الحياة المحتملة، لا تزال الأسلحة الأميركية تقتل الحياة القائمة.

في شباط/فبراير من العام الجاري، أصدرت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأميركية، قرارًا جريئًا، يعتبر الأجنة أو البويضات الملقحة في عيادات التلقيح الصناعي أطفالًا لهم حقوق وحياة يجب معاقبة من يدمرها. جاء القرار كرد على قضيتي "قتل غير مشروع" رُفعتا ضد عيادة للخصوبة قبل ثلاث سنوات. أعلنت الجمعيات المناهضة للحق في الإجهاض هذا انتصارًا رمزيًا وفعليًا، واعتبرت أن الأجنة تستحق نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال. كان هذا أيضًا بطبيعة الحال جزءًا من المناظرة الأميركية حول الإجهاض، فالأوساط المحافظة و"المناصرة للحياة" ترفض تجميد الأجنة، وهو خيار يأخذه عديد من الأزواج من أجل الإنجاب لاحقًا. كما تقول مديرة إحدى هذه الجمعيات اليمينية، فإنه "ليس من المنطقي ترك البشر في الجليد" في إشارة إلى عمليات تجميد البويضات والأجنة. على الجهة الأخرى من العالم، على بقعة صغيرة مطلة على المتوسط، حيث تذهب أسلحة أميركية بمليارات الدولارات سنويًا، كانت حرب الإبادة على قطاع غزة قد وصلت شهرها الرابع، وكان "القتل المشروع" للأطفال هو اللحظة الموازية هذه المرة. تحولت غزة إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال، كما ستقول منظمات عديدة؛ جحيمًا للأطفال كما يقول مسؤولون أمميون. قتل آلاف الأطفال بشكل مباشر، وربما عشرات الآلاف بشكل غير مباشر، تفشت الأمراض، وأصبح ما كان يومًا تحذيرًا أمميًا عما هو على شفا الكارثة، الكارثة بنفسها.
"ليس من المعقول ترك البشر في الجليد"، لم تفارقني هذه الجملة في الأيام الماضية. في وثائقي من إنتاج التلفزيون العربي بعنوان "لهيب الثلاجات" (2024)، يقول والد أحد الشهداء الذين قضوا في ثلاجات إسرائيل أعوامًا، إنه عند استلام جثة ابنه، التي كانت مكعبًا من الجليد، كان قلقًا من أن ابنه "سيتكسر"، حرفيًا. كان حتى تخيل صورة جسد يتكسر مرعبة. "لا يجب ترك البشر في الجليد" تقول مديرة الجمعية، التي تناصر على الأغلب "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وترى نصرة إسرائيل واجبًا دينيًا، كما فعل بوش، وتفعل الغالبية العظمى ممن يحاربون الإجهاض تحت شعار نصرة الحياة. لكن كيف يصبح الأطفال المحتملون أهم من الأطفال الموجودين فعلًا، وكيف يكون النقاش الأول، الذي قد يسقط رؤساء ويأتي بغيرهم، نقاشًا عن الحيوات غير الموجودة بعد، في دولة تمول بالمليارات قتل آلاف الأطفال الفعليين وسلب عشرات آلاف الحيوات القائمة؟ كيف يحدث ذلك، بينما لا تزال السياسة الخارجية موضوعًا غير ذي شأن لدرجة أن يغير من المعادلة؟ والأهم من ذلك كله، كيف تصبح نصرة الحياة pro-life أداة لسلب الحياة في أماكن أخرى؛ الحياة غير البيضاء؟
أما المفارقة الأقسى، فإن تمديد مفهوم الطفولة بالمعنى القانوني ليشمل الأجنة، يحدث أيضًا بالتزامن مع حملات منظمة ضد الطفولة الفلسطينية، ليس فقط عبر قتل آلاف الأطفال كـ"أعراض جانبية"، ولكن عبر خطاب شامل يخرج هؤلاء الأطفال من تصنيف الطفولة نفسها ويضعهم في تصنيفات أخرى، تجعل قتلهم أسهل، واعتقالهم مفهومًا، ضمن استراتيجية شاملة لما سماه باحثون فلسطينيون سياسات نزع الطفولة Politics of Unchilding. إنهم إرهابيون محتملون، دروع بشرية، لكنهم ليسوا أطفالًا. ولما أصبح إفساد الأجنة قتلًا في ألاباما، لا يزال الأطفال الفلسطينيون "يموتون" في خطاب الصحافة الغربية السائدة، ولا يُقتلون. يموتون بلا فاعل، وبلغة المبني للمجهول، أو كأنهم ضحايا كارثة طبيعية.
الحياة كمسألة استحقاق
ستمتد المفارقة التي تضمنها خطاب بوش على طول السنوات التي تلته. ستفتح نقاشات طويلة عن العدالة العرقية والحياة المتساوية وعن حياة السود التي (لا) تهم، وستكون الحركات المناهضة للإنجاب في المعظم في الصف المعادي للحياة – الحياة غير البيضاء بطبيعة الحال. ستكشف تقارير مفجعة عن فضائح الحرب على الإرهاب، وسيتحدث المسؤولون الأميركيون عن مئات آلاف الأطفال الذين ماتوا في حروبهم كأعراض جانبية. ستنخرط نفس الإدارات الأميركية "المؤيدة للحياة" في حملات من القتل والتدمير الممنهج، وسيتم اغتيال وسرقة آلاف الأطفال السود والأصلانيين في تقارير موثقة. سيفصل أطفال عن عائلاتهم على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة، وستستمر هذه الإدارات في خضم نضالها لحماية الحياة المحتملة، في سرقة الحياة القائمة.
لكن ما هي الحياة سوى مسألة استحقاق؟ فالفصل بين ما هو حياة وما هو ليس حياة ليس فصلًا بيولوجيا، ولا تستطيع أجهزة المختبرات تقديم إجابة حوله. ليس إلا سؤال أهلية، سؤالًا عن الحق في الوجود. هنا، يموت آلاف السود والسكان الأصليين كل سنة فقط لأنهم لا يملكون أي وصول إلى الرعاية الصحية، ويمنح جورج بوش تأمينًا صحيًا حكوميًا للأطفال غير المولودين. يموت ملايين الأطفال في سوريا والعراق والسودان وفلسطين دون أن يمثل موتهم فقدانًا للحياة أو خسارة في خطاب النخب الأميركية، لكن أطفالًا لم يولدوا يملكون حياة يجوز التباكي عليها، ويصبح التحسر عليها جزءًا من استقطاب سياسي ضخم، وجزءًا من وعود صناع السياسة الأميركيين، بل ومن قيم الأمة، والأهم مبررًا لشن حرب استمرت لعقود ولا تزال مستمرة.

في كتابها بالإنجليزية "أطر الحرب: متى تستحق الحياة الحسرة؟" (2009)، تسائل المفكرة النسوية البارزة جوديث بتلر هذه "التأطيرات الانتقائية والتفاضلية"، حيث تسأل ببلاغة كيف تعكس تمثيلات الموت والحياة اللامساواة العميقة والراسخة، وكيف تكشف الحرب عن التقسيمات العميقة للعالم، بين من تستحق ومن لا تستحق حياتهم الحزن. وعلى هذا النحو، فإنه لا يمكن الإقرار بخسارة بعض الأرواح، ببساطة لأنه لم يتم اعتبارها من البداية حية، فلا يمكن أن يحدث الموت إلا لمن نعتبرهم بشرًا، تستحق خسارتهم الحزن. تشرح المفكرة النسوية كيف يتم تصوير مجموعات معينة أنطولوجيًا كخطر محتمل على الحيوات التي تهم أو التي تستحق الحسرة، فيتعذر حتى تخيل موتهم كمأساة تستحق الأسى. بل وغالبًا ما يتم تبرير هذا الموت، من خلال وصفه كضرر جانبي للمساعي الدؤوبة من أجل حماية وتوفير الأمان والمأوى للحيوات التي تهم. نعم، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مثلًا.
من ضحايا حروب أميركا في الشرق الأوسط، إلى المهاجرين واللاجئين، وضحايا الإيدز في أفريقيا، فإن الوصف الوجودي الانتقائي لجماعات معينة كغير متحضرين أو خطيرين، يتحكم حسب بتلر بأهليتهم ليس فقط للحياة، ولكن للموت الذي يستحق الحزن. لذلك، فإن وصفهم أنطولوجيًا "من خارج لغة الحياة" يسقط موتهم من الحزن العام. وبنفس المنطق، فإن سياسات الحزن تعزز، من خلال تضخيم الاهتمام بجماعات بعينها، من التقسيم الصارم الذي يجعل بعض الحيوات لها قيمة حصرًا، على النقيض وربما من خلال التضاد مع حيوات أخرى.
لم يكن غريبًا إذًا أن يتصل هذا التاريخ الطويل من "نصرة الحياة" المحتملة التي تهم، بسلب الحياة القائمة التي لا تهم في هذا الخطاب العنصري. تكفي نظرة سريعة على الخطابات المعاصرة ضد الإجهاض، لفهم كيف تذوب بسهولة في خطابات أخرى عن "الاستبدال العظيم"، أو في حركات الصهيونية المسيحية والنازية الجديدة، أو حتى الحركات التي تجاهر بحنينها إلى زمن الاستعمار الواضح. وكما يقول ستيف كينج، وهو شخصية برزت كرمز لكل من التفوق الأبيض ومعارضة الإجهاض: "إذا واصلنا إجهاض أطفالنا واستيراد بديل لهم على شكل شباب عنيفين، فإننا نستبدل ثقافتنا وحضارتنا". فأطفال الآخرين الملونين إذًا، هم خطر محتمل، إرهاب جيلي متواصل، أما أطفالنا المحتملين البيض، فإنهم ما سيكمل ثقافتنا وحضارتنا. أما ذروة المفارقة، فأن هؤلاء الأطفال الملونين، أصبحوا جزءًا من معركة حتمية، صراع حضارات، مع هؤلاء الأطفال البيض الذين لم يأتوا بعد.
لنأخذ خطوة إلى الوراء الآن، إلى غزة مرة أخرى، وإلى مدونات اليمين الإسرائيلية التي تقول صراحة بأنه "لا أطفال هناك"، إلى شبكات المال السياسي واللوبيات التي تتحكم بالنقاش السياسي وتربط مباشرة أو غير مباشرة الإجهاض بالحرب على الفلسطينيين، إلى مشهد الأجنة والجثث في الثلاجات، وأسئلة "القتل المشروع" وغير المشروع، إلى خطاب بوش، وإلى ما نتذكره من صور أطفال العراق وما تسرب من سجون غوانتنامو وأبو غريب، لنتذكر الخطابات الكثيرة عن الحياة المقدسة وغير المقدسة والحرب على الإرهاب والحرب على الإجهاض. لنأخذ خطوة إلى الوراء، وننظر إلى ذلك كله. عبر تلك الخطوط غير الواضحة تمامًا التي تجمع كل ذلك، ربما نفهم أكثر.