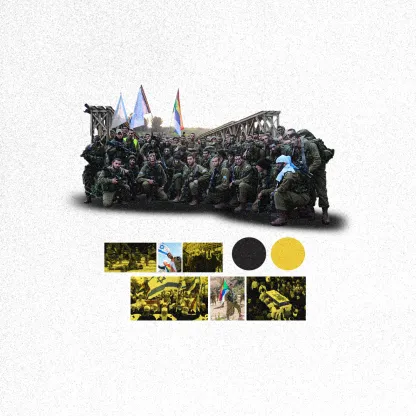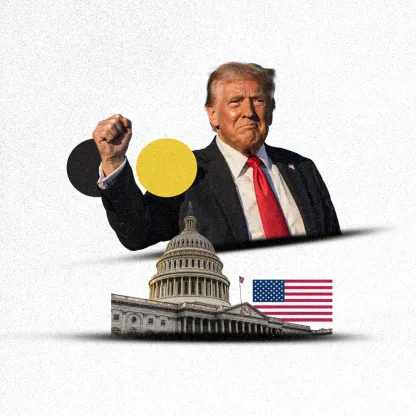ما الذي يميز خوفنا عن الخوف البدائي لدى الحيوان، أو حتى لدى أسلافنا من البشر الأوائل؟ ربما يكمن الفرق في أن الإنسان الحديث هو الأكثر اهتمامًا من بين كل الكائنات بإحكام سيطرته على كل عناصر الكون و التلاعب بها، بما في ذلك مشاعره وأفكاره الخاصة.
وفي عصر الرأسمالية المتأخرة، صار الاستثمار في "رأس مال الخوف" مباحًا ومسموحًا به ضمن آليات السوق، بعد أن كان التعويل على خوف الناس المدفوع بغريزة البقاء من أجل ضبطهم إداريًا واقتصاديًا وأمنيًا حكرًا على السلطة السياسية.
ومع دخولنا عصر "خصخصة الخوف"، صار من مسؤوليات الفرد تجاه نفسه وعائلته أن يصبح أكثر اهتمامًا بأمنه الخاص، وأن يدفع مزيدًا من الأموال ليضمن عدم تعرضه للخطر، ذلك لأن الأمن العام لم يعد مسؤولية الدولة وحدها.
قدّم لنا فيلم "The Purge" (التطهير، 2013)، للمخرج جيمس ديموناكو، تصورًا عن هذا التحول بطريقة لافتة: تُوجِدُ الدولة تقليدًا سنويًا تقوم فيه، ولمدة يوم واحد فقط، برفع كل القوانين والعقوبات وإباحة كل الجرائم أمام من يرغب في السلب والقتل والاغتصاب. وهنا يبدأ السباق المحموم بين الناس لشراء خدمات شركات الحراسة والتأمين، ودفع أموال طائلة لشراء البوابات الفولاذية و أجهزة الإنذار والأسلحة.
وكما يقول الباحث والفيلسوف الألماني بيتر سلوتردايك، في كتابه "التعبئة اللانهائية"، فإن الإبقاء على عنصر الهلع، والمحافظة عليه بكل السبل، هو من أسباب وجود الحضارات وقيامها واستمرارها. إذن، فالخوف الذي في داخلنا لا ينظر إليه المسؤولون عن إدارة الجموع والتحكم في سلوكها بنفس الطريقة التي نراه نحن بها. إنه أداة فعالة لا يصيبها البلى لتحريك الجماهير أو إخضاعها وتحويل اهتمامها من قضية مصيرية إلى أخرى هامشية. لكن اختزالًا من هذا النوع قد لا يستوي. فمن الصعب حقًّا الجزم ما إذا كانت حالة الخوف الدائم تمثل احتياجًا ونزعة فطرية عندنا، أم أنها ورقة سياسية في يد الطبقات الحاكمة تقرر لعبها حين ترى ذلك مناسبًا، والأرجح أنها مزيج من هذا وذاك.
كورونا.. أو الهلع من كل شيء تقريبًا
في عام 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19" وباءً عالميًا، مضيفةً بذلك فصلًا جديدًا في ماراثون الهلع العالمي، إذ كان الجدل في حينها محتدمًا بالفعل حول أخطار التغير المناخي. وكان لهذا الإعلان وقع بالغ على جاهزيتنا النفسية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، و السبب في ذلك يكمن فيما يلي:
دفع بنا تقدّم العلم، في كافة المجالات، إلى تناسي مصادر خوفنا التي تنقسم عادةً إلى ثلاثة أبواب: الخوف من جبروت الطبيعة (الخوف الكوني كما يسميه باختين)، الخوف من هشاشة الجسد، والخوف من العدوان الإنساني. هذا الواقع الجديد احتفى به ويليام جيمس في مطلع القرن العشرين بقوله: "في العالم المتحضر صار أخيرًا من الممكن لعدد كبير من الناس السير من المهد إلى اللحد بدون التعرض لوخزة واحدة من الخوف الحقيقي".
تكمن صدمة وباء كورونا في كونها أطاحت بهذه المستويات الثلاثة دفعة واحدة. فالخوف من الطبيعة عاد وبقوة مع تنامي التنبؤات بأنها ليست سوى البداية لسلسلة من الأوبئة. كما جعلنا الوباء ننتبه، مجددًا، إلى حقيقة هشاشة أجسادنا أمام كائنات لا تُرى. وأخيرًا، صرنا نعتبر أي إنسان يتحرك ويتنفس بالقرب منا، أو حتى يخرج للتنزه خارجًا في أوقات الحجر الصحي، يمارس فعلًا عدوانيًا/عدائيًا ضدنا. لكن هل كانت حياتنا تخلو من الهلع قبل كوفيد؟
الخوف ووفرة المعلومات
ربما تكون ميزة العصر الذي نعيش فيه هي وفرة المعلومات وعلاقتها بالخوف. ولعل نظرة على ثنائية العنف والتكنولوجيا، تترك الحدود واضحة لحقبة جديدة من الخوف الإنساني. على سبيل المثال، ظهرت أول نواة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سنة 2013. وخلال فترة وجيزة، اكتسح جيوشًا وأباد مدنًا وقرى قبل أن يتمكن العالم من تحديد أجندته. ما كان واضحًا وجليًا هو أن التنظيم يمثّل آخر "صيحات" الإرهاب العالمي. كما تمايز عن تنظيم القاعدة بكونه أكثر مؤسساتية منه، إضافةً إلى تحديد مجال نفوذه، كما يتجلى في اسمه، وتنصيبه خليفة وقادة ميدانيين.
ثم مع مبايعة الكثير من الجماعات المسلحة في كافة أنحاء العالم، صار هذا الخطر معولمًا وبات الإحساس بقربه منا لا يقارن بالشكل الأولي للإرهاب العالمي الذي كان أكثرنا لا يراه إلا في التلفاز من خلال تسجيلات قادته، على غرار بن لادن والظواهري وغيرهما. كما أن زعيم طالبان، الملا عمر، مات ونحن لا نعرف له سوى صورة رديئة الجودة بالكاد تُظهر عينه العوراء. أما في الحقبة الجديدة فيجري تصوير القتل والعمليات الإرهابية بكاميرات عالية الجودة، وبإخراج ينفّذه محترفون. فهل يعود ذلك إلى كون متطلبات إدارة الخوف في هذا العصر الرقمي صارت تستدعي مستوى عاليًا من الفرجوية، تتعدى مجرد صورة مشوهة لأحد الجهاديين، أو تسجيل صوتي على كاسيت؟
هذه المشهدية المفرطة للعنف الديني صارت بمثابة النار والوقود في آن معًا، وباتت على علاقة وثيقة بخوفنا المعاصر، حيث إنها تبث الرعب في حواسنا البصرية والسمعية كما لو كانت تحدث داخل بيوتنا. وهي كذلك تحفز نفسها أكثر باعتلاء مسرح الفرجة أمام الجميع بل وأمام نفسها أيضًا.
وفي هذا السياق، يقول المفكر التونسي العادل خضر في كتابه "اللابشري: هذا السّوى الذي لا يحتمل": "إن الانتحاري [في عصر الصورة] لا ينقلب بمجرد موته إلى شهيد. فهو في حاجة إلى شاهد يشهد عليه ويشاهد موته، ويحوّلَ ذلك الموتَ إلى مشهد فضيع كارثي. وهذا الارتباط الجديد بين الموت ومشهد الموت، بين الإرهاب ووسائل الإعلام، هو الذي يصنع من الإرهاب ظاهرة مروّعة عنيفة. ولا يقلب مشهد الانتحار المسلمَ إلى شهيد، وإنما إلى صنف من "الإنسان المقدس" الذي يسجل بموته دخوله في حوزة الإلهي وانسحابه من الفضاء العمومي".
إن لعصر الميديا الجديدة وطوفان المعلومات، دون شك، دور محوري في مفاقمة هلعنا. ومثالُ العلاقة بظاهرة الإرهاب العالمي قابل للتطبيق على كافة المجالات والقضايا التي تقض مضجع الإنسانية في هذا العصر. ويكفي أن نسترجع حادثة إحباط ركاب طائرة أمريكية محاولةً لتفجيرها من قبل شاب نيجيري سنة 2009، حيث اعترف باراك أوباما على إثرها بأن المشكلة لم تكن في نقص المعلومات، بل في زيادتها المفرطة، وأن الخلل كان في: "الإخفاق في استيعاب المعلومات التي كانت بين أيدينا بالفعل والتأليف بينها".
الحق في إدارة الخوف
بطريقة ما، يبدو أننا نحتاج للشعور بالخوف والهلع. فعلى الصعيد الفردي، يستهلك كثيرون منا أفلام وروايات الرعب، بينما يخاطر آخرون بتسلق جبال وعرة، وسواها من الأنشطة التي تحفز هرمونات الإثارة وحس المغامرة. لكن الأمر لا يقتصر على الفنون والرياضات الخطرة. فقد كان للمخيلة الشعبية نصيب في ابتداع أساطير وسيناريوهات لأهوال محدقة بالبشرية، بمعزل عن أهل العلم والسياسة. حتى وإن كانت تستلهم هذه التصورات من النخبة في عالم السينما أو الأدب، إلا أنها تبقى شاهدة على الحاجة لدى الناس، كل فترة من الزمن، للشعور بالفزع من خطر داهم بغض النظر عن شكله.
في 31 تشرين الأول/أكتوبر عام 1938، بثت إذاعة "C.B.S" الأمريكية مسلسلًا إذاعيًا مستوحى من من "حرب العوالم" لهيربرت جورج ويلز، تسبب خلال وقت قصير في حدوث فوضى لم تشهد الولايات المتحدة مثلها منذ زمن طويل، حيث ظن كثيرون من مستمعي الإذاعة الذين لم يلتحقوا بالحلقة منذ بدايتها، أن ما يسمعونه من صفارات إنذار وصيحات فزع لمراسلين عبر أثير الإذاعة كان تغطية عاجلة لغزو كائنات فضائية لولاية نيوجيرسي وانتشارها في كامل البلاد، ما دفع بالكثير من الناس لترك بيوتهم واللجوء إلى الجبال وسط تعطل شبكات الاتصالات بسبب العدد الهائل من اتصالات الاستغاثة.
قبل ظهور الإنترنت، كان خبر: "هل ينتهي العالم سنة ألفين وكذا؟" يتصدر عناوين الصحف كل سنتين تقريبًا، والأسباب تختلف من نيزك عملاق إلى بركان في جوف الأرض إلى غيرها من التصورات.
يؤكد لنا ما سبق أن نزعة معاداة النخبة Anti intellectualism، التي تجنح إلى التقليل من شأن آراء الخبراء وتنتقد سلطتهم، حاضرة حتى حين يتعلق الأمر بصناعة الخوف وإدارته. ففي أزمة كورونا مثلًا، رفض قسم كبير من الأمريكيين وسكان العالم تعليمات الأطباء والبروتوكولات التي وضعتها السلطات، وهو الشيء الذي صُنّف على أنه رفض للحد من حريات التنقل والعمل وما إلى ذلك.
لكن يمكن أيضًا قراءة الأمر، ضمن سياقنا هذا، على أنه رفض من الجماهير لاحتكار السلطة، العلمية والسياسية، للحق في إدارة الخوف. كأنما شعارهم في ذلك هو: اتركوا لنا المجال لنخترع خوفنا بمفردنا.
لا يمكن وضع تاريخ موجز للأفكار والأحداث التي أصابت البشرية بالهلع، حتى في الحقبة المعاصرة على الأقل. إذ إن التداخل الزمني وتأثير كل ظاهرة على ظهور ظاهرة أخرى لاحقة، جعل من مهمة رسم خريطة للخوف الجماعي الذي عصف بالإنسانية غاية في الصعوبة، حيث نصل بعد جمع الحوادث والتواريخ، وتحليلها ومحاولة التدبّر في مختلف أشكال الانفعال الجماعي إزاء الأخطار الداهمة، إلى حقيقة مفادها أن مسألة الاستغلال السياسي لغريزة الخوف في الإنسان لا تمثل سوى قطرة من محيط، في ما يتعلق بالأسباب التي تجعلنا نخاف الأهوال التي نجهل من أين ستأتينا ومتى، إذ إن التركيبة شديدة التعقيد لأدمغتنا تفرض حالة من اليقظة الدائمة في مواجهة الأخطار، بل وتساهم بطريقة ما في تدويرها وإعادة إنتاجها في حال غياب الهزات الوجودية المفزعة، وهو ما يلخصه زيجمونت باومان في كتابه الخوف السائل بقوله:
"تدفعنا المخاوف إلى القيام بفعل دفاعي، وعند القيام به فإنه يحول الخوف إلى وجود ملموس، فاستجاباتنا هي التي تعيد صياغة الهواجس المخيفة باعتبارها واقعًا يوميًا يجسد كلمة الخوف المجرد. وقد استقر الخوف الآن بالداخل، وهو يتسرب إلى أنشطتنا اليومية المعتادة، وقلما يحتاج إلى دوافع أخرى من الخارج، فالأفعال التي يولدها يومًا بعد يوم تمده بكل الدافعية والطاقة التي يحتاجها لإعادة توليد نفسه وانتشاره وازدياده" (ص179).