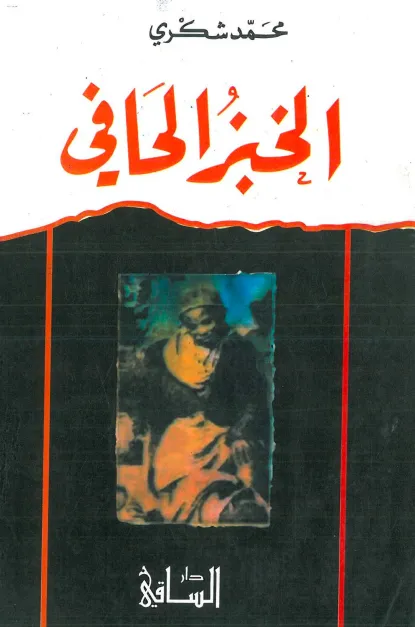ماذا يعني أن تصير كاتبًا مشهورًا؟ لطالما شغلني هذا السؤال وأهدر ليالي من التفكير والخوف لأنه يعني، بالنسبة لي، أن يوجَّه ضوء شديد نحو عينيّ، في الوقت الذي أعاني فيه من رهاب الضوء. وإذا لم أكن أعاني، فبعد مدة قليلة سأفقد القدرة على الرؤية الدقيقة، ولن أرى سوى الأشباح والظلام.
ربما لهذا أنظر للكتّاب المشهورين بعين الشفقة لا بعين الغبطة أو التمني، لأنني أتخيل حجم الصراعات التي يعيشونها بعد الشهرة، خاصةً المتعلقة بمصير أعمالهم المستقبلية وسؤال ما إذا كانت ستحقق شهرة ما سبقها، فهناك من حُصِر إبداعه في عملٍ واحد، أو في شخصية روائية ابتكرها.
أما الشاعر الذي تُختصر قصائده في سطر شعري يتيم، فلا أملك سوى أن أقدّم له العزاء لأنه داخل كل كاتب - حتى لو أنكر هذا أو لم يعترف به - رغبة جامحة في أن يصل كل ما يكتبه إلى الناس، وإلا فقدت الكتابة جدواها، فلم يحدث أبدًا أننا رأينا أحدًا توقف عن الكتابة لأنه اكتفى بالشهرة التي حققها، بل رأينا من توقف عن الكتابة لأن أحدًا لم يلتفت إليه وإلى ما يكتبه.
ولعل العبارة الصادمة التي قالها الروائي المغربي محمد شكري (1935 - 2003) بعدما حققت روايته "الخبز الحافي" (1972) شهرة لم تفقد بريقها حتى اليوم، وهي: "أشعر أنني من هؤلاء الكُتّاب الذين سحقتهم شهرة الكتاب الواحد"، تختصر هذه الصراعات في حقيقة مفادها أن الضوء يعقبه حتمًا الظلام، وليس بالضرورة أن يكمن هذا الظلام في زوال الشهرة، بل في عدم قدرة الكاتب على كتابة عمل آخر بالجودة نفسها، أو أن يكتب أعمالًا جيدة لكنها لا تصل بالقدر نفسه إلى الناس.
لكن كيف سحقت "الخبز الحافي" صاحبها؟
لا يخفى على أحد أن هذا العمل يتناول سيرة محمد شكري الذاتية. سيرته المتوحشة والجارحة التي تمتد أحداثها من الطفولة المبكرة إلى سن ما بعد المراهقة، وأن هذا العمل انتظر عشر سنوات قبل أن يصل إلى قرائه الحقيقيين في المغرب، فقد كتبه شكري عام 1972، ولم ينشر باللغة العربية إلا في عام 1982.
وبين هذين العامين تُرجمت "الخبز الحافي" إلى لغات عدة، واستحال شكري وعمله إلى ظاهرة تُقرأ وتُؤوَّل من منظورات عدة، أي أن العمل صنعته الضجة الفضائحية التي سبقته، ولم يكن يتوقع شكري بالطبع أن العمل سيُحدث هذا الجدل العالمي البالغ، خاصةً أنه كان ينفي عنه أية قيمة أدبية بقوله: "إن ما كتبته في هذه السيرة أعتبره وثيقة اجتماعية وليس أدبًا عن مرحلة معينة، آثارها السيئة ما زالت تنخر مجتمعنا".

ما يهمني هنا ليس ما تحويه هذه السيرة من فواجع أو فضائح، ولا كيف كان يَنظُر إليها كاتبها والنقّاد في تلك الفترة، وإنما الصراعات التي عاشها شكري بعد الشهرة الساحقة التي حققتها لأنه كان يعلم أنها ستظل محاولة - بالرغم من نجاحها - هشة ومُعرضة لليُتم إذا لم تسندها إنجازات أخرى.
ولهذا ألحق بها كتابين واصل فيهما أيضًا سرد سيرته، ولكن اهتمام الناس ظل محصورًا بروايته الأولى "الخبز الحافي"، إلى درجة أن الأطفال في الشوارع لم يكن ينادونه "شكري"، وإنما "الخبز الحافي". يقول: "كتبت (زمن الأخطاء) ولم تمت، كتبت (وجوه) ولم تمت. إن (الخبز الحافي) لا تريد أن تموت".
بالعودة إلى رسائله مع الروائي والأكاديمي المغربي محمد برادة، التي امتدت بين عامي 1975 و1994، والمنشورة في كتاب "ورد ورماد"، نجد أن شكري كان يشعر بعبء هائل من مواصلة الكتابة تحت ضغط الشهرة، وأنه ظل يتمنى أن يعيش بعيدًا في بلد لا يعرفه فيه أحد ليكون له من جديد أول صديق، أول خصم، أول عمل لم يمارسه من قبل.. إلى ما لا نهاية من الأوائل. فهو لم يكن يريد أن يكون نسخة من التكرار الأبدي، بل أن يكون وحيد نفسه وعصره وحياته ولعنته ورضائه وموته وبعثه، كما لم يكن يريد لأعماله أن تكون تكرارًا لما كتبه أو كُتب من قبل.
وفي إحدى رسائله التي تعود إلى عام 1980، أي قبل نشر "الخبز الحافي" (باللغة العربية) بعامين، نكتشف أن الشهرة لم تكن حافزًا أبدًا له، ولم تمنحه الثقة الكاملة فيما يكتب، بل إنه كثيرًا ما كان يمزق كتاباته، وخاصةً في مرحلة التنقيح التي تمثل له الكتابة الفعلية.
يقول: "العزيز محمد أرسلت لك 21 قصة، ودون أن أدخل في التفاصيل فإن بعضها ترجمه بول بوولز ونُشر في مجلات أميركية وإنجليزية. أنا على يقين لو أني احتفظت بالقصص التي أرسلتها لك لمزقت بعضًا آخر منها. لا أبالغ إذا قلت لك بأني في حاجة دائمًا إلى من يحفزني على العمل، فلولا بولز لما كتبت سيرتي الذاتية، وجان جنيه وتينسي وليامز في طنجة (..) إنني مُصاب بالكسل اللذيذ وأيضًا بهوس الكتابة إلى حد الانهيار. في العمق أفضل الانهيار في الكتابة. ليس كل ما فيّ بليدًا".
وفي رسالة أخرى، يعترف أنه مزق روايته "الليل والبحر" التي كتبها عام 1966، وأنه احتفظ بفصلٍ منها ليحوّلها إلى قصة قصيرة بالعنوان نفسه، وأن هذه المرحلة من الكتابة، أي التنقيح، الذي يعقبه التمزيق، تستهلكه بما فيه الكفاية، لكنه يعترف أيضًا أنه لولا ذلك لانتحر منذ زمن.
كما أن الشهرة لم تنقذه من الأمراض. ففي أواخر 1977، دخل شكري مستشفى الأمراض العقلية بتشجيع من صديقه الطبيب محمد الجعيدي، لأنه كثيرًا ما كان يمر بأزمات نفسية عنيفة بسبب ماضيه الذي يلاحقه، ذلك أن والده كان لا يزال حيًا ويذكِّره بمواقفه اللعينة معه ومع إخوته، وقد حكى لمحمد برادة موقفًا يختصر هذه العلاقة المشوهة: "لقد كدتُ أبصق على وجه أبي عندما سمعته يقول عني: إنه يلبس معطف المخنثين (يقصد ميني معطف) وله لحية شيطان، وشعر (هداوة). أنت قد تقول لي بأنها أشياء بسيطة غير ذات أهمية يقولها أب عن ابنه، لكنها سفالة".
في هذه الأثناء، كان شكري بحاجة ماسة إلى المال، وكان يعترف كثيرًا أن المال، لا الشهرة، ما يحفزه ويشجعه على الكتابة، ما زاد من صراعاته لأن الكتابة ليست مهنة، ولا يريدها أن تكون كذلك، حتى أنه فشل كثيرًا في الدخول في عزلة الكُتّاب الحقيقيين، إذ إن الميول تتربى في الجماعة، أما العبقرية ففي الوحدة كما يقول جوته. ولهذا أخذ يفكر جديًا في التقاعد النسبي حتى يتفرغ نهائيًا للكتابة.
وبالفعل، تخلص في عام 1982 من لعنة العمل الذي كان يفجعه في الصباح ويقلقه في المساء لكنه ظل يكتب ويمزق، وظل يعاني من الفقر بعدما قلّت أموال "الخبز الحافي"، حتى إنه اعترف لمحمد برادة في إحدى رسائله بأنه لم يكتب شيئًا ذا أهمية منذ عام 1973، وأن الحديث عن الكتابة والقراءة بشكل مُلح صار يحزنه، وأنه يهرب من كل من يسأله عما إذا كان يكتب.
وكان عام 1987 هو ذروة شعوره بالفشل في الكتابة، والسبب أنه طلّق الكتابة وتزوج تفاهة الحانات. يقول: "كان ينبغي أن أستمر في الكتابة رغم الإحباط في النشر، حتى خطي تردَّأ بعد أن لم أعد أكتب سوى برامج الإذاعة وبعض الرسائل".
وحاول بعض المقربين منه دفعه إلى كتابة ما يحكي، لكنه كان يرى أن ما لا يُحكى هو ما يُكتب، أي أنه في الوقت الذي يشعر فيه بالعجز التام لم يستسهل عملية الكتابة، وفضل أن يعيش على ما تدره عليه الترجمات، حتى إنه في إحدى رسائله طلب من برادة أن ينساه ككاتب، وأن يتذكره كصديق، قائلًا: "يبدو أنني انتحرت أدبيًا دون أن أشعر".
من عمل عظيم إلى عبء ثقيل
الإشكالية هنا ربما تكمن في أن كتابات محمد شكري لم تخرج من ظلال السيرة الذاتية، لهذا لم يستطع أن يتخلص من القيود التي فرضها عليه نجاح "الخبز الحافي"، وقد وقع كثير من الكتّاب في هذا المأزق، أو هذه اللعنة المعروفة بـ"لعنة الكتاب الواحد"، مثل الكاتب السوداني الطيب صالح صاحب واحدة من أفضل مائة رواية في العالم خلال القرن العشرين، وهي "موسم الهجرة إلى الشمال"، التي نُشرت لأول مرة في أواخر الستينيات في بيروت، وتحوّلت بالنسبة له من "عمل عظيم" إلى "عبء ثقيل"، للحد الذي أعلن فيه يومًا عن كرهه لها: "أنا لا أحب هذه الرواية كثيرًا، رغم أنها كانت بداية شهرتي".
يعود هذا العبء في اعتقادي إلى ثلاثة أسباب، أولها أن الطيب صالح لم يرغب من الأساس في أن يكون كاتبًا، مثلما لم تكن لديه رغبة في نشر ما يكتبه. وكان قبل أن يغادر السودان إلى لندن قد حاول كتابة القصة القصيرة أو شيئًا من هذا القبيل، لكنه مزق ما كتب وانتهى الأمر عند ذلك الحد، بمعنى أنه لم يخطط لهذه الطريق، طريق الشهرة ومن ثم الاحترافية.
وعندما كتب قصته القصيرة الأولى "نخلة على الجدول" في لندن عام 1953، والتي نُشرت في مجموعته القصصية "دومة ود حامد"، كتبها تحت وطأة الحنين إلى أهله وبلده وعشيرته، كما أنه نشرها تحت وطأة إعجاب أحد أصدقائه الفلسطينيين بها، وهو معاوية الدرهلي الذي قال له إن أسلوبه فيه من ملامح أسلوب جيمس جويس.

بدأ الإنجليز منذ هذه القصة في التعامل معه بوصفه كاتبًا مهمًا، وكان هذا يُدهشه ويضعه تحت الضغط لأن الكتابة بالنسبة له "عملية عذاب متصلة"، إذ يقول في حوار مطوّل مع الصحفي المصري خالد محمد غازي، والمنشور في كتاب "الطيب صالح.. سيرة وشهادات من محطات العمر"، إن: "أكثر تحد أواجهه يتمثل في الصفحات البيضاء، أشعر أنها تخرج لي لسانها وتقول: لو كنت رجلًا اكتبني، وأنا في الغالب أرى أن الذي يدفعني للكتابة - غير البحث عن الراحة والدفء - هو اختمار تجربة ما داخلي فهذا يستفزني للكتابة ويرهقني حتى أفرغه على الورق، وهذا حدث مع قصة (الرجل القبرصي) ورواية (موسم الهجرة إلى الشمال)، فقد كانتا تعبيرًا عن اختمار تجربة".
السبب الثاني هو أن القراء والنقاد على حد سواء رأوا أن هناك شبهًا ظاهريًا بينه وبين بطل رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" مصطفى سعيد، وأنها ربما تكون سيرته الذاتية، وليست مجرد "رواية قضية" يطرح فيها مسألة الصلة بالغرب على نحو شديد من الالتباس، الأمر الذي جعله يشعر بأنه محاصر بالأعين والأفواه التي تلاحقه بالأسئلة أينما ذهب، خاصةً أن الكاتب في عالمنا العربي يعاني بشكل عام من تلصص القراء على حياته، فغالبًا ما يتم الخلط بين حياة الكاتب الفعلية وحيوات أبطاله.
وعندما سُئل الطيب صالح في الحوار المذكور أعلاه عن وجه الشبه بينه وبين بطل الرواية، قال منفعلًا: "مصطفى سعيد ليس هو أنا، والنساء اللواتي في الرواية كلهن من وحي الخيال.. أنا لا أعرف واحدة اسمها (ايزابيلا سيمور) مثلًا، لكن لعلني صادفت نساءً يشبهونها، ولو أنني أردت كتابة قصة حياتي لقلت "سيرة حياة"، والحقيقة أنني لا أملك الرغبة في كتابة سيرتي، لأن حياتي عادية وليس فيها ما يستحق أن أؤلف عنه كتابًا".
كان الطيب صالح، في أوقات كثيرة، يتعجب من الشهرة الكبيرة التي حققتها "موسم الهجرة إلى الشمال" لأنها روايته الأولى. وفي الغالب، لا يجتمع الناس على الأعمال الأولى للكتّاب لأنها في وجهة نظر البعض قد تكون مختلطة بأصوات كُتّاب آخرين، كما أن لا أحد يغامر مع كاتب مبتدئ، لكن الطيب صالح كان له ما يفسّر هذه الشهرة، وهو أن الرواية نُشرت قبيل هزيمة 1967، حيث كان الصراع بين الشرق والغرب محتدمًا، لهذا انتبه الناس لها (مع روايات أخرى بالطبع).
ولأنها أرّخت أيضًا لجيل كامل من السودانيين الذين ذهبوا إلى إنكلترا ودخلوا في صدامات، ولعله جيل كامل من العرب. لكنه، بالرغم من ذلك، لم يكن يرى أن "موسم الهجرة إلى الشمال" هي أهم ما كتبه، فقد ألحق بها رواية مهمة أيضًا هي "عُرس الزين" التي احتفى فيها بالعالم الذي فقده وهو عالم القرية السودانية، ولم يكن في أثناء كتابتها قد وصل إلى أوج شهرته، ما يعني أنه لم يكتبها تحت ضغط أو بدافع أن يثبت للناس أنه يستحق هذه الشهرة، بل لأنه يريد أن يصل صوته إلى الذين يحبهم.
ولعل هذه هي المعضلة الرئيسية التي يتعرض لها أي كاتب نال شهرة ما: أن يجد نفسه محاصرًا بتوقعات القراء وبأحكامهم القطعية على أعماله المستقبلية، فهم قد يسلبونه الشهرة كما منحوه إياها في أي لحظة. وبعض الكُتّاب أرخوا حبالهم للقراء، وقرروا ألا يكتبوا سوى ما يُطلب منهم، وهذا هو السبب الثالث لكره الطيب صالح لروايته الأولى، إذ كان يشعر أنه تجاوزها وأصبح في مرحلة أخرى قد تكون أكثر بعدًا وتعمقًا في مجال الرواية، وذلك بكتابته لـ"ضو البيت" و"مريود" وغيرها من الأعمال، لكنه ظل مرتبطًا في أذهان القراء بعمل واحد، وكأنه لم ينتج غيره. لهذا عندما سُئل عما جناه من الكتابة، ردد بيت المتنبي الشهير: "ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني/ بما أنا باكٍ منه محسود".
فتنة تطال صاحبها
ثمة نموذج ثالث أريد التحدث عنه، وهو الكاتب المصري صبري موسى الذي ما إن يُذكر اسمه حتى تقفز إلى الذهن روايته "فساد الأمكنة"، التي اختيرت ضمن قائمة أفضل مائة رواية عربية والحائزة على عدة جوائز أبرزها جائزة "بيجاسوس" الدولية من أميركا عام 1987، فهي الرواية التي جعلت النقاد يضعون صاحبها في جملة واحدة مع الأديب العالمي إرنست همنغواي، إذ رأوا أن هناك تشابهًا بين أجواء الرواية وبين "العجوز والبحر"، وربما الذي أعطاهم هذا الإحساس بالتشابه أو التقارب هو المغامرة في الطبيعة، فمعظم أعمال همنغواي عبارة عن احتكاك مباشر لأبطاله مع طبيعة قاسية صارمة، وهكذا كانت حياته نفسها.
ورغم أن صبري موسى لم يشعر طيلة حياته أنه مظلوم على مستوى الاهتمام النقدي بأعماله، إلا أنه كان يحزن كثيرًا من حصر إنتاجه الأدبي في "فساد الأمكنة"، وعبّر عن ذلك في اعترافاته المنشورة في كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة" للكاتب المصري أيمن الحكيم، قائلًا: "في تقديري أن روايتي (السيد من حقل السبانخ) أكثر أهمية من (فساد الأمكنة)، ولكن تظل الأخيرة هي الأكثر شهرة، وهذا يحدث دائمًا مع كثير من الكتّاب، أن عملًا من أعماله يشع بريقًا ويصادف هوى لدى القراء ويطغى على بقية أعماله".

قد يفسر هذا التهمة الظالمة وغير المنصفة التي ظلت تلاحقه حتى وفاته عام 2018، وهو أنه كاتب كسول ومقل في إنتاجه. فصبري موسى لديه ثلاث روايات، وخمس مجموعات قصصية، وثلاثة كتب في أدب الرحلات، إلى جانب عمله في كتابة السيناريو حيث أنجز أكثر من عشرة أفلام، أشهرها فيلم "قنديل أم هاشم"، وفيلم "الشيماء". ولا نستطيع أن نغفل أنه كان صحفيًا من الطراز الرفيع، وأنه كان مواظبًا على كتابة المقال الصحفي، وهو من الفنون الكتابية التي لا تقل أهمية عنده عن كتابة الرواية أو القصة.
لكننا بالعودة إلى طريقته في الكتابة، التي وصفها بأنها "غريبة ومدهشة وربما مرعبة"، نجد أنها لا تختلف كثيرًا عن طريقتي محمد شكري والطيب صالح، فالثلاثة لا يعتبرون أنفسهم كتّابًا محترفين رغم الشهرة التي تمتعوا بها، بل هواة، لأن الكاتب المحترف كما نعرفه لا بد أن يلتزم بمنهج صارم وبساعات عمل محددة وساعات راحة محسوبة ونظام معيشي واضح، كما الحال مثلًا مع نجيب محفوظ. ولكن صبري موسى كان فوضويًا بالكامل ولم يستطع طوال حياته إقامة هذا النظام.
يقول في اعترافاته: "كنتُ أكتب رواياتي في شكل حلقات صحفية، حلقة حلقة، وبمجرد أن أنتهي من كتابة أول حلقتين يبدأ النشر مسلسلًا.. وتبدأ المطاردة.. فأكتب في حالة توتر مصحوبة باليأس والخوف والأمل والإحساس الرهيب بالمسؤولية أمام القراء.. وفي بعض الأحيان كان الرسام ينتهي من رسم الحلقة والخطاط من وضع العناوين وتبدأ المطبعة في طباعة ملازم أخرى من المجلة، بينما أجلس أنا على مكتبي كأني أجلس على (خازوق).. أشعر وكأنني خارج عن وعيي، وفي بعض الأحيان تستعصي الكتابة لدرجة تجعلني أبكي فعلًا.. ثم تحدث المعجزة وأكتب وأنا لا أشعر بما يدور حولي حتى أنتهي في اللحظات الأخيرة.. وعندما تُنشر الحلقة وأقرأها أندهش فعلًا مما كتبته وكيف خرج بهذا الشكل".
والدليل على الرعب الذي كان يعانيه من فعل الكتابة أن خروج "فساد الأمكنة" إلى النور احتاج عشر سنوات تقريبًا. ففي ربيع عام 1963، أمضى صبري موسى في جبل "الدرهيب"، بالصحراء الشرقية قرب حدود السودان، ليلة كاملة خلال رحلته الأولى لهذه الصحراء، وهي الليلة التي ولدت فيها بذرة "فساد الأمكنة" داخله. ثم عاد ورأى "الدرهيب" مرة ثانية بعد عامين، وذلك خلال زيارته لضريح المجاهد الصوفي أبي الحسن الشاذلي، المدفون في قلب هذه الصحراء عند عيذاب، وأدرك في تلك الزيارة الثانية أدرك أنه في حاجة لمعايشة هذا الجبل والإقامة فيه إذا رغب في كتابة الرواية. ومن حسن حظه أن وزارة الثقافة المصرية وافقت على تفرغه من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1966 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1967 للإقامة في الصحراء حول "الدرهيب" للتفكير ومحاولة الكتابة، لكنه بدأ في كتابة الرواية وعام 1968 في أوله، ثم انتهى منها وعام 1970 لم يبدأ بعد.
ونُشرت "فساد الأمكنة" لأول مرة مسلسلة في مجلة "صباح الخير" الأسبوعية خلال 1969 - 1970، ثم نُشرت طبعتها الأولى في الكتاب الذهبي بالعدد (204) الذي صدر في تموز/يوليو 1973.
وفي عام 1974، بدأت الرواية تُحدث صدى هائلًا خاصةً بعد فوزها بجائزة الدولة التشجيعية، وفوز صاحبها بوسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، فكان كل من يقرأها يُفتن بها، وهي: "فتنة عمومية وممتدة وعابرة للأجيال والحدود ولم يفلت منها أحدٌ" كما يقول أيمن الحكيم الذي يؤكد في كتابه عن ساحر الصحراء بعد الاطلاع على أوراقه وسيرته أن فتنة "فساد الأمكنة" طالت صاحبها: "فعلى الرغم مما حققته له من شهرة وجوائز، فإنها حجبت وغطت بضوئها القوي على بقية إنجازه، وفيه ما لا يقل قيمة وإبداعًا عن تلك الرواية إن لم يكن يزيد".
الأمثلة على الكتّاب الذين عاشوا على الحافة الحرجة، الحافة التي يلتقي عندها الضوء والظلام، كثيرة ومتنوعة، لكنني حرصت على الحديث عن كل من محمد شكري والطيب صالح وصبري موسى، ليس فقط لأن أحدًا لا يختلف على عبقريتهم، وعلى البصمة التي تركوها في الأدب العربي، بل لأنني وجدتُ رابطًا مشتركًا بينهم، وهو أنهم كانوا يرون فعل الكتابة أشبه بالسير على الجمر، وهؤلاء هم الكتّاب الحقيقيون الذين لم يتاجروا بموهبتهم ولم يستغلوا الشهرة التي حققوها في ضخ أعمال متواضعة ومبتذلة، وكذلك لأنهم لم يروا أنفسهم في سباق مع أحد، ولا حتى مع أنفسهم!