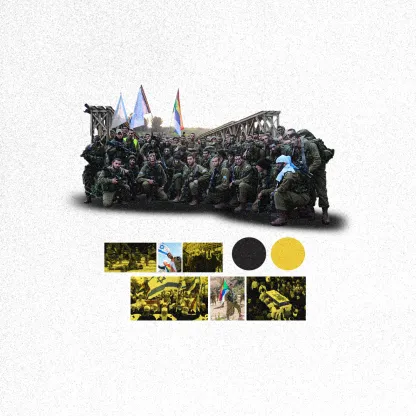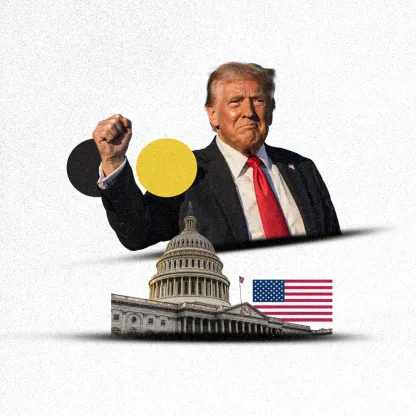الطلاق، بما هو فك للرابطة الزوجية، موضوعٌ أفقي على مجالات متعددة في تناوله ليس مبتدئها إلا المستوى التشريعي - الشرائعي دون المستوى الاجتماعي والنفسي وحتى الفلسفي أيضًا. وهو دائمًا ما يتصدر الجدل في الفضاء العمومي العربي من زاوية ارتباطه بهشاشة وضع المرأة على نحو يجعله عنوانًا أساسيًا في المطلبية التحديثية للمدونة العربية للأحوال الشخصية.
ولذلك لطالما مثّل مبحث الطلاق مدخلًا لحماية حقوق المرأة عبر التشريعات، وبالخصوص تمدد مجال رقابة الدولة من بوابة القضاء على نحو يؤدي إلى توسع مجال ما تسميه الدراسات القانونية النظام العام العائلي على حساب الفردانية المحضة. توسعٌ بعنوان حماية المرأة بوصفها الطرف الضعيف في ظل هشاشة موقعها في البيئة الاجتماعية والحقوقية العربية بوجه عام.
الحق في طلب الطلاق، ودور القضاء في إنشائه وتوثيقه، وحقوق المرأة المطلّقة؛ هي المسائل الأساسية المطروحة في المشروع الإصلاحي لتنمية وضع المرأة العربية. وهي مسائل لطالما أثارت الجدل، سابقًا وراهنًا، الذي يتبلور في عناوين متعددة منها ثنائية التقليد والتحديث في ارتباطها بمصادر التشريع، وكذلك مبحث التجديد داخل المنظومة الفقهية الإسلامية نفسها، دونًا عن دور القضاء/الدولة في معالجة المسائل الشخصية في المجال الأسري المحض. وتأتي التنقيحات التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية في عدد من البلدان العربية في بداية القرن الحادي والعشرين، بما شمل أساسًا أحكام الطلاق (المغرب والجزائر وقطر) أو في السنوات الأخيرة (مثل السعودية والإمارات) أو التنقيحات المبرمجة (مصر)؛ في سياق مسار إصلاحي يعكس ديناميكية مستمرة لا زالت حدودها بصدد التلمّس ولا زالت آفاقها بصدد الترصد.
الرقابة القضائية في منظار الإصلاح التشريعي للطلاق
لطالما ظهر الطلاق بوصفه أحد عوامل صناعة هشاشة وضعية المرأة في البيئة العربية من زاوية أنه يتمثل واقعًا، وبصفة إجمالية، كممارسة فردية وتعسفية لا تؤدي فقط لانحلال الرباط الزوجي، ولكن أيضًا لهدر حقوق الأسرة، وليس المطلقة فقط، وذلك ماديًا ومعنويًا. وبغض النظر عن النظام التشريعي للطلاق ومضامين الاجتهادات الفقهية، فقد أدت هذه الممارسات الاجتماعية في نظام أبوي منتج لعلاقات غير متساوية بين الرجل والمرأة، على الأقل فيما يتعلق بنوعية الحقوق ومجالها، إلى حالة من الخلل. وفي هذا الإطار، مثّل فرض الرقابة القضائية على الطلاق مدخلًا لضمان حقوق كل طرف دون تعسف، مع الإشارة إلى أن دور القاضي في إنشاء الطلاق في حالات محددة ثابت في الفقه الإسلامي، وليس الموضع لتبيانها.
وبذلك تصدرت المطالبة باشتراط الرقابة القضائية على الطلاق مطالب الإصلاحيين الأولين في إطار التجديد من داخل المنظومة الفقهية، على غرار المصلح التونسي الطاهر الحداد صاحب مؤلف "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" (1930)، الذي أكد أن: "تأسيس محاكم الطلاق ليست سلبًا للرجل فيه ولكنه تعديل له".
وقد استعرض في مؤلَّفه تسعة أسباب لإنشاء "محاكم الطلاق" كما سماها وقتها، ومن بينها ضمان وجود إحصائيات حول أسباب الطلاق لمعالجتها، على نحو يجعل الغاية ليس فقط ضمان العدل في تنفيذ الطلاق، ولكن أيضًا الحيلولة دون تحققه.
وطبعت هذه الأفكار مجلة الأحوال الشخصية التونسية (1956) التي لا زالت منذ ذلك الوقت مثالًا نموذجيًا في البيئة العربية للمكاسب التشريعية للمرأة، وقد نصّت بالخصوص على مبدأ أنه "لا طلاق إلا أمام المحاكم". فالطلاق ليس إلا فك للزواج مزدوج الطبيعة بذاته: هو عقد محض بين طرفين، ولكنه أيضًا مؤسسة اجتماعية وقانونية. وعليه، مثّل تدخل القضاء عنوان تثبيت للزواج بوصفه مؤسسة خاضعة للتدقيق في صورة إنهائها.
والطلاق أمام المحكمة يكون إما إشهادًا عليه وهي صورة لا يمكن للقاضي معارضة الراغب في الطلاق، وإما إنشائيًا له، وهي صورة بت القاضي في تحقق حالة من حالات استحقاق الطلاق لطالبه، كالضرر والعيب والغيبة وغيرها من الصور. ورغم تباين دور القاضي في الحالتين، أي أمام تصرف ولائي أو تنازعي، فالرقابة ثابتة لضمان احترام الأحكام التشريعية بوجه عام. وقد نحت عدة قوانين عربية، خلال العقود الأخيرة، في اتجاه اشتراط المرور عبر المحكمة للطلاق، كالقانونين المغربي والجزائري على سبيل المثال، بيد أن قوانين أخرى لازالت متمسكة بعدم اشتراط المرور عبر المحكمة ويكتفي بعضها بمطالبة الزوج بتوثيق الطلاق.
في هذا الإطار، تحلُّ معضلة الطلاق الشفاهي التي طالما أسالت الكثير من الحبر، خاصةً على ضوء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر مؤخرًا، وفي ظل ما ظهر من تجاذب بين السلطة السياسية من جهة، ومؤسسة الأزهر من جهة أخرى. وتتضمن ملامح المشروع توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
والملاحظ أن قانون الأحوال السعودية الجديد (2023) أوجب على الزوج توثيق الطلاق في أجل خمسة عشر يومًا، وجزاء الإخلال بلزوم التوثيق ليس إلا الالتزام بالنفقة تجاه الزوجة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمها به. ودون الطلاق الشفاهي، تحلُّ أيضًا معضلة الطلاق الغيابي، وهو رائج في بعض المجتمعات العربية في ظل غياب أو هشاشة الضوابط الإجرائية لممارسة الطلاق.
إن السؤال الجوهري في العمق لا يتعلق فقط بترتيب حقوق الأطراف في النص التشريعي كتحديد شروط الطلاق وآثاره، بل بتحديد مدى إطلاق الممارسة الفردية وبالتبعية دور المؤسسة القضائية في مراقبتها. الجواب لا يمكن أن يتجاوز مفهوم الطلاق بما هو حق لكل من الزوجين في نهاية المطاف، إن تجاوزنا الاختلاف الإجرائي بين مسميات الطلاق والفسخ والتطليق والخلع في المدونة الفقهية الإسلامية باعتبار أنها تمثل جميعًا، في النهاية، انحلالًا للرابطة الزوجية. لكن تبقى ممارسة الحق، أي حق بوجه إجمالي، مشوبة بضوابط شكلية كانت أو مضمونية تتعلق بشروط إنفاذه أو على الأقل بالتعسف في ممارسته.
ولذلك، كانت الحاجة لرقابة عبر القضاء لا تقتصر على إنشاء الطلاق فقط، بل أيضًا على الإشهاد عليه، باعتبار أن أحكام الطلاق لا يمكن أن تخرج عن النظام العام الذي تضبطه الجماعة عبر القوانين الملزمة.
يؤدي إبعاد الرقابة القضائية واقعًا إلى إطلاق الممارسة الفردية التعسفية في واقع اجتماعي تواجه فيه المرأة ضروب المعاملة التمييزية والهشاشة المادية والاجتماعية. بل بات توثيق الطلاق، على الأقل، طلبًا إشكاليًا. والحال أن التوثيق بوجه عام هو من مستلزمات الإدارة العصرية للمجتمعات.
ولذلك كانت المطالبة بالرقابة القضائية الشاملة عنوانًا رئيسيًا في المطالب الإصلاحية فيما يتعلق بالطلاق، ولكن الرقابة تثير، في زاوية أخرى مقابلة، إشكالية في منظار علاقة الفرد بالدولة، في سؤال تتزايد مشروعيته عبر الزمن حول أخلاقية دور الدولة/القضاء بوصفها أداة جبر على الفردي الحميمي. وهو سؤال وإن يتقاطع ظاهريًا مع تيار تغييب الرقابة القضائية على الطلاق موضوعنا هاهنا، فإنهما يختلفان في المضمون.
الرضائية في مواجهة الطلاق القضائي
دائمًا ما يتمّ تقديم التشريع الفرنسي بأنه نموذج للتشريع الوضعي الحداثي، خاصةً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وهو، بعد تكريسه للطلاق الذي لم يكن متاحًا في الإرث الكنسي التقليدي، الأمر الذي لم يكن في المقابل موضع نقاش في المنظومة العربية الإسلامية؛ فرض البوابة القضائية للحكم بالطلاق. لكن هذه البوابة باتت تظهر ثقيلة على فض العلاقة الزوجية غير التنازعية، خاصةً في ظلّ الأعباء، زمنًا ومجهودًا، التي يفرضها الفصل عن طريق المحاكم على غرار معضلة طول الزمن القضائي. وفي هذا الجانب، كان لافتًا أن يبادر المشرع الفرنسي لإرساء إمكانية "الطلاق دون قاض" انطلاقًا من عام 2017 في صورة توافق الزوجين.
إنه إحداث تشريعي جديد يستهدف إعادة إعلاء الرضائية، خاصةً في مادة الأحوال الشخصية. لكن الأكثر مزيد توكيد طبيعة الزواج كعقد بين طرفين بدرجة أولى، على نحو يفترض أن فسخه الرضائي هو قرار من طرفي العقد لا يفترض تدخّل غيرهما. وتُستذكر، في هذا الجانب، المقولة الشهيرة للفقيه الفرنسي العميد كاربونيي "لكل شخص أسرته، ولكل شخص قانونه". فلم تعد هناك حاجة ليمارس القاضي دوره الكاشف للإرادة المزدوجة للطلاق. بيد أن الطلاق الرضائي لم يشذ مطلقًا عن فرض أشكال رقابة أخرى وذلك عبر اشتراط صياغة كتب اتفاق بالتراضي عن طريق محام ولزوم تسجيله في الدفاتر الرسمية عن طريق الموثق. ولكنها تبقى رقابة لإجراءات هذا الصنف من الطلاق ليس أكثر.
ظهر استحداث الطلاق بدون محكمة في المنظومة التشريعية الفرنسية ردًا على الدعوات المتتالية لتقليص مظلة تدخّل القضاء في العلاقات الشخصية، في اتجاه توسيع مجال الحرية الفردية في تحديد آثار الطلاق على وجه الخصوص. يتحدث البعض، في هذا الجانب، عن توجه لخصخصة الآثار القانونية، ولكنه يظل محدودًا باعتبار أن توسيع الصبغة الرضائية لا يتعارض مع بقاء النظام العام العائلي الذي يفرض ضوابط لا محيد عنها.
اقترح الموثقون القضائيون في تونس مؤخرًا، عام 2023، مقترح قانون لتنظيم المهنة ينص على توسيع مجالات عملهم في اتجاه اختصاصهم بتوثيق ما أسموه "الطلاق الرضائي"، فيما يظهر تبنيًا للخيار الفرنسي للطلاق دون قاض. وهو اقتراح سُرعان ما تم تقبله بارتياب باعتبار أن مبدأ الطلاق القضائي هو مكسب جوهري استحدثته مجلة الأحوال الشخصية ضمن الخيار الإصلاحي الصارم لدولة ما بعد الاستقلال للمعضلات المجتمعية المؤدية لانتهاك حقوق المرأة.
يعكس هذا الارتياب مدى استمرار المخاوف من إعادة رمي الطلاق إلى خارج المحكمة، رغم أن الصورة تنحصر في الطلاق الرضائي المحض، خاصةً وأن الممارسة أثبتت أن الرقابة القضائية تحولت إلى عبء زمني، على الأقل في قرار ثنائي بالانفصال، عدا عن أن الصبغة العلنية للجلسات بالمحاكم تتعارض مع الطابع الخاص والحميمي للعلاقات الزوجية.
ارتفاع معدلات الطلاق وضمور الوساطة
يكشف تصاعد حالات الطلاق في الوطن العربي، على غرار ارتفاع عدد إشهادات الطلاق بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55 بالمئة في ظرف 6 سنوات فقط، بين 2010 و2016؛ عن تغييرات جوهرية في الممارسات الأسرية. ويعود ارتفاع معدلات الطلاق، مقارنةً بمعدلات الزواج، لأسباب متعددة في مقدمتها تزايد الوعي بالحرية الفردية وتزايد الاستقلالية المادية والاجتماعية للزوجة مقابل تراجع أدوات الوساطة والمصالحة.
إذ لا يكاد يغيب التنصيص في مدونة الأحوال الشخصية العربية على إمكانية الاستعانة بالوساطة العائلية لرأب الخلاف بين الزوجين استلهامًا من التحفيز القرآني في هذا الصدد. وفي التشريعات الغربية، كالقانون الفرنسي، توجد مؤسسة الوسيط العائلي، وهو مختص محترف في حل النزاعات الأسرية. ولطالما ظل دور القاضي في المصالحة عاملًا أساسيًا في تأسيس الرقابة القضائية على مسار الطلاق، بيد أن الممارسة على أرض الواقع أثبتت تراجع دور الوسطاء والمصالحين لأسباب متفرقة لعل في مقدمتها تراجع تأثير الوجاهة العائلية على الزوجين، استتباعًا للتغيرات التي شهدتها البيئة الاجتماعية العربية في العقود المنقضية.
فبقدر ما تمارس الوجاهة دورًا ما خاصة في المجتمعات القبلية، خاصةً في بلدان المشرق العربي، فإنها اضمحلت تقريبًا في المناخ المديني الذي يتميز بتزايد فك الارتباط عن الحاضنة الاجتماعية من جهة، وتعمق الخصوصية من جهة أخرى.
والواقع أن مساهمة تراجع دور الوساطة العائلية في تهدئة الخلافات الزوجية، وبالتالي في ارتفاع معدلات الطلاق على وجه إجمالي، يدفع لملاحظة تنسيب في صورة الطلاق بوصفه علاجًا ضروريًا لفشل الحياة الزوجية. ففي هذا الجانب، لطالما وجّه الاتهام لدور الرقابة الأبوية والمجتمعية في منع الزوجة على وجه الخصوص من الطلاق/التطليق/الخلع، وبالتالي في فرض الطلاق الصامت، وهو الانفصال الواقعي بين الزوجين تحت سقف واحد. وتتصاعد الدعوة في هذا الجانب لمعاينة الطلاق ليس بوصفه سوءة بل ضرورة أحيانًا لفسخ ارتباط لم يحقق الغاية المرجوة حين انعقاده.
في الختام، الطلاق هو حالة اجتماعية حاملة لآثار قانونية ومجتمعية ونفسية. ويعكس التغيير المستمر للأحكام المنظمة له في ورشة الإصلاحات التشريعية على تمحوره بوابة أساسية لمعالجة هشاشة وضعية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتظل دائمًا الأسئلة مطروحة، في الأثناء، حول أدوار المؤسسات (القضاء/الوساطة/المصالحة.. إلخ) في علاقة بالطلاق بوصفه في جوهره خيارًا فرديًا.