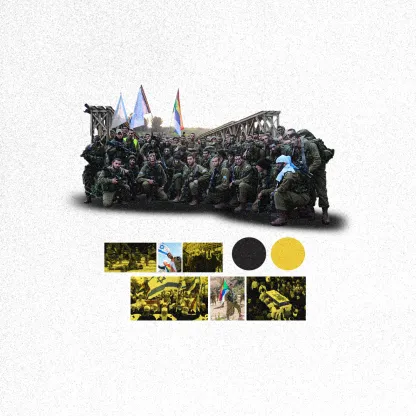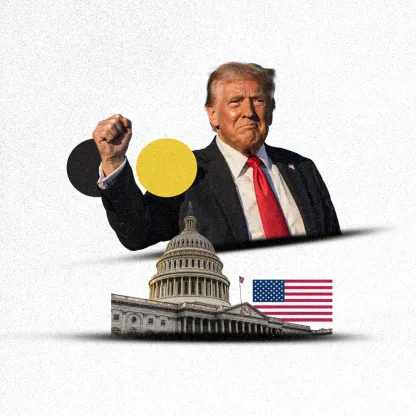فالموتُ تُعرف بالصفات طباعه
لم تلقَ خلقًا ذاقَ موتًا آئبًا
- المتنبي
يقول فرانسوا دو لاروشفوكو (1613 - 1680) في كتابه "حكم وأفكار: توقيعات" (1665): "ثمة شيئان لا يمكن التحديق فيهما: الشمس والموت" ( شذرة: 26). بالنسبة للموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، ومع الأسف لا نستطيع مجابهته أو حتى التحايل عليه هروبًا من وطأته وضراوة مخالبه، وهي الحقيقة التي صدّق عليها القرآن الكريم "أينما تكونوا يُدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة" (النساء: 78)، واختبرها الإنسان فاستخلصها في حكمة بليغة حسب قول أبي ذؤيب الهذليّ الذي فُجع في خمسة من أبنائه: "وإذا المَنيّةُ أنشَبَت أظفارَها/ ألفيتَ كلَّ تَميمةٍ لا تَنفعُ"، فهو وحده الذي لا يجد الإنسان له شفاء، حتى وإن راوغنا باستجدائه واستئناسه تارة كما في حالة محمود درويش في الجدارية:
"ويا مَوتُ انتظِر يا مَوتُ
حتى أستعيدَ صفاءَ ذهني في الربيع وصِحّتي
لتكون صيّادًا شريفًا
لا يصيد الظبيَ قُربَ النَبع
ولتكُنِ العلاقة بيننا ودّيةً وصريحة".
أو حتى بترويضه وخداعه تارة ثانية كما فعل أمل دنقل في قصيدته الشهيرة "لعبة النهاية"، لكن في النهاية لا مفرّ من الاستسلام، والوقوع في حبائله التي ينصبها لمن حانت لحظته/لحظتهم، وفي النهاية "كان مبتسمًا، وأنا كنت مستسلمًا لمصيري". ثم بعد كل المراوغات والتحايل عليه باستدعاء صور الأصدقاء (الأوفياء والخونة) والأقارب (الأب والأخت) كانت قصيدة الجنوبي أشبه بمرثية لذاته، حيث يقول معلنًا النهاية:
"-هل تريد قليلًا من الصبر؟
-لا
فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكنه
يشتهي أن يلاقي اثنتين: الحقيقة - والأوجه الغائبة"
(أوراق الغرفة 8، قصيدة الجنوبي).
تنظيم مجنون للحياة
الحقيقة المطلقة بلا مواربة هي أن جميع البشر فانون "وكل نفس ذائقة الموت" (العنكبوت: 57) لا محالة، والحقيقة الأخرى أن أمام سطوة الموت وديموقراطيته؛ حيث يتساوى الجميع في هذا المصير وإن كان فرديًّا (حيث هو ذو طابع فردي وشخصي) فلا يموت إنسان نيابة عن الآخر أو بدلًا منه وفقًا لقول الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة" (الأنعام، 94) تتضاءل أمامه كل مغريات الدنيا وشهواتها.
حدوث الموت أو اقترابه منا بفقد عزيز أو قريب أو صديق، إلخ.. يُجبرنا على أن نقف وقفة مصيرية أمام سطوته، هذه النظرة (لو بتدبّر وتأمّل حقيقيين) كفيلة بأن يتغيّر كلّ شيء في حياتنا؛ تفكيرنا وعلاقاتنا، واختياراتنا، وأيضًا ذواتنا التي لم تعد كما كانت قبل أن تمتد إليها يد المنون. وكأن لحظة الموت هي لحظة الارتداد إلى الوعي، لحظة التنوير وإدراك الحقائق الغائبة أو تلك التي كنا نماطل فيها "مدفوعين بالرغبة في الحياة"، باعتبارها هي الأخرى حقيقة كُبرى كما يقول شاعر الهند الأكبر طاغور، إلى أن تأتي لحظة الإفاقة ممثلّة في الموت / الوداع النهائي. فكما يقول رولان بارت في "يوميات الحداد": "ما إن يموت شخص حتى يبدأ تنظيم مجنون للمستقبل". هل معنى هذا أن الموت إشارة على إعادة التفكير فيما هو قادم؟ بالطبع نعم، وكذلك مراجعة الماضي. قد يظن البعض أن سيرة الموت توقف الحياة، وتدفع الإنسان إلى اليأس، ولكن ما رأيناه أن الموت (أو قربه بأي شكل) يدفع الإنسان إلى تغيير فكره وإعادة نظرته إلى الحياة، حيث علاقة الموت (أو قربه) بتغيير المصير علاقة مدهشة، فهو اللحظة الحقيقية التي يشعر فيها الإنسان بتفاهة الحياة، ومن ثمّ بعدها بحجم علاقته بالمتوفي (أو شعوره بقرب أجله) تنقلب حياته رأسًا على عقب فالموت أعمق لأنه كما يقول كيتس "مكافأة الحياة الكبرى"، ولنأخذ هذه الأمثلة، كدليل على فعل الموت المؤثر والمؤكِّد لمعنى كيتس.
ذكر إميل سيوران أن سقراط كان يتمرّن على عزف الناي أثناء استخلاص السُّم من الشوكران، فسُئِلَ: "فيم سينفعك العزف وأنت هالكٌ لا محالة؟"، فأجاب قائلًا: "يكفيني عزف هذا اللحن قبل مماتي". وكأنّ الشعور بقرب النهاية دافع ومحفّز لاستكشاف مُتع الحياة أو على الأقل الارتواء من رغباتها حتى ولو كانت متناقضة مع ظرف الموت. وما يمكن ذكره عن التغيير الجذري (لمصائر البشر) الذي يُحدثه الموت في الإنسان، ما يُروى عن أبي العلاء المعري، فعندما توفيت أمه كان عائدًا من بغداد التي ذهب إليها وهو في السادسة والثلاثين للتزوّد بالعلم، وقد أقام بها سنة وتسعة أشهر، رحّب به البغداديون وأحسنوا معاملته، وبينما هو في طريق عودته إلى مسقط رأسه، بلغه نبأ وفاة أمه، فكتب إلى أهل المعرة ينبئهم بعزمة على العزلة وقطع علاقته بالناس. جاء القرار نتيجة لحالة الحداد التي هو عليها، حياة المعري بعد وفاة أمه تبدلّت، وكأن هذه اللحظة الحديّة، إشارة لمراجعة حياته السابقة، فعلى الفور سلك نمطًا حياتيًّا غير الذي كانه قبل موتها، فاعتزاله للناس، جعله ينشغل بالكتابة، وكأن الموت أحيا في داخله هواية الخلق بالكلمات، فكتب المعري كتبًا مهمًا، تفوّق بها على نفسه.
وبالمثل رولان بارت (1915 - 1980) في اليوم التالي لوفاة أمه يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 1977، بدأ رولان بارت كتابة "يوميات الحداد"، ثم انغمس في أعمال كثيرة كلها متعلّقة بحالة الحداد، وحضّر لدراسته عن "كيفية كتابة الرواية"، لكنه في الوقت ذاته كان يميل إلى تغيير نمط الحياة على نحو ما فعل المعرّي، فقد سئم من كتابة محاولات نقدية، ومن إلقاء محاضرات هنا وهناك، وأخذ يحلم بحياة جديدة بـ: "فيتا نوفا" عنوان أحد كتب دانتي "يجب أن أختار حياتي الأخيرة، حياتي الجديدة"، لكن حياة بارت التي أراد تغييرها بسؤاله عن كيفية التوقف عن الكتابة، توقفت بالفعل بعد إصابته في حادث مروري مات على إثره.
الفيلسوف لوي ألتوسير (1919 - 1990) بعدما قتل زوجته هيلين في جريمة بشعة في يوم خريفي من عام 1980، هو الآخر لجأ إلى تغيير نمط حياته، وقد أفرج عنه القاضي لأن الجاني من وجهة نظره لم يكن في قواه العقلية، بعدها ماذا فعل ألتوسير قرر الاختباء وعدم الظهور مجددًا على مسرح الحياة” وكتب سيرته "المستقبل يدوم طويلاً" كنوع من التطهّر بذكر تفاصيل ما جرى. بعد الحادثة مباشرة خرج إلى الشارع باحثًا عمن يروى له ما حدث.
ميرسو بطل رواية الغريب (1942) لألبير كامي (1913 - 1960) عندما جاءه خبر وفاة أمه "اليوم ماتت أمي. أو لعلها ماتت أمس لست أدري"، تبدّل كل شيء في حياته، بل انقلبت حياته رأسًا على عقب، حتى حالة المبالاة التي تلقى بها الخبر كسرها، وأراد أن يغيّر نمط حياته، فخرج واحتفل، ثم أقدم على جريمة القتل، التي تمّ تبريرها بسبب سخيف في المحكمة، بأنها بفعل الشمس. لكن لماذا لم نأخذ في اعتبارنا، مقولة بارت أن الشخص يسعى إلى تنظيم مجنون إلى حياته، ألم يكن ما فعله مجنونًا.
بحثًا عن الأسلوب المتأخر
إدوارد سعيد (1935 - 2003) المفكّر الأميركي الفلسطينيّ الأصل، الذي عاش في الغرب متماهيًّا مع ثقافته وتقاليده، أدرك مع لحظة المرض الهوّة التي تفصله بين عالميْن؛ عالم التنشئة الأولى في بيئته الأصليّة، وعالم تربيته الكولونياليّة في البيئة الغربية حيث سنوات الدراسة والنضج الطويلة، كلها كانت خارج العالم العربي، في هذه اللحظة المفصليّة في حياته، أدرك أنه لا بدّ من تجسير هذه الهوة باستعادة حياته العربيّة، وبالأحرى هويته العربيّة وتمثّلها تمثلاً حقيقيًّا، خاصّة بعدما تأكد له بالدليل القاطع سواء بالمعاملة في المطارات أثناء رحلاته أو بالهجوم عليه بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية أنه صار "مضطرب الهوية" فكان يُعدُّ - كما أدرك - "غريبًا في صباه القاهرة لأنه أميركي، أما بلده الأميركي فلم يعدّه أصيلًا فيه" (برنن أماكن الفكر: ص 405).
فما إن داهمه المرض وقد تمّ تشخيصه، بإصابته بسرطان الدم (اللوكيميا) حتى شعر بأنه "تحت سطوة أشدّ الأفكار سوداوية عن العذاب والموت الداهمين" (خارج المكان: ص 301)، وفي الوقت ذاته كانت ثمة رياضة التجأ إليها كي يخفّف بها وطأة هذا الضيف الثقيل، ففكر حسب اعترافه: "بأهمية أن أخلّف سيرة ذاتية عن حياتي في العالم العربي، حيث ولدت وأمضيت سنواتي التكوينية"، غرض هذه السيرة أو المذكرات أو حتى "الرواية التوثيقية" حسب وصفه له دائمًا، تحقيق عدة أهداف، أوّل هذه الأهداف كما يقول: "حاجتي إلى أن أجسّر المسافة في الزمان والمكان، بين حياتي اليوم وحياتي بالأمس. أرغب فقط في تسجيل ذلك بما هو واقعي بدهي دون أن أعالجه أو أناقشه" (خارج المكان: ص 22)، أما الهدف الثاني فالسيرة كانت محاولة لترويض شبح الموت الذي غافله، محاولة لانتصار ولو مجازي باستعادة ذاته في أهم أطوارها، الطور الذي لم يهزمه فيه المرض.
يعود إدوارد سعيد بكتابه "خارج المكان" (2000) إلى هويته العربية، وقد بدأ في كتابته في أيار/مايو 1992 في ردّ مباشر على الذي يُهدّد بالنهاية، أي المرض الذي أنشب أظافره في جسده، فمع المرض حدث تحوّل مصيري لشخصه؛ فقد سعى عبر الكتابة إلى استرداد هويته باستدعاء الذكريات، والأهم تقوية صلته بأصله العربي فكتابه "خارج المكان" الذي يشير إلى عكس معناه، فهو ارتداد للهوية العربية، واستعادة لذات إدوارد سعيد التي سيكتشف على الرغم من شعوره بأنه خارج المكان بسبب عوالم التربية الثقافية والعيش والكتابة؛ أنه "عربي أدّت ثقافته الغربية - ويا لسخرية الأمر - إلى توكيد أصوله العربية، وإن تلك الثقافة؛ إذ تلقي في ظلال الشك على الفكرة القائلة بالهوية الأحادية، تفتح الآفاق الرحبة أمام الحوار بين الثقافات" (خارج المكان: ص 10).
لحظة الكشف التي أنارت داخل إدوارد سعيد والتي غدت أشبه بـ"تأمّل بروستي" على نحو ما كان يشير كثير من أصدقائه؛ ركّز فيها على ذاته الشّابة كأنها لم تكن هو، بل هي مخلوق غريب قاوم كل محاولات التفسير"، هذه اللحظة الحدية بكل آلامها قام عبرها بفعل استعادة كليّ لذاته ولهويته، فحسب قوله الكتابة عنده "استذكار، وفي الوقت ذاته فعل نسيان، أو استبدال اللغة القديمة باللغة الجديدة"، الغريب أن ردّة فعل إدوارد سعيد بعد هذه اللحظة الحدية (أي لحظة معرفته بالمرض) جاءت على النقيض تمامًا، فلم ينطوِ على نفسه، بل قام بفعليْن مجهديْن لذاته المجهدة بفعل المرض؛ الأوّل، يتمثّل في الكتابة بنهم، فحسب تلميذه تِمُثي برْنَن في كتابه "إدوارد سعيد أماكن الفكر" (2022) قال: "أمضى إدوارد سعيد السنوات الأربع الأخيرة من حياته في تجميع ثلاثة كتب قصيرة"، وكأنه في سباق ضد الزمن لكن الإرهاق جعل "التقدم في كتابة الكتب الثلاثة بطيئًا، وأجبره على تأجيل كتب أخرى (منها كتاب عن إقبال أحمد وآخر عن بيتهوفن وباخ) إلى يوم ما في المستقبلّ (أماكن الفكر: ص 403)، وفي انهماكه في الكتابة "تخلّى عن حذره من إغضاب زملائه في المهنة ومن الظهور بمظهر مَن لا يسير مع الركب"، فلم يعد لديه ما يخسره، فقرر كما يقول برنن: "أن من المستحسن أن يضع مبادئه على المحك بأوضح شكل ممكن" (أماكن الفكر: ص 410). هذا القرار قربه من فكرة المراجعة الشاملة لحقله الدراسي أو "كشف حساب" لمواجهة الدور الذي أدّاه ذلك الحقل في رسالة المثقف إن كان أدى دورًا كذلك حسب رأيه. وأول شيء فعله هو مراجعة ما كتبه من مقالات في السبعينات وأوائل الثمانيات عن الأدب المقارن والترجمة، ولاحظ كما يقول تلميذه برنن "إغراق الأدب المقارن في التخصص وبعده عن الشائع والمألوف.
وثانيًا استعادة حياته ومحاولة فضّ الاشتباك بين الهويتيْن المتصارعتيْن؛ الهوية العربيّة بحكم النشأة، والهوية الكولونياليّة/الغربية بحكم الثقافة والتربية، كان الغرض من الكتابة كما يعلن هو مقاومة المرض، معتمدًا على فعل التذكّر، حيث كما يقول "لعبت الذاكرة دورًا حاسمًا في تمكيني من المقاومة خلال فترات المرض والعلاج والقلق الموهِنة". لم يقتصر فعل الاستعادة على كتابة المذكرات، وإنما قام برحلة حقيقية عينية لأماكن النشأة، فزار القدس ومنها إلى القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. الكتاب بمثابة استعادة لأماكن عديدة فقدت هويتها بسبب سياسة التهويد، وشخصيات عديدة غيبهم الموت عن المشهد، وكأن الكتاب إحياء لمعالم عالم اندثر بأماكنه ورجاله.
الموت وتأمّل الحياة
الشاعر أمل دنقل (1940 - 1983) عندما استلمح رسول الموت في مرضه بالسرطان، أدرك أنها النهاية، وبدأ التحوّل وهو على فراش المرض المنذر بالموت، لم يستسلم خوفًا، بل شاغب الموت، وقاومه بضراوة خشية ألا يكون مثل الصقر "صقرًا مستباحًا"، خالقًا من لحظة الضعف والتحدي في آنٍ واحد، لحظة ولادة جديدة، مرحلة بدا فيها رومانسيًّا أو لنقل حياديًّا في تعامله مع كل الأشياء، بدءًا من المرض الذي تحوّل فيه هو إلى مرشد ومرافق لمرافقه، فصار هو السند لزوجته وهو يرى جزعها وهلعها عليه، ورومانسيًّا في تعامله مع أصدقائه الذين تاجروا بمرضه وبمساعداتهم له، ومؤسسات الدولة وتخاذلها مع محنته، بتراخيها عن مدّ يد العون لأهم شاعر، ومعاملته كمواطن من الدرجة الثانية، فلم يعد أمل ذلك "المحارب الفرعوني" الذي كان الجميع يخشاه من قبل، فهو نفسه يعترف لزوجته "لقد ظللت إلى عهد قريب أخجل من كوني شاعرًا، لأن الشاعر يقترن في أذهان الناس بالرقة والنعومة"، فهو حادّ الطباع يشتبك بحدة وقسوة قد لا تنناسبان مع الحدث:
"مبارزات الديكة
كانت هي التسليّة الوحيدة
في جلستي الوحيدة
فوق غصون الشجر المشتبكة"
ومع المرض صار نبيلًا في صمته وكأنه يتساءل: "كيف تواطأ من سكن القلب على دمنا المكشوف!".
قصائد أمل التي ولدت في أرجاء "الغرفة 8" بمستشفى السرطان (ضدّ من، زهور، لعبة النهاية، الخيول، السرير، الجنوبي)، كانت هي الأخرى ولادة جديدة لرؤية شاعر متصالح أولاً مع ذاته ومع الآخرين، حتى مع مَن تاجروا بمرضه، ولم لا، وكما يقول لاروشفوكو: "المصلحة التي تعمي البعض، تضيء طريق البعض الآخر"؛ وكذلك متأمّل للحياة التي آخذ في وداعها، وكأنه يمتثل لقول اسبنوزا: "إن آخر ما يفكّر فيه الرجل الحرّ هو الموت: لأن حكمته ليست تأمّلاً للموت، بل تأمّلًا للحياة"؛ فبدأ ينظر إلى الحياة والكون نظرة مختلفة ذات معنى لا ترى في الموت "نهاية كل شيء، وإنما هو نهاية لضرب من الحياة وبداية لضرب آخر منها" على نحو ما يؤمن كثير من الفلاسفة. فاكتشاف الموت في حدّ ذاته كما يقول أونامونو: "انتقال بالإنسان إلى مرحلة النضج العقلي أو البلوغ الروحي"، وهي نظرة في مجملها اكتسبها من رؤية الموت الذي يطل عليه من كل شيء، في الألم الذي ينهش جسده كل يوم، وفي نظرة الإشفاق مِن زواره، وفي لون رداء الممرضات والأسِّرَة وحبّات الدواء، وأردية الراهبات، وأربطة الشاش، وأنبوبة المصل، وكوب اللبن، وكل هذا كان يشير إلى لون النهاية لون الكفن (لون الحقيقة / الموت) أو كما يقول: "البياض الوحيد الذي نتوحد فيه"، فكانت فلسفة أمل الجديدة التي استقاها من مجاورته للموت، جميعها، فلسفة تأمّل لا مجابهة لهذا الذي تسلّل إليه فجأة، وكأنّ المرض/الموت روّض ذات أمل، على عكس ما يرى نقاده أنه كان يروّضه. فلسفة جعلته يعيد التفكير في أشياء كثيرة لم يكن ينتبه إليها من قبل، فأثناء وجوده في مستشفى السرطان للعلاج كان (كما تقول زوجته عبلة) "يتسللُ في منتصف الليل من غرفته ليسرق شوارع القاهرة ويعود ليخبئها في سريره، نسي أنه مريض ومارس عشقه لشوارع القاهرة، بالإصرار على رؤيتها بين الحين والآخر من نافذة سيارة أحد الأصدقاء" (الجنوبي: ص 122).
وعي أمل بالموت قديم، حاضر في كثير من قصائده ودواوينه الأولى، استحضره مرارًا وتكرارًا بصورة لافتة، بصور شتى: الموت الجماعي، والموت السياسي، والموت من منظور الذات، وكذلك الموت المتخيّل، وقد زحف إلى عناوين قصائده بدءًا من ديوانه الأول "مقتل القمر"، مرورًا بقصائد مثل: "موت مغنية مغمورة" و"الموت في لوحات" و"ميتة عصرية" و"الموت في الفراش"، و"فقرات من كتاب الموت"، و"الحداد يليق بقطر الندى"، إلخ... كما اختبره فعليًّا بموت الأب وهو طفل، وموت الأخت، وموت الأصدقاء، ومجازيًّا بموت الأصدقاء أو مَن اعتقد أنهم سكنوا القلب فأدموه. هذا الاطراد الكثيف بدلالاته المتعدّدة والعميقة في آنٍ واحدٍ، شغل الباحثين والدارسين فتوقفوا عند دلالات الموت، وإيقاعاته، وتشكيل صورته في شعره وغيرها من دراسات توقفتْ كلية عند تيمة الموت في شعره فقط، لكنّ الموتَ في ديوانه الأخير "أوراق الغرفة 8" موتٌ مختلفٌ عن سابقه، هو عن معايشة حقيقية في صورة المرض، الموت هنا ملموس، يجالسه، ويحاوره، وتطل معالمه في كل شيء بما في ذلك الزهرات التي تتنفس بالكاد "وعلى صدرها حملت - راضية / اسم قاتلها في بطاقة!". صورة جديدة للوعي بالعدو الذي يتربص، وينتظر لحظة القصف، والإعدام، فلا نراه يندب أو يبكي، أو حتى يعاتب، ولِمَ يفعل ذلك وقد قال شوقي: "محا الموت أسباب العداوة بيننا/ فلا الثأر ملحاحٌ ولا الحقد ثائر"، بل نراه يستأنس به ويحاوره كما في "لعبة النهاية"، وينتظره بشغف كما في قصيدة "ديسمبر"، وما توحيه دلالة اختيار اسم الشهر الأخير من دنو النهاية وأنها الخاتمة فيقول في نهاية القصيدة:
"قلتُ للورق المتساقط من ذكريات الشجرِ
إنني أتركُ الآن - مثلك - بيتي القديم
حيث تَلقي بي الريحُ أرسو -
وليس معي غيرُ:
حزني المقيمْ
وجواز السفرْ!".
وبصورة مباشرة يناديه:
"فمتى يقبل موتي
قبل أن أصبح - مثل الصقر -
صقرًا مستباحًا!؟".
وكأنه يريد أن يقول له، ها أنتَ غافلتني واقتربت، ولكن أنا سوف انتهز الفرصة، وأناديك: فلتأتِ. فيولد في لحظة الاحتضار ولادة شعرية قصائد "أوراق الغرفة 8"، وهي تجربة شعرية مغايرة عن تلك التي كتبها في دواوينه السابقة، وجاءت قصيدة "الجنوبي" لتحشد كل تداعيات الذاكرة في حنينها إلى بداياتها الأولى كما يقول جابر عصفور، فقد حنّ الفرع إلى أصله فيعود الجنوبي إلى أصله كما يعود النيل إلى منبعه:
"أو كان الصبي الصغير أنا؟
أم ترى كان غيري؟
أحدّقُ..
لكن تلك الملامح ذات العذوبةِ
لا تنتمي الآن لي
صرت عني غريبًا
ولم يتبق من السنوات الغريبة
إلا صدى اسمي
وأسماء من أتذكرهم - فجأة -
بين أعمدة النعيّ،
أولئك: الغامضون: رفاق صباي
يقبلون من الصمت وجهًا فوجها..
فيجتمع الشمل كلّ صباح،
لكي نأتنس".
اقتراب الموت من أمل كان فرصته الذهبية، لانعاش ذاكرته؛ كي يعود إلى ذاته بعد أن استغرقته أحداث العالم الخارجي، وانزوت ذاته في الظل لينتصر الهمّ الجمعيّ على الهمّ الذاتيّ، وتذوب (و/ أو تتوحّد) ذاته الفرديّة في الذات الجمعيّة ذات أمته العربية من خليجها إلى محيطها، يُحْبَط لانكساراتها، ويُبصِّر بمآلاتها الحزينة:
"الأرض ما زالت بأذنيها دم من قرطها المنزوع
قهقهة اللصوص تسوق هودجها.. وتتركها بلا زادٍ
تشدُّ أصابع العطش المميت على الرمالِ
تضيع صرختها بحمحمة الخيولْ
الأرض ملقاة على الصحراء... ظامئة
وتلقى الدلو مراتٍ.. وتخرجه بلا ماء
وتزحف في لهيب القيظ
تسأل عن عذوبة نهرها
والنهر سمّمه المغول".
ويدق ناقوس الخطر محذرًا تارة: “لا تصالح/ ولو قيل ما قيل من كلمات السلام"، وتارة أخرى صارخًا: “قلت لكم/ لكنكم/ لم تسمعوا هذا العبث/ ففاضت النار على المخيمات/ وفاضت... الجثث/ وفاضت الحوادث والمدرعات". فكان المرض والانعزال في "الغرفة 8" فرصته الأخيرة لاستعادة ذاته الفردية، بتذكّر الراحلين والأوجه الغائبة التي رحل بعضها وتاه بعضها الآخر في دوامة الحياة وبريق الذهب: طفولته (ورفسة الفرس التي شجّت الرأس "وعلّمت القلب أن يحترس") وأبوه، وأخته، ويحيى الطاهر عبد الله/ وصديقه سيد شرنوبي الذي عاش معه في حجرة في السويس، وقد خانته حبيبته، فعانى كثيرًا حتى ينساها، وخاض حربيْن وخرج منهما سالمًا، لكن عندما التهبتْ لوزتاه وذهب لاستئصالهما، مات بسبب المخدّر، أو لعله القشة التي أجهزت على القلب المفطور أصلًا! وأخيرًا الجنوبي الذي جاء مع أمل من الصعيد وتخلّى عن أحلامه بفعل الذهب المتلألئ في كل عين، فسقط أو مات مجازيًّا في عين أمل.
الرؤية العميقة التي بدت في نظرته لكل ما حوله الإنسان والأشياء بعد ما اقترب منه الموت، تكمُن في صدق استشرافه للحقيقة التي صاغها مُبكّرًا عندما قال في "الإصحاح الأول" من قصيدة "سفر ألف دال" إن:
"كل شيء يفرّ
فلا الماء تمسكه اليد
والحلم لا يتبقى على شرفات العيون
والقطارات ترحل والراحلون
يصلون ولا يصلون".