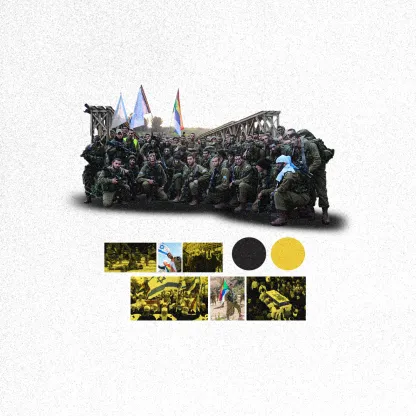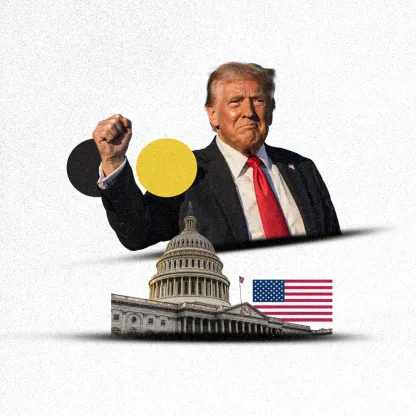تتمنى آمنة ضاهر، أم سامر (78 عامًا)، ممازحةً، لو يتزوجها فلسطيني من الضفة الغربية أو الداخل المحتل ولو لساعة واحدة كي تستطيع، مستخدمةً أوراقه، الرجوع إلى فلسطين ورؤيتها واحتضان ترابها والموت فيها. وللمصادفة اللطيفة، جاء حديثها على وقع نغمات أغنية فريد الأطرش "لكتب ع أوراق الشجر.. سافر حبيبي وهجر"، قادمةً من بيت أحد جيرانها في مخيم شاتيلا بالضاحية الجنوبية لبيروت. شعرتُ حينها كأنّ فلسطين هي الحبيب الذي هجر آمنة وما زالت تترقب عودته بكامل جوارحها منذ 75 عامًا.
ولدت آمنة عام 1945 في قرية دير القاسي بقضاء عكا، وهي قرية تقع على الشريط الحدودي اللبناني - الفلسطيني، وهُجِّرت منها بعد ثلاث سنوات لتمضي بقية عمرها لاجئة في لبنان، حيث عايشت محطات مفصلية من تاريخ فلسطين ولبنان يتداخل فيها السياق العام مع ما هو شخصي.
يجسّد صوت آمنة قصة وتاريخ وذاكرة فلسطين المحكية على لسان امرأة أكل الدهر واللجوء والحرب والتهجير المستمر سنواتٍ وسنوات من عمرها، وعلّم على ملامحها وتجاعيدها التي تروي كل واحدة منها قصة مختلفة في التفاصيل، متشابهة في المقاومة والوجع.
كانت احتمالات الموت الكثيرة رفيقة آمنة معظم حياتها، أولها أثناء النكبة، وكانت تبلغ من العمر حينها ثلاث سنوات، عندما هدمت العصابات الصهيونية منزلها فوق رأسها وعائلتها في قرية دير القاسي. تعرضت أختها حينها للإصابة بينما استشهدت أختها الأخرى. وعندما كان الجميع على وشك مغادرة المنطقة المدمرة، أصرّت والدتها على البحث عن آمنة لتجدها حية تحت أنقاض البيت. تصف هذا اليوم قائلةً: "كتبت عليّ الحياة أن أعيش، وأعيش كل مأساة الشعب الفلسطيني".
خرجت العائلة بعد التهجير إلى قرية عيتا الشعب اللبنانية. ومشت الأم، تجرجر خلفها أذيال الخسارة، كل تلك المسافة الفاصلة بين القريتين وهي تحمل جثة ابنتها لتدفنها وحيدة تحت شجرة زيتون في القرية ذاتها. ويبدو أن آمنة ورثت من والدتها حنيَّتها وخوفها على أولادها وذاكرتها الشفوية، إذ دائمًا ما تروي قصصًا متناقلة عن والدتها، وتصف حياتها بقولها: "قضيت حياتي مثل القطة يلي بتضل تنقل أولادها من مطرح لمطرح".
وكما هو واقع بلدها السياسي، كانت رحلتها مع التهجير مركبة. فبعد عيتا الشعب وُضع اللاجئون في شاحنات ونُقلوا إلى بلدة برج الشمالي جنوب لبنان، حيث وزِّعوا بعد ذلك على المخيمات. وكانت بعلبك المحطة الأولى لآمنة وعائلتها، فعاشت فيها ثلاث سنوات إلى جانب ثكنة غورو العسكرية الفرنسية، التي بقيت شاهدة على آثار الانتداب الفرنسي للبنان.
سكنت آمنة مع باقي اللاجئين الفلسطينيين في غرف كبيرة مقسمة حسب العائلات، وتستعيد مشهد السكن آنذاك وكأنه "معسكر"؛ غرف متراصة ومتلاصقة يستطيع المرء فيها أن يسمع كل ما يدور في الغرف المجاورة، بينما تفصلها عن مراحيضها مسافة بعيدة كان يتعين عليهم مشيها لقضاء حاجتهم.
تجسّد آمنة ذاكرة قوية محكية متنقلة يستطيع أن يلاحظها الغريب والقريب، يلقبها البعض بـ"كتاب تاريخ" لسلاسة سردها للروايات، وكأنها تحاول تعويض أسى الفقد وضياع الوطن والبلاد بحفظ التواريخ والتفاصيل والوجوه والأحداث. يشعر المرء عند الجلوس معها وكأنه داخل مشهد طويل معقد، صور كثيرة مركبة، قصة كبيرة متشعبة داخل قصص صغيرة تتناثر أحداثها هنا وهناك. تدل المرأة السبعينية التي لا تخلع العباءة الفلسطينية عن جلدها، على اللاجئين الذين تحفظ أخبارهم وقصصهم عن ظهر قلب، كلٌّ بمخيمه وبلده التي هجر منها. ففلان من قرية الزوق التحتاني استشهد، وآخر من قرية الكابري هاجر، وآخر كان فدائيًا وكرّس كل حياته للثورة الفلسطينية التي تخلت عنه فيما بعد.
ورثت أم سامر من ذاكرة أمها حكايا القمح والحصاد والزراعة وأدوار النساء الفلسطينيات قبل النكبة بين الأرض والغناء وتعبئة المياه، وحكايا الفلسطينيين ونضال الثوار ضد الانتداب الإنجليزي ومن ثم الاحتلال الصهيوني. فهاهنا القمح والتين والزيتون، وهنا البيادر ومضافة جد والدتها وفرسه التي كان يجوب بها البلاد من فلسطين إلى بيروت، وهناك ذكريات عكا ودير القاسي والكابري والتجارة في يافا، وثائرٌ خانه سلاحه الصدئ الذي أهداه إياه العرب، وهنالك تجنيد إنجليزي إجباري ومؤامرات دول كبرى ترسم مصير هذا الشعب.
هنا الألفة والمحبة بين أبناء الأرض، وهناك التلاحم والعشرة اللطيفة مع جيرانهم في جنوب لبنان. تقول: "ستي لبنانية من عيتا الشعب، كانت تيجي على بلدنا تشتغل"، "وجدي وجد فتاة ضائعة في لبنان عقب المجاعة خلال الحرب العالمية الأولى، فأخذها معه إلى بلده وربّاها وزوجته مع بناته". وعن تشابه الأرض تقول: "بلدنا وجنوب لبنان واحد، ذات الأرض وخصوبة التربة والطبيعة".
عادت ذاكرة آمنة الطفلة إليها عقب تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، إذ تروي مشاعرها عندما زارت قرية الظهيرة في الجنوب، ووجدت النساء هناك يجهزن نبتة التبغ لتصير دخانًا. عثرت في ملمس ورق التبغ والسلق والقمح على رائحة والدتها ودير القاسي، فطلبت منهن أخذ سنابل من القمح معها عند الرجوع إلى المخيم كي تقول لأحفادها: "انظروا ماذا كانت تزرع بلدكم، هذا القمح الذي نطحنه ثم نعجنه ليصير خبزًا نقتات عليه".
وتذكرت حكاية والدها الذي كان يبيع الزيت والزيتون في مدينة حرفيش المسيحية، إذ كانت هناك فتاة صغيرة اسمها مادلين اعتادت أن تناديه "يا بيّاع الزيت"، أحبها كثيرًا إلى حد أن سمّى ابنته على اسمها. تصف ذلك اليوم قائلةً: "حسيت بغصة، الجنود اللي مالهم أرض بأرضنا ونحنا بعاد عنها وبينا فاصل". عندما رأت معزاة عبرت الشريط الحدودي، نظرت إليها وأجهشت في البكاء معاتبةً إياها: "حلال من الله إنتي تفوتي على أرضي وأنا واقفة هون أتفرج؟!".
قصة آمنة ليست مرتبطة بالأحداث التاريخية المفصلية الكبرى وحسب، بل أيضًا بنضالات العمال اليومية الذين يبنون البلاد على أكتافهم وبعرق جبينهم. اضطر والدها أن يعمل جناينيًا في قرية دير الأحمر في بعلبك. وبسبب تهميش الأطراف وصعوبة إيجاد فرص عمل، اضطروا إلى النزوح إلى مخيم تل الزعتر، شرقي بيروت، الذي كان يحتضن اليد العاملة اللبنانية والسورية والفلسطينية لكونه يقع في منطقة صناعية، وذلك بعد مجيء "منظمة التحرير الفلسطينية" إلى لبنان وتحسن أوضاع اللاجئين قليلًا.
عاش اللاجئون الفلسطينيون في زمن الرئيس فؤاد شهاب تحت سيطرة الشرطة ومكتب الاستخبارات العسكرية، المعروف باسم "المكتب الثاني"، الذي اتخذ تدابير قمعية ومهينة بحق الفلسطينيين، لناحية تقييدهم ومنعهم من التجول والاستماع إلى الراديو أو قراءة الصحف، بل ومن زيارة المخيمات الأخرى دون تصاريح يتعذر عليهم الحصول عليها، هذا إضافةً إلى المضايقات اليومية والابتزاز والاعتقالات والتعذيب، الأمر الذي أدى إلى ثورة عام 1969 التي اندلعت داخل المخيمات، وانتهت بطرد عناصر "المكتب الثاني" منها.
تحكي آمنة عن هذا التاريخ بلغتها الشعبية، وتصف تغيّر الحال بعد مجيء المنظمة بقولها: "الثورة كانت ثورة عنجد"، وتضيف: "المخيم كان كله تخاشيب، بس إجت الفدائية اتعمّر، وبطّل تنك". ولا تنسى في حديثها معاملات "المكتب الثاني" لناحية قمع الفلسطينيين، إذ تقول: "كان ممنوع نتنفس".
وإثر اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (13 نيسان/أبريل 1975)، حاصرت ميليشيات "حزب الكتائب"، بمساعدة النظام السوري، مخيم تل الزعتر عام 1976 لمدة سبعة أشهر إلى أن وقعت المجزرة التي أدت إلى مسح المخيم الذي سُمي تيمنًا بقرية تل الزعتر قضاء عكا، وراح ضحيتها قرابة 4000 فلسطيني ولبناني. وكانت آمنة وعائلتها ممن عايشوا الحصار والمجزرة، لكنها نجت بأعجوبة. تقول واصفةً الحصار: "كنا نشرب مي فيها دم".. تدندن: "آخ بتل الزعتر، أبوي استشهد، واستشهد جاري وأطفاله وأخوي محمد".
أنجبت أم سامر ابنتين خلال الحصار، لتكون بذلك قد عاشت المأساة والتجويع والقصف مع أولادها الستة، وفقدت خلالها أخاها (22 سنة) ووالدها الذي تصف بحرقة مشهد قتله أثناء حديثها عن اليوم الذي خرجوا فيه من المخيم، حيث خرج جمع من اللاجئين حفاة مسالمين رافعين رايتهم البيضاء، فتسلّى عناصر "حزب الكتائب" اللبنانية بقتلهم وقنصهم، وكان والدها واحدًا من الـ 1500 فلسطيني الذين قتلوا عند استسلام المخيم.
رفض الوالد المصاب الخروج مع المصابين الذين أجلاهم "الصليب الأحمر" كي لا يترك عائلته وحيدة، فقُتل بدم بارد بعدما سأله العنصر: "معك مصاري؟"، ووجد في جيبه شيكًا فصرخ في وجهه قائلًا: "رايح تصرفه عند أبو عمار؟" فأرداه قتيلًا. الرجل الخمسيني الذي لم يكن مقاتلًا أصلًا، قُتل وهو يرتدي أجمل ثيابه، حاملًا شهادات ابنه الجامعية ومصحفه الذي أحرقوه أمامه، رغم أنه لم يكن "معاديًا"، إذ رفض على سبيل المثال قرار زوجته بتحطيم مقتنيات المنزل قبل مغادرتها لمعرفتها أن "الكتائب" سيسيطرون عليه فيما بعد.
في عائلة آمنة ثمانية مفقودين منذ ذلك الوقت، منهم أخوها وأخ زوجها وأولاده وأولاد عمتها. كانت آمنة تخاف كثيرًا، رغم هول ما رأت من جثث، إلا أن الصدمة لم تنزع عنها عاطفتها. امتنعت عن البكاء أثناء قتل والدها أمامها لأن أحدهم نصحها أنها إن بكت سوف تُقتل، لتنهار بعد الوصول إلى المدرسة التي نزحوا إليها في المدينة الرياضية، قبل أن يُنقلوا إلى منطقة الدامور: "طلعونا بالكميونات، جارتنا أم بلال غطت زوجي وسلفي في تنورتها كي لا يتم قتلهم"، هكذا نجا الرجال من العائلة على حد تعبيرها، إذ إن أم بلال رفضت الكشف عما تخبئه خلف التنورة ليطلق عليها أحد العناصر النار وهو يمشي وتصاب في إصبعها.
تصف الخروج من تل الزعتر بأنه مثل النكبة، الفرق أن الأولى كانت على يد الصهاينة، أما الثانية فكانت على يد: "جيراننا الذين تقاسمنا معهم الخبز والملح". تتذكر ذلك بينما يعيد التاريخ نفسه مع الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية التي يتعرضون لها.
في الدامور، عاشت آمنة تحت القصف والطيران تنقّل أولادها السبعة من ملجأ إلى آخر. وفي عام 1982، أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، أنجبت ابنها الثامن. انتقلت بعد ذلك إلى مخيم شاتيلا لتكون شاهدةً على مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، ثم هاجرت مرة أخرى من شاتيلا أثناء حصار المخيمات 1985 - 1987. تختصر رحلتها مع التهجير قائلةً: "قديه الواحد بدو يتعذب؟! هذا الشعب الفلسطيني شو قضى؟! ما ضل بلد إلا وضربتنا". تأخذ الموقف السياسي الذي يتخذه غالبية اللاجئين، يتذكرون من قتلهم من غرباء وعرب ويسمونهم واحدًا واحدًا، من النظام السوري، إلى الأردني، فالمصري، وصولًا إلى اللبناني.
بدأت آمنة العمل وهي في سن العاشرة من عمرها كي تستطيع إطعام إخوتها. عملت في معمل نسيج يملكه فرنسيون، ثم عملت في شركة بكداش للورق مدة 14 عامًا بعد زواجها. كان زوجها فدائيًا منشغلًا طوال الوقت في ساحات القتال ضمن صفوف تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وكصديقة للتنظيم، انتسبت آمنة إليه في قسم الشؤون الاجتماعية. وكانت الحياة الزوجية في ظلّ غياب الزوج معظم الوقت معقدة، إذ اضطرت إلى تربية أطفالها الثمانية وحدها في ظروف استثنائية سُجن خلالها زوجها، وذلك عدا عن أنها كانت تتلقى، أحيانًا، أخبارًا كاذبة عن وفاته وتعتقد بأنه مات.
وعلى الرغم من غياب الزوج لفترات طويلة، ظلت آمنة مخلصة له. "يلي بضيع بلاقيش"، تقول واصفةً فقده بعد موته. ورغم تربية أولادها وحدها، ظلت آمنة تربي أحفادها فيما بعد. ورغم السنين التي مرت، إلا أنها لا تزال تتذكر مواقف وعبارات عنصرية قيلت لهم كلاجئين منذ خمسين سنة لأن "الأسى ما بينتسى"، على حد تعبيرها.
تقول إنها تتذكر دائمًا لأنها تعتبر التذكّر جزءًا من الحفاظ على وجودها وروايتها أولًا، ولأن الأحداث تتكرر مرة أخرى. وبينما تنتظر اليوم آمنة دورها طويلًا لتحصل على حقها في الطبابة من عيادة "الأونروا"، تشاهد الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة المحاصر وهي تتذكر مأساة كل ما عاشته وعاناه شعبها. تختم حديثها عن الذاكرة قائلةً: "شو بدك تتذكري يا سفرجلة، كل ذكرى بغصة".
تذهب آمنة إلى دار المسنين يوميًا وتملأ وقتها في الرسم والحديث عن فلسطين. تعيش في غرفة ضيقة في مخيم شاتيلا. ورغم الألم ومرارة التجربة وكبر سنها، إلا أنها لا تزال تعيش على أمل أنها ستعود يومًا إلى فلسطين!