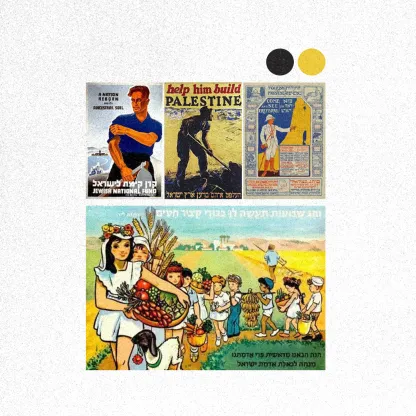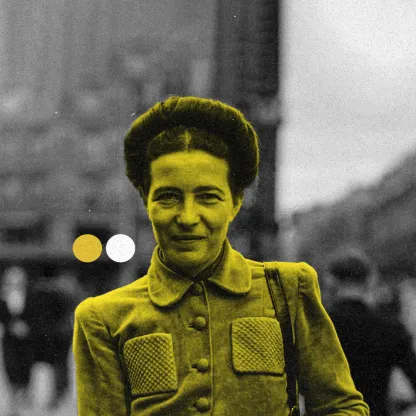المفهوم المركزي في حياة وتجربة الشاعر والروائي الألماني إلياس كانيتي (1905 - 1994) هو "التحوّل". وفي خطبته "مهنة الشاعر" التي ألقاها في ميونيخ، كانون الثاني/يناير 1976، رأى أن على الشاعر أن يكون "راعيًا للتحولات". هنا ترجمة لنص هذه الخطبة.
ــــــــــــــــــــــــ
من الكلمات التي ترددت في الآونة الأخيرة بقوى خائرة، تم تجنبها وتبطينها، وجلبت السخرية على مستخدميها، وفرّغت من محتواها حتى أصبحت إنذارًا قميئًا ومشينًا؛ كلمة "الشاعر". ومن أقْدَم على مواصلة مغامرة الكتابة بشكل من الأشكال، أطلق على نفسه لقب "شخص يكتب".
قد يطرأ على الذهن أن الهدف من هذا هو التنازل عن طموح كاذب، وضع معايير جديدة، الإلحاف بالقسوة على الذات وتجنب ما قد يؤدي إلى عواقب دنيئة. أما في الواقع، فقد حدث العكس تمامًا وطوّر، الذين أهالوا على كلمة "الشاعر" بأعنف الضربات بلا هوادة ولا شفقة، مناهجَ ترفع الصيت بوعي ودراية. الرأي الوضيع بموت الأدب عمومًا صنّف بيانًا أدبيًا في كلمات مثيرة للشفقة، طبعت على أغلى أنواع الورق ونوقشت بكل جدية واحتفالية كأنها أفكار معقدة وصعبة المراس. يقينًا، للفور غرق هؤلاء في وضعهم المضحك، لكن آخرين، لم يكونوا عقيمين بما فيه الكفاية للموت في بيان، كتبوا كتبًا مريرة وعالية الموهبة، كسبوا الصيت سريعًا كـ"شخص يكتب" وواظبوا على اتباع تقاليد الشعراء الأقدمين. وعوض التزام الصمت، كرروا تصنيف الكتاب ذاته المرة تلو الأخرى. ورغم يقينهم أن البشرية لن تتغير وأنها جديرة بالموت، فقد ظل لها عندهم وظيفة عليها أداءها، ألا وهي التصفيق لهم. من لم تعد فيه الرغبة بهذا، من سئم بنات الأوهام المكرورة، لُعِن مرتين. مرة كإنسان، فقد أسقطت عنه إنسانيته، ومرة لأنه أحجم عن الاعتراف بنزعة الموت اللانهائية للكاتب كإبداع أوحد ذي قيمة.
ستتفهمون أني لا أحيل شكًا على ظواهر الذين يكتفون بالكتابة يقل عن شكي بظواهر الذين مازالوا يسمون أنفسهم شعراء بكل رضا. لا أجد فرقا بين الفريقين، فهما متشابهان كما تشبه البيضة أختها، يبدو لهم الاعتبار الذي حصلوا عليه مرة حقًا مدونًا في كتب القانون.
والقول الفصل هو: من لا يشك اليوم بحقه في أن يكون شاعرًا، ليس شاعرًا. من لا يرى وضع العالم الذي نعيش فيه، يشق عليه قول شيء عنه. لقد انتقلت الأخطار التي تتهدد عالمنا إلى الدنيوي، وكانت قبلًا أهم مواضع اهتمام الدين. ينظر الذين ليسوا شعراء إلى القيامة التي عاشها العالم أكثر من مرة بعين باردة، ويوجد من يرى في هذا فرصة سانحة بجعلها مهنة يشبعون بها ويتخمون. منذ أن عهدنا بتنبؤاتنا للآلة، فقدت التنبؤات كل قيمتها. كلما نزعنا عنا المزيد، كلما ائتمنا أنفسنا لمرجعيات ميتة، كلما قلت سيادتنا على الماجريات. من سلطتنا المتنامية على الميت والحي، وخاصةً على الحي مثلنا، نشأت قوة معاكسة، نتحكم فيها ظاهريًا. يمكن قول الكثير الكثير، لكن كل ما سأسرده معلوم، وهذا هو المثير، فقد غدت كل تفاصيله حديثا يوميًا تلوكه الجرائد، غدا سخافة منكرة. لا تتوقعوا مني إعادته، فقد أضمرت اليوم شيئًا أقل بساطة.
حري بنا بذل الجهد في التفكير إن كان هناك في الوضع الراهن للدنيا أي شيء قد يستفيد منه الشعراء أو من كانوا يعتبرون في حكمهم حتى اليوم. فقد بقي للكلمة، رغم معاناتها الأليمة من ضربات القدر المتعسفة، بعضًا من حقها. ليكن الأدب ما كان، فهو لم يمت. مثله مثل البشر الذين ما زالوا يتمسكون به. علام تقوم حياة الذي يمثله اليوم، ما الذي عليه تقديمه؟
قبل عهد غير بعيد عثرت على جملة لمؤلف مجهول، لا أستطيع ذكر اسمه، لأن أحدًا لا يعرف من هو. الجملة مؤرخة في الثالث والعشرين من آب/أغسطس 1939، قبل أسبوع واحد من اندلاع الحرب العالمية الثانية، ومفادها:
"لقد قضي الأمر. لو كنت شاعرًا حقيقيًا، لكان لي أن أمنع الحرب".
أي بلاهة! نقول اليوم، لأننا نعلم حق العلم ما الذي جرى مذاك. أي خيلاء. ما الذي كان بوسع فرد واحد أن يمنعه ولماذا الشاعر تحديدًا؟ هل هناك طموح أكثر بعدًا عن الواقع؟ وما الذي يميز هذه الجملة من فخامة جمل الذين تداعوا للحرب؟
قرأت الجملة وبلبلتني، نقلتها إلى أوراقي بمزيد من البلبلة. وفكرت، لقد وجدت فيها ما يقززني أكثر من غيره في كلمة "الشاعر"، مطمحًا يقف على النقيض من إمكانات الشاعر، مثلًا عن الفطحلة اللغوية التي شوهت الكلمة ويدفع على الشك بنية صاحبه.
لكن بعدها، خلال الأيام التالية، شعرت لدهشتي أن الجملة لا تنفك عني، أنها تطرأ على ذهني مرارًا وتكرارًا، أني استحضرها، أفككها، أدفعها عني، وأعود لأستحضرها. أثارتني بدايتها: "لقد قضي الأمر"، التعبير الأمثل عن الهزيمة المطلقة، وهذا في زمن يعد بالانتصارات. وبما أن الأنظار كلها موجهة إليها، فإنه يتحدث سلفًا عن وحشة النهاية وكأنها محتمة. لكن الجملة الأصلية: "لو كنت شاعرًا حقيقيًا، لكان لي أن أمنع الحرب" تتضمن، عند المزيد من التمحيص، الوجه المخالف للفطحلة، أي الإقرار بالإخفاق التام. إلا أنها تعبر أقوى عن الإقرار بمسؤولية – وهذا هو المستغرب فيها – حيث لا يمكن الكلام عن المسؤولية بمعناها الضيق المعهود.
هنا ينقلب على نفسه من يعني ما يقول، فهو يقولها بهدوء، ضد نفسه. إنه لا يوطد لمطمحه، بل يتنازل عنه. لقنوطه مما سيأتي، يدعي على نفسه، وليس على المتسببين بالحرب، الذين يعرفهم بالتأكيد، فإنه لو لم يكن يعرفهم، كان سيفكر عنهم تفكيرًا مختلفًا. وبهذا لا يبقى إلا منبع واحد للبلبلة التي حدثت عنها: تصوره عن كنه الشاعر وأنه كان يعتبر نفسه شاعرًا، حتى لحظة تداعي العالم أمام عينيه باندلاع الحرب.
إن هذه الدعوة غير المعقولة إلى المسؤولية هي ما همزني على التفكير في الجملة. وأضيف علاوة على هذا أن الحرب بلغت حدًا لا يمكن التوقف فيه، بواسطة الكلمات، الكلمات الصادرة عن وعي، المكرورة والمغتصبة. وإذا كانت الكلمات قادرة على كل هذا الفساد، فلماذا لا تتمكن من الحيلولة دونه؟ لا غرو إذن، أن يأمل من يتعامل مع الكلمات أكثر من غيره، أثرا أقوى لها.
فالشاعر إذن، وربما نكون وصلنا إلى هذا التفسير على وجه العجلة، هو الذي يتوسم في الكلمات الكثير، يتنقل بينها بفرح، قد يكون أكثر من تنقله بين البشر، يستسلم لهم، لكن ثقته أقوى بالكلمات، يقوض عروشها، ليثبتها فيها برباطة جأش أكثر، يسائلها ويتلمسها، يربت عليها، يخدشها، يسحجها، يلونها، بل وفي مستطاعه السجود أمامها بعد كل ما أبداه نحوها من جحود. حتى لو لاح، كما يلوح غالبًا، أنه يقتل الكلمات، فإنه يقتلها حبًا.
خلف هذا الركام من التهور يكمن شيء لا يعرفه دائمًا، مضبب غالبًا، لكنه أحيانًا عنيف عنفًا يمزقه، وهو إرادة تحمل مسؤولية كل ما يمكن وضعه في الكلمات والتكفير عن إخفاقاتها.
ما قيمة هذا التحمل الافتراضي للمسؤولية في عين الآخرين؟ ألا تزول كل آثارها لأنها غير واقعية؟ أظن أن ما يلقيه الإنسان بنفسه على عاتقه، حتى الإنسان ضيق الأفق، يجدّ فيه أكثر مما يلقى على عاتقه بالقوة. كما أنه لا قرب من الأحداث، لا علاقة عميقة معها، أكثر من الإحساس بتحمل ذنوبها.
إذا كانت كلمة الشاعر مسوّسة، فهذا لأنها كانت مشحونة بالتمظهر والعبث، بالتملص، كي لا ترهق النفوس. إن ربط الفتنة السامية بالجميل، بكل أنماطها، قبل دخول المرحلة الأقفر في تاريخ البشرية، التي لم يستطع الشعراء معرفتها حتى لما حلت عليهم، لم يأت لهم بالاحترام والتقدير. ثقتهم العمياء، غضهم الطرف عن الواقع، الذي كانوا يحاولون الوقوف بوجهه بوسائل الاحتقار لا غيرها، إنكارهم لأي علاقة لهم معه، بعدهم الداخلي عن كل ما يحدث على أرض الواقع، فلم تكن لغتهم تشي بأي شيء من كل هذا، لهذا يمكننا اليوم أن نفهم لماذا أدارت العيون، التي كانت ترى بقوة ودقة أكثر، ظهورها لهذا العماء مندهشة منه.
على خلاف هذا تقف الجملة التي انطلقت منها في مطلع مقالتي. طالما وجد بعض، والحق يوجد الكثيرون من هذا الصنف، يتحملون مسؤولية الكلمات وتثقل عهدتهم لإحساسهم بالفشل الذريع، فلنا الحق في التمسك بكلمة أطلقت على مبدعي أهم الأعمال الأدبية في تاريخ الإنسانية، أعمال ما كنا سندرك دونها ما هي الإنسانية. بمجابهة هذه الأعمال، التي نحتاجها يقينا بشكل آخر، لكنها لا تقل عن حاجتنا لخبز يومنا، نتغذى عليها وتحملنا في ظلماتنا، وحتى لو لم يبق لنا غيرها، حتى لو لم نعرف كيف تحملنا، ونبحث دون جدوى في زمننا عن شيء قد يشبهها، فلا يبقى لنا إلا موقف واحد: نستطيع، إذا قسونا على زمننا وعلى أنفسنا، أن نتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد اليوم شعراء، بيد أننا نتمنى من أعماق القلب أن يوجدوا.
يبدو هذا تحصيل حاصل ولا قيمة له إلا إذا اتضح لنا ما هي الصفات التي على شاعر اليوم التحلي بها كي يجدر بحمل هذا اللقب.
أزعم أن أول وأهم السمات هي أن يكون راعي تحولات، راعيًا بمعنيين. من ناحية عليه أن يحيط بإرث الأدب العالمي الذي لا يفتقر التحول ولا نعلم إلا اليوم مدى غناه بالتحولات لأن أعمال معظم الحضارات القديمة قد فكت أسرارها قريبًا. فحتى القرن الماضي، كان على من يريد الإحاطة بهذه الناحية الأصيلة والملغزة للإنسانية، أعني بها موهبة التحول، أن يلتزم بعملين رئيسيين من أعمال القدماء، هما تحولات أوفيد، المصنف الذي يضم بين دفتيه معظم التحولات السحرية، "السامية"، المعروفة آنذاك، وثانيهما أقدم وهو الأوديسة، التي تقوم على تحولات الإنسان المغامر، أوديس. وهذه التحولات تصل قمتها عندما يعود إلى وطنه في هيئة المتسول، أدنى الطبقات، ولم يصل شاعر بعدها إلى كمال الرياء الذي تمكن منه، فما بالك بتجاوزه. من السخافة التطرق إلى أثر هذين العملين على الحضارات الأوروبية الحديثة، قبل عصر النهضة، وخاصةً بعده. تظهر تحولات أوفيد في أعمال أريوستو، مثلما تظهر في أعمال شكسبير وغيرهما، ومن الخطأ الفاضح الظن أن أثرهما على الأدب الحديث زال. أما أوديس، فما زلنا نراه حتى اليوم أمامنا، الشخصية الأولى في أعلام الأدب العالمي، التي غدت أساسًا من أسسها، سيصعب علي جدًا ذكر أكثر من خمسة أو ستة شخصيات على كل هذه العظمة.
لقد كانت الشخصية الأولى التي نستمد منها، لا شك، لكنها ليست الأقدم، فقد اكتشفنا شخصيات أقدم منها بكثير. لم تمض أكثر من مائة عام على اكتشاف البطل السومري غلغامش وعظم قيمته. تبدأ هذه الملحمة بتحول الكائن البشري الذي يعيش بين الحيوانات في الطبيعة، أنكيدو، إلى إنسان المدينة والحضارة، هذه المعرفة التي تلمس شغفنا أكثر لأننا بتنا اليوم نعلم الكثير عن أطفال عاشوا بين الذئاب. تصب الملحمة بموت أنكيدو في مجابهة رائعة مع الموت، المجابهة الوحيدة التي لا تترك طعم علقم الخداع الذاتي في الإنسان المعاصر. هنا أود أن أتقدم كشاهد على حدث يوشك أن يكون معقولًا: لا عمل أدبي، ولا أي عمل غيرها، غيّر مجرى حياتي كما فعلت ملحمة غلغامش التي يزيد عمرها على أربعة آلاف عام وكانت مجهولة حتى مائة عام مضت. التقيت به وأنا في السابعة عشرة من عمري ولم أتحرر من أسره حتى اليوم، كنت أعود إليه كما يعود المؤمن إلى الكتاب المقدس وملأني بالتشوق إلى المجهول، هذا بصرف النظر عن أثره الخاص من الناحيتين الجمالية والفكرية. يستحيل علي اعتبار المؤلفات التي تواترت إلينا على مد الدهور وغذّت روحنا، منتهية خالصة، وحتى لو تم البرهان على عدم وجود أعمال مكتوبة من نفس القيمة، يبقى لنا الاحتياطي الهائل من حكايات وخرافات الشعوب الطبيعية.
فلا نهاية للتحولات في هذه الحكايات، وهذا هو ما يهمني هنا. قد يقضي أحدنا عمرًا في تقصيها وفهمها ولن يضيع العمر سدى. لقد تركت لنا قبائل لا يتعدى تعدادها المئات إرثًا لا نستحقه والحق، لأن ذنب فنائهم يقع على عاتقنا أو أنهم يبادون أمام أنظارنا، التي لا تأبه بهم. لقد احتفظوا رغم هذا بكل تجاربهم الروحية حتى النهاية والجدير بالملاحظة هو أنه بالكاد يوجد شيء قد يفيدنا أكثر منها، بالكاد يوجد شيء قد يملأنا بالأمل مثل تلك القصائد القديمة، التي لا مثيل لها، التي نظّمها بشر نطاردهم، نغبنهم حقهم، نسلبهم، نجلب عليهم البؤس والمرارة. هؤلاء، الذين نحتقرهم لتواضع حضارتهم المادية، يبادون خبط عشواء، بلا رحمة ولا هوادة، تركوا لنا إرثًا روحيًا لا ينضب. لن يكتفي أحدنا شكرًا على إنقاذ العلم له. والحفاظ عليه من الاندثار، بعثه في حياتنا، هو واجب الشاعر.
فقد سميته راعي التحولات، لكنه راع في معنى آخر أيضًا. ففي عالم يصبو إلى النتيجة والتخصص، لا يرى سوى القمم التي يسعى إليها بخط عمودي ضيق الأفق، يضع كل قواه في العزلة الباردة للقمم، لكنه لا يألوا بالًا بالجانبي، المتنوع، الأصيل، الذي لا يساعد على صعود القمة، في عالم يصبو إلى منع التحول، لأنه يقف حائلًا دون الهدف الأعلى للإنتاج الصناعي، عالم يكثر إنتاج وسائل تدميره الذاتي ويحاول في الآن ذاته خنق ما زال متوافرًا من خصال كسبتها الإنسانية خلال العصور وقد يقف في وجه التدمير، في هذا العالم، أستطيع تسميته العالم الأكثر عماء من جميع العوالم، يبدو وجود الموهوبين بالقدرة على التحول رغم أنفه أمرًا حاسمًا له القيمة الأعظم.
أظن أن هذا هو الواجب الحقيقي للشاعر. عليه الاحتفاظ بالمعابر بين البشر مفتوحة، بفضل موهبة مُنحَها، كانت عامة قبلًا ومهددة اليوم بالاضمحلال، لكن عليها الصمود بجميع الوسائل. عليه أن يكون قادرًا على التحول إلى كل شخص آخر، حتى إلى أصغر الكائنات، أكثرها سذاجة، أكثرها عجزًا. يجب ألا تنحصر رغبته بمعرفة مجريات بواطن الآخرين لغايات تقوم عليها حياتنا العادية، يمكن القول الرسمية، يجب أن تكون رغبته منزهة عن كل نية على النجاح أو التقدير، أن تكون شهوة بذاتها، شهوة التحول المحض. ولهذا يحتاج الشاعر أذنًا صاغية دائمًا، لكن هذه لا تكفيه، فأغلب الناس لا يستطيعون اليوم الكلام، يعبرون عن أنفسهم بمقتطفات من الجرائد ووسائل الإعلام العامة ويقولون الشيء ذاته دائمًا، دون أن يكونوا ذواتهم دائمًا. والتحول الحق فقط، لا غيره، التحول بمعناه المتطرف، الذي أستخدمه هنا، يمكّنه من الإحساس بما يختفي وراء كلمات الإنسان، بالمحتوى الحقيقي لما فيه من حياة. إنها صيرورة مبهمة، لم تجر أبحاث على طبيعتها إلا بالكاد، ورغم هذا فهي المنفذ الحقيقي الأوحد إلى الإنسان الآخر. حاول المتنطعون معرفة مداخيل هذه الصيرورة بمختلف الأساليب، فسموها التعاطف أو التقمص العاطفي، وأنا أفضل، لأسباب لا داعي لذكرها الآن، كلمة "التحول" المشحونة بمزيد من المعنى. لكن، سيان ما كان، فلن يجادل أحد أنها صيرورة حقيقية ونفيسة. في الدأب على ممارستها، في معرفتها القسرية لشتى أنواع البشر، كلهم، وخاصة منهم الذين لا يلفتون إلا القليل من الأنظار، في الممارسة القلقة، التي لم تذبل أو تنشلّ بنظام عملي، أود أن أرى مهنة الشاعر الحقيقية. ربما لا تسكب إلا ندرة من هذه الخبرة في كتاباته. أما كيف سيتم الحكم عليها، فهذا أمر يدخل عالم النتائج والقمم ولا يهمنا اليوم، فإننا مشغولون بمن هو الشاعر، إن كان هناك شاعر، وليس بما يخلفه من آثار.
إذا صرفت النظر كليا عم يعتبر نجاحًا، بل إذا أبديت الشك نحوه، فهذا يرتبط بخطر، يعرفه كل منا بنفسه. إن النية على النجاح، مثل النجاح ذاته، له أثر يضيّق الأفق. إن الساعي على دربه محدِّدًا هدفه يشعر بكل ما لا يخدم هدفه وطأ ثقيلًا. يرميه عن نفسه لتخف حمولته، لا يهمه إن كان ما يطرحه أفضل ما فيه أم لا، تهمه النقطة التي يصلها، يقفز من نقطة لنقطة أعلى وأعلى ويحسب الارتفاع الذي بلغه بالأمتار. موقفه هو كل ما يهمه، وهذا الموقف تحدده العوامل الخارجية، ليس هو من يبلغه، لا يد له في بلوغه. يراه ويسعى للوصول إليه ومهما كانت هذه الجهود ضرورية في مجالات كثيرة من مجالات الحياة، فإنها تدمر الشاعر، الشاعر كما نود أن نراه.
فالشاعر الحق عليه خلق المزيد والمزيد من المكان في ذاته. مكانًا لمعرفة لا يكسبها لغايات بعينها ومكانًا للبشر الذين يختارهم ويحتويهم بالتحول. فأما المعرفة فله كسبها بالعمليات النظيفة والنزيهة، التي تحدد البناء الداخلي لكل فروع المعرفة. لكن لا توجد قاعدة واعية تقوده لاختيار هذه الفروع، التي قد تكون متباعدة جدًا عن بعضها البعض، بل إن دافعه هو النهم الغامض للمعرفة. وبما أنه منفتح في الآن ذاته على جميع البشر ويفهمهم بطريقة قديمة، لا علمية، أي بالتحول، بما أنه على حركة داخلية لا تتوقف، عليه ألا يضعفها، ألا يضع لها نهاية – فهو لا يصنف البشر، لا ينسقهم في أنظمة، بل يكتفي بلقائهم واحتوائهم - بما أنه يصدم بهم، فمن المحتمل أن يتحدد التوجه المفاجئ إلى فرع معرفي جديد بمثل هذه اللقاءات أيضًا.
أنا واع تمامًا لغرابة هذا المطلب، فهو لن يثير إلا الاعتراض. قد يشي بأن الشاعر ينحو إلى فوضى المحتويات المتضادة والمتنازعة في نفسه. وليس لي ما أنقض به هذا الاعتراض إلا القليل، هذا إلى حين. الشاعر يكون أقرب إلى العالم عندما يحمل في ذاته فوضى، لكنه يشعر، وهذا منطلقنا، بالمسؤولية تجاه هذه الفوضى، لا يوافق عليها، لا يستحسنها، لا يبدو لعينيه عظيمًا، لأنه يجد في نفسه مكانًا شاسعًا لكثير من المتضادات والمفككات، يكره الفوضى، لا يموت فيه الأمل بالقضاء عليها لأجل الآخرين ولأجل نفسه أيضًا.
وكي يقول شيئًا عن هذا العالم له قيمة ما، لا يحق له تجنبه والتخلص منه. عندما يضبط الفوضى التي يعنيها العالم اليوم، رغم كل الغايات والتخطيطات، فإنه يتجه بالمزيد من السرعة نحو تدمير ذاته، بهذه الطريقة وليس بطريقة الرقابة الأخلاقية، التي يفرضها القارئ، عليه أن يحملها في ذاته. لكن عليه ألا يصبح ضحية للفوضى، عليه، بناء على خبرته بها، أن يتحداها ويوجه إليها عواصف آماله.
ما هو هذا الأمل ولماذا يكون قيمًا، إذا تغذى على التحولات، تحولات الأولين، التي يكسبها عبر إثارة مطالعاته المعاصرة، عبر الانفتاح على المحيط الراهن؟
إنها قوة الشخصيات التي تحتله، لا تنسحب من المكان الذي استعمرته في نفسه، تعمل في داخله، كأن كيانه يقوم عليها. هي أغلبيته، المعبرة والواعية، هي، بما أنها تعيش فيه، مقاومته للموت. من سمات الخرافات المتواترة شفاهيًا أنها يجب أن تكرر وتشاع. حياتها تكمن في محدوديتها، قادرة على الرسوخ. لا يمكن معرفة كافة أسرار حيويتها إلا حسب الحالة المعينة، وربما تم تمحيصها قليلًا من منحى وجوب سردها المتواصل وإذاعتها. يسهل قول ما الذي يجري لنا عندما نسمع أحدها للمرة الأولى. لن تتوقعوا مني اليوم أن أسهب في أسرار كمالها، وإلا لن يكون لها قيمتها العظيمة. سأقتصر اليوم على واحد منها، وهو الإحساس بالثقة والقطعية، هكذا جرت الأحداث، وما كان لها أن تجري مجرى آخر. سيان ما كنا نعلمه من الأسطورة، لامعقوليتها الواضحة في سياق آخر، إلا أنها هنا، في هذا السر، تبقى خالية من كل شائبة، هنا تأخذ صيغة فريدة، لا غنى عنها.
هذا الاحتياطي من اليقين، الذي وصل منه الكثير إلى أيامنا، استغل في استعارات شاذة. وكلنا يعرف كيف استغلتها السياسة لمصالحها. وحتى في تشوهها، تسخيفها، اغتصابها، فلهذه الاستعارات الوضيعة مكانتها لعدة أعوام، إلى حين تنفجر فقاعتها. الاستعارات العلمية من نوعية أخرى تمامًا، وسأكتفي بمثل بارز: سيان ما كان رأينا بالتحليل النفسي، فقد اكتسب حظًا وافرًا من قيمته من كلمة "أوديب"، والمحاولات النقدية التي بدأت اليوم تصوب إليه، تبحث عن نقاط ضعفه في هذه الكلمة تحديدًا.
إن سبب الابتعاد عن الأساطير كامن في التشويهات التي أجريت عليها في زمننا. نتصورها أكاذيب، لأننا لا نعرف إلا ما استعير منها فإننا نرميها في سلة الاستعارات ذاتها. التحولات فيها تبدو لنا غير معقولة. لا نكتشف من معجزاتها إلا التي أصبحت حقائق بطريق الاكتشافات ولا نتفكر أن الفضل في هذه الاكتشافات يعود على الأساطير.
لكن ما يشكل أصل الأسطورة، علاوة على تمظهراتها ومحتوياتها الجانبية، هو التحول الذي يجري فيها. وهذا تمامًا ما خلق الإنسان نفسه به. بالأسطورة ساد الإنسانُ العالَمَ، به صار شريكًا فيه. قد نقدر على الإقرار بأن الإنسان سيطر على العالم بفضل التحول، لكن له فضل أعظم، فهو يدين له بالشكر على الرحمة.
لا أتورع من استخدام هذه الكلمة التي تبدو لخبراء الروح غير مناسبة، فإنهم يحبذون نفيها، وهذا أيضًا نابع من التخصص، إلى مجال الدين، فهناك يجوز استخدامها والعمل عليها. لكنهم يبعدونها عن القرارات العملية لحياتنا اليومية، التي تخضع يوما بعد يوم للتقنية.
قلت إن الشاعر هو من يشعر بالمسؤولية، رغم أنه لا يقوم إلا بأقل من غيره للبرهان عليها في التفاصيل اليومية. إنها المسؤولية عن الحياة التي تدمر نفسها، وعلينا ألا نخجل من القول إن هذه المسؤولية تتغذى على الرحمة. لا قيمة لها عندما تظهر في شكل إحساس فضفاض وعمومي. إنها تتطلب التحول الدقيق إلى كل فرد، حي وموجود. يتعلم التحول ويمارسه في الأسطورة، في الآداب المتواترة. وهو لا شيء إن لم يواظب على تطبيقه في محيطه. الحياة المتنوعة التي تصب فيه، وتبقى بكل تمظهراتها منفصلة حسيًا، لا تُسبَك في مفهوم مجرد، لكنها تمده بقوة تحدي الموت وبهذا تصبح شأنًا عامًا.
لا يمكن للشاعر أن يسلم البشرية للموت. بكل عنفوان سيعلم، هو الذي لا يسد أبوابه في وجه أحد، القوة المتنامية للموت في الكثيرين. وحتى لو بدا للجميع أن لا طائل منه، سيهز هذا اليقين ولن يستسلم أبدًا، مهما كانت الظروف. ستواجه عزته وفخاره رسل العدم التي تتكاثر في الأدب ويكافحها بوسائل أخرى غير وسائلها. سيعيش على وصايا صاغها بنفسه، لكنه لم يصغه لنفسه وحدها ونصها:
لا تدفع إلى العدم من يريد السقوط في العدم. لا تبحث عن العدم إلا لتجد طريق الخلاص وتدل الجميع عليه. اصبر على الحزن والقنوط لتتعلم كيف تنقذ الآخرين منه، لا احتقارًا للفرح الجدير بالخليقة رغم أنها تشوه وتمزق بعضها البعض.