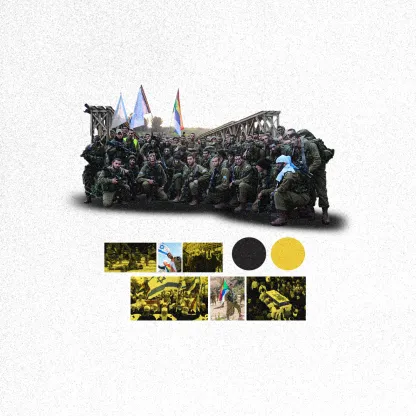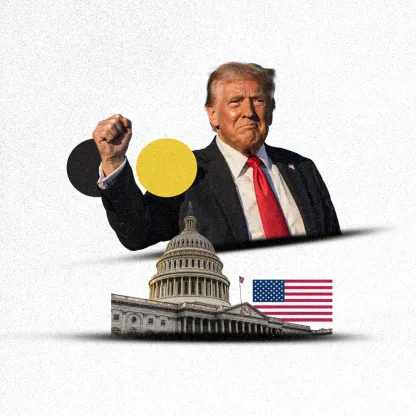"جسر الرئيس حافظ الأسد"، هذا هو اسمه، بيدَ أن السوريين مثل بقية شعوب الأرض ينزعون إلى الاختصار لذا اكتفوا بالقول "جسر الرئيس"، دون ربطه بالرئيس المقصود، أهو الأب أم الابن، أم أي حفيد محتمل في المستقبل. يلفظونه وكأنه بلا دلالة، اسمًا مجرّدًا، صوتًا عشوائيًّا لا يعني شيئًا، فالمعتاد أن يُطلَق اسم العائلة على المعالم الوطنية، مثل مكتبة الأسد، دار الأسد للثقافة والفنون، مستشفى الأسد، وأحيانًا لرغبة في التنويع هنالك في دمشق مستشفى اسمه "مستشفى الأسدي".
أذكر في إحدى جلسات النقاش التي كثرت بُعيد ثورة 2011، أنّ معارضًا ستينيًّا تلعثم على عتبة فراغ توجب عليه مِلأه بعبارة "مستشفى الأسد الجامعي"، لكنه سكت للحظة، ثم قال مشدّدًا "المستشفى الجامعي". صمت مجدًدا وبعد تنهيدة أسرّ لنا بأن الوقت برأيه ليس مبكرًا لتغيير أسماء الصروح المعمارية، فالناس ستحتاج أعوامًا حتى تعتاد عليها بعد انهيار النظام، لكنه أقر بأن اسم "الجسر الوطني" لم يرقْ له واقترح تسميته بـ"الجسر الرئيس"، إضافة "أل" تعريف فقط، لأنه ببساطة رئيسي جدًا في مدينة دمشق.
النظام لم يسقط وبقي الجسر جسر الرئيس، موجودًا جدًا، إلى درجة أن لا أحد ينتبه إليه، فهو مثل جبل أو سماء أو نهر، لكنه الأشد تورية لأنه الأكثر انخراطًا في المعمعة اليومية لسكان دمشق، تحمّل عبر أكثر من ثلاثة عقود عشرات ملايين الأقدام وعجلات السيارات والباصات والسرافيس ومؤخرات الشحادين وأصحاب البسطات، قشور البوظة والبسكويت وأكياس الشيبس، أعقاب السجائر المعلوكة، دخان العوادم، نظرات قاسيون المزعجة المتعالية المسمّرة في وجهه الشاحب مثل وجه عمال المناجم.
الجسر يقف على عدد من الأعمدة ذات شكل إسطواني، كثيرًا ما تُستخدم كإعلانات لحفلات أذينة العلي وريم السواس، لملصقات متآكلة الأطراف لمرشحي عضوية مجلس الشعب، لنعوات الوفيات، لمطهر الصفوري، لاعترافات غرامية تُخط بأقلام الفولمستر كحقائق موصوفة مثل "عبد الله يحب سوسن". لا أعتقد أنّ الشعارات المناهضة للنظام طاولت أعمدته وجدرانه الاستنادية في بداية الثورة، لأن معظم الأكشاك تحته لا تُغلق، فضلًا عن دوريات الأمن والشرطة التي تركن قرب زاوية المتحف الوطني، وحركة التكاسي المستمرة، وبعض سائقي سرافيس خطوط قدسيا ودمر والديماس ومساكن العرين، ممن يفضّلون السهر والعمل ليلًا بعيدًا عن زحمة النهار.
يُخيّل للمرء من كثرة لفظ اسمه أن الغرض الأول لإنشائه عام 1992، هو أن يغدو أشهر نقطة علّام في سوريا، أكثر من أن يكون أهم عقدة مواصلات في العاصمة، تصل بين حيي البرامكة وأبو رمانة بأربعمئة متر من إسمنت مؤسسة الإسكان العسكري، مطلّة على الشارع الموازي لنهر بردى الآسن والشحيح، الممتد بين جسر فيكتوريا شرقًا وساحة الأمويين غربًا.
قوة خفيّة تحثّ خطوات البشر فوقه، فيغذّونها لتهرول، موظفين وعسكريين ومدنيين، لحى مشذبة وشوارب، مانطوهات سوداء، حُجُب بيض وملونة، روائح عرق وعطور وكرواسان تنبعث عند أدراجه المكتظة بالصاعدين والنازلين، بطلاب كليتي الحقوق والشريعة والمجاورتين، بالذين يتابعون طريقهم إلى كليات العلوم والاقتصاد والتربية، بشابّات يعبرن مسرعات من أمام بسطة عليها قلادات بأسماء وأحرف وقلوب، وميداليات فضية وأكواب بورسلان وسكاكين وأداة سحرية متعددة الاستعملات يعشقها العساكر وطلاب المدينة الجامعية، تُستخدم في الوقت نفسه لفتح المعلبات وتثبيت البراغي وقص الأظافر وفتح سدادات الزجاجات. الفتى الواقف خلف البسطة يُعلّق سيجارة في زاوية فمه ويتابع بنظراته طالبة تلبس حقيبة ظهر قماشية، لا يسمع صوت المرأة التي تسأله عن أسعار الجوارب وهو يحاول تمييز شكل الوشم المرسوم على كتف الصبية بينما تمضي مسرعة باتجاه كلية الفنون الجميلة.
الدرج النازل يكتظ ساعة الذروة بآباء يحملون أكياس الخبز والخضار ليصلوا ساحة الكراج، يرفعون دكة بناطيلهم القماشية عندما يقترب السرفيس، ثم يركضون ويزاحمون للحصول على مقعد أو مساحة للقرفصاء وسط أجوجة من الحر والعرق والأحذية المغبرّة. هنا هي النقطة نفسها التي ينزل فيها الجنود الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في ثكنات جبال دمشق الغربية، ومعهم قصاصة ورق تحمل توقيع الضابط على إجازة لثلاثة أيام، يمسكون بحقائب قماشية ويسيرون برؤوس حليقة ووجوه محترقة من الشمس، يتجهون ليستقلوا سرفيسًا آخر إلى كراجات العباسيين للانطلاق إلى أهلهم في المحافظات البعيدة.
المسافة الممتدة من زاوية الجسر من جهة البرامكة حتى وكالة سانا، تظلّ مزدحمة بمنتظري سرافيس مهاجرين صناعة، وميدان شيخ محي الدين، مزة جبل كراجات، برامكة كراجات، يحجبون هم وبسطات الباعة وأصوات الزمامير العمق التاريخي لدمشق الجديدة، الذي لا يتكشّف للعابر إلّا في صباحات يوم الجمعة، حين يكون الدمشقيون في المطابخ يعدّون فتة الحمص أو الفول، لتسترخي المدينة وتحاول التعافي من الصداع.
كنتُ أتمشى في تلك الصباحات هناك، أنظر إلى واجهة كلية الحقوق، وإلى حديقتها التي تُصوَّر فيها المظاهرات ضد الفرنساوي في المسلسلات. قبالتها رئاسة الجامعة، قصر رضا سعيد، شارع الحلبوني المرصوف بالحجارة، بجواره المتحف الوطني، هل حقًّا المتحف هنا! يمر بمحاذاته الملايين كل يوم ولا يلحظونه. يليه مباشرة مدخل التكية السليمانية، وكأنها بقعة معمار لا تتصل بالمحيط.
هذا الصباح تبدو الأماكن أدفأ، معالم المدينة أقرب من بعضها البعض أيام العطلة. أمشي في شارع النصر حتى أصل ساحة الحجاز، من هنا يمكن رؤية أعمدة المرجة. باتجاه الشمال قليلًا جسر فكتوريا، أقطعه وصولًا إلى ساحة يوسف العظمة، عندئذ، أعود أدراجي باتجاه الغرب، صوب فندق الفورسيزنس، حيث واجهات المحال الفخمة وبطاقات الأسعار على الملابس والساعات والمجوهرات، توحي باستحالة أن ينتهي هذا الشارع عند نهاية جسر الرئيس من ناحية أبو رمانة، حتى أنّ معظم الناس الذين نراهم تحت الجسر يشعرون بالوحشة حين يقتربون من تلك الأحياء.
آخذ نفسًا عميقًا من فوق الجسر وأتأمل الامتداد الغربي الواسع، المساحة الفارغة التي شغلها فيما مضى معرض دمشق الدولي شرعوا فيها بمشروع بناء لم يكتمل، تبنّته زوجة الرئيس وسمّته "وردة مسار"، من المفترض أن يخصص عند انتهاء العمل منه يومًا ما لاكتشاف مواهب وقدرات الأطفال السوريين. قبالته باتجاه الغرب قليلًا مبنى قيادة الأركان، قبل ساحة الأمويين التي تتوسط مبنى التلفزيون ومكتبة الأسد ودار الأسد للثقافة والفنون. في لحظة هدوء، أشعر أن بناء جسر الرئيس كان بمثابة اللمسة الأخيرة التي بدونها لن تُعرف هوية دمشق المعاصرة والزمن الذي تعيش فيه، وكأنما كل المعالم من حوله مربوطة إليه، يُخيّل إليّ أنه إذا اختفى فجأة فستمضي تلك الأماكن وتهيم مبتعدة عن الأرض التي بُنيت فوقها.
ما يلبث أن يعود يوم الأحد، أول من يبدأ العمل ساعة الفجر أصحاب بسطات الشاي و"التلاتة بواحد"، فهو موعد عودة السهارى والفنانات من مساكن برزة وملاهي التل. زبائن طلوع الضوء أسخياء ويستحقون الاستيقاظ باكرًا، فمن يسهر طوال الليل وينام النهار يصيبه نوع من الاستهتار، من تداعياته إكرامية تُسعِد صاحب البسطة وتمده بالتفاؤل. شيئًا فشيئًا تصحو المدينة، تُقلع باصات المبيت العسكري، يخرج الموظفون من بيوتهم، يمشي طلاب المدارس في مجموعات، ويعود البشر ليغمروا المكان.
يومًا بعد آخر رسّخ جسر الرئيس نفسه كجسر ديستوبي، كمكان كان ليفضله المشردون الذين عاشوا في أنفاق مدينة نيويورك في سبعينيات القرن العشرين. تراجعت منذ سنوات خدمات التنظيف، وانهار حافز العامل على بذل الجهد، فأخذ تتصاعد روائح تخمرات وتفاعلات بين مواد لا تزول بالتنظيف اليومي، يحتاج التخلص منها إلى إعصار أو حمم بركانية ينفثها قاسيون، ثم الانتظار حتى يُنظِّف الرماد وجه الإسمنت ثم يغسل المطر كل ما كان.
منذ أيام أزالت محافظة دمشق بسطات الكتب المستعملة تحت جسر الرئيس، بغرض تجميل المكان، فالمدينة لم تعد منذ زمن طويل حلم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عندما زارها عام 1952 وأقسم على جعل كوالالمبور نسخة عنها، كما يحلو للسوريين الترويج على مواقع التواصل. الآن، بعدما أغلقت جلّ مكتبات العاصمة جراء فقر السوريين وعدم قدرتهم على شراء كتاب جديد، قرر المسؤولون أنّ عمليات التجميل ستبدأ أولًا بالقضاء على الكتب المستعملة، المشهد الوحيد الذي يذكّر العابرين المتعبين بمعنى الكتاب وما يمثله من قيمة وجمال.
خلال دراستي في الجامعة كنت أتردد باستمرار على بسطات جسر الرئيس وشارع الحلبوني المجاور، أبحث بجانب مناهج الجامعة في القانون أو المالية أو قوانين الجسم الصلب، عن رواية أو ديوان شعر أو كتاب فلسفة، وأمضي وقتًا لا بأس به في التفتيش عمّا يقد يعنيني بين كتيّبات توقعات الأبراج وتعلم اللغات في بضعة أيام وروايات باولو كويلو ودان براون.
خلال الحرب عُفّشت بيوت السوريين الذين هُجّروا، سُرق الأثاث ونُهبت الأغراض وحُمّلت مكتبات الشغوفين بالقراءة في الشاحنات بجوار البرادات والغسالات والمكانس الكهربائية. أحيانًا تُركت الكتب بين الركام ليجمعها الجنود لاحقًا ويتدفؤون على نارها خلال الشتاء. المكتبات المعفّشة بيعت بالكيلو لتجار المواد القابلة لإعادة التدوير، وبعضها اشتراه أصحاب البسطات، ممن دأبوا على دفع مبلغ مقطوع للذين نووا مغادرة البلاد وبيع المنزل والأثاث والمكتبة التي جمعهوها كتابًا بعد كتاب.
في شهر أيار/مايو من العام 2022، بعد تسريب مشاهد لضابط يُعدم مدنيين في حي التضامن شرقي دمشق ويلقيهم داخل حفرة تمتلأ بالجثث، صدر عفو رئاسي عام، ليأتي أهالي المعتقلين والمفقودين من كل حدب وصوب، ولتتجمع تحت جسر الرئيس آلاف المآسي والقصص. الآباء والأمهات كبروا أكثر مما ينبغي، طبقات الدمع متجمدة في عيون الجميع، الوجوه متلهفة، أصوات تمتمة ودعاء، مشاعر قنوط وأمل تغطي عليها زحمة تكهنات.
خرج المئات فحسب من بين عشرات آلاف المغيّبين في سجون النظام. عندما كان يصل أحد المفرج عنهم كانوا يتجمهرون حوله، يسألونه إن رآى فلانًا أو سمع عنه، اسمه محمد، منصور، علي.. هذه صورته، انظر جيدًا. هناك أمٌّ لم تصدّق أن ذاك الجسد العاري والهزيل الذي رأته مرميًا قرب جدار أصفر في إحدى الصور التي هرّبها قيصر من المعتقلات، هو لجثة ابنها، قالت بصرامة إن هذا الوجه الغائر ليس له، هاتين العينين المتحجرتين ليستا عينيه، لذا قررت المجيء والوقوف بين الناس، وانتظار ابنها تحت جسر الرئيس.