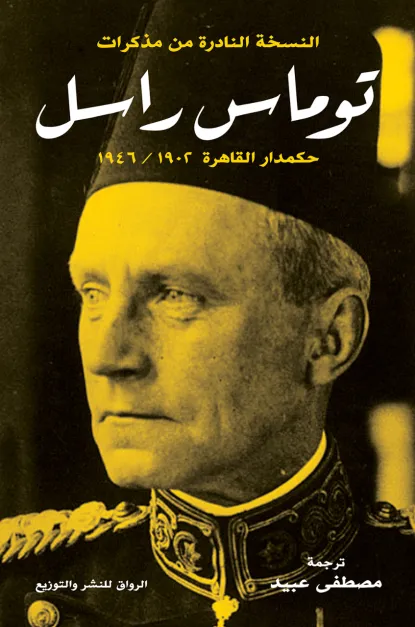واجه محمد علي صعوبات عديدة في طريقه إلى بناء جيش ينفّذ طموحاته بدايات القرن التاسع عشر، ومن بين هذه الصعوبات "مرض الحنين إلى الوطن" الذي أصاب الجنود الفلاحين، وهذا توصيف كلوت بيك كبير أطباء الجيش آنذاك. لم يخترع كلوت بك هذا المصطلح، فالنوستالجيا موجودة في العالم منذ القرن السابع عشر، حيث صاغها طالب الطب يوهانس هوفر كوصف طبي للأعراض الجسدية والنفسية التي تصيب المبتعدين عن أوطانهم طوعًا أو قسرًا، وتودي بحياتهم أحيانًا.
ومع الوقت، خلع المصطلح رداءه الطبي وتحول إلى مفهوم ثقافي يعبر عن توقٍ للماضي بشكل عام. وفي مصر، يتمثل هذا التوق، كما نصادفه كثيرًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة قديمة للقاهرة للتعبير عن الحنين لقرن أصبح جزءًا من تاريخ بعيد.
وفي سياقنا، تُعبّر النوستالجيا عن نفسها بالصورة وتستبعد الكلمة، فلا وجود للمجلات والجرائد والنتاجات الثقافية للقرن العشرين، ولا تكون النوستالجيا استدعاءً للأرشيف لدراسته ونقده، بل مداعبةً لطيف ضبابي من المشاعر يختصر الحياة في ثنائية الماضي الجميل في مواجهة الحاضر السيئ، لتقديم تفسير سريع واستهلاكي لمعضلة اللحظة الحالية.
رغم ذلك، يمكن توجيه تلك المشاعر للتنقيب في ماضي القاهرة من خلال مصادر أخرى تكون فيها الصورة مرشدة للكلمة دون أن تستحوذ على حصرية رواية الماضي. وعلى هذا الأساس، سنتناول في هذه المقالة فترة النوستالجيا المصرية المفضلة، أي النصف الأول من القرن العشرين، اعتمادًا على مذكرات الضابط الإنجليزي توماس راسل "مذكرات توماس راسل: حكمدار القاهرة 1902 – 1946" (الرواق للنشر والتوزيع، 2020/ ترجمة مصطفى عبيد).
الصائد توماس
أصابت وفاة الباشا الأسرة العلوية في مقتل، حتى وصلت في بداية القرن العشرين إلى مرحلة تتشارك فيها السلطة والثروة مع أطراف داخلية مثل طبقة الملاك الزراعيين والأثرياء الجدد، وخارجية مثل الاحتلال الإنجليزي الذي لم يحكم بالسلاح فقط، بل لزمه جهاز إداري محترف يعمق وجوده.
كان توماس راسل واحدًا من هؤلاء الموظفين الملتحقين بوزارة الداخلية المصرية، ولم يعلم حينها بأن مدة خدمته ستمتد إلى 44 عامًا، خدم خلالها في 32 حكومة كنائب مفتش، ثم مفتش، ثم نائب حكمدار الإسكندرية حتى عام 1913، ثم حكمدار القاهرة حتى 1946.
يبدأ راسل مذكراته بشكل تقليدي فيستعرض أصوله العائلية عن طريق وصف لوحة زيتية لجده الدوق السادس لبلدة غلدفور بجانب جده تشارلز وأخيه اللورد جون راسل، الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا مرتين. يقف الثلاثة حاملين بنادقهم مستعدين للانطلاق في رحلة صيد، وهي الهواية التي تعكس تراث العائلة وستترسخ في مسيرة راسل المهنية.
يتذكر راسل طفولة سعيدة رغم وفاة والدته المبكرة، إذ قام والده هنري راسل بتنشئته رفقة إخوته في فسيحة، حيث تظهر المساحات الشاسعة والغابات الممتدة بانتظام خلال مراحل نشأته.
تعّلم توماس في مراحل طفولته المبكرة مهارات صيد السمك والفئران، ثم انتقل إلى مدرسة هيلبري العسكرية وتنامى اهتمامه بالصيد والطبيعة، إذ يحكي قصص سفره بعيدًا عن المدرسة ليزور غابةً مملوكة للسير جورج فادول عمدة لندن، ثم ينهي مسيرته التعليمية في الكلية اللاهوتية بكامبريدج، حيث كان يقضي وقت فراغه بقيادة عربة تجرها كلابه، ضمن تخليصه حقول المزارعين من الفئران.

شهدت تلك الفترة بداية تفكيره في مستقبله المهني، وتلقى في تلك المرحلة دعوة لقضاء شهر في بيت إسكتلندي. وفي خضم هذا التخبط، التقى بابن عمه بيرثي ماتشيل، الذي يعمل مستشارًا لوزارة الداخلية المصرية، والذي أثار فضوله تجاه مصر وعرض عليه فرصة لزيارته. من تلك الخلفية الاستكشافية المتصلة بالطبيعة والصيد، سيتشكل مسار توماس الوظيفي وسيتشابك مع تراثه العائلي كمُطارد، إذ ستظهر صفات الصيادين المحنكين التي استقاها من مشارب مختلفة بعد عدة أعوام، عندما انتقل من مراقبة الغابات والبحيرات إلى مراقبة مدينة تشهد مجتمعًا متنوعًا ونشطًا مثل القاهرة بدايات القرن العشرين.
نحو مصر
في العام الأول من القرن العشرين، سافر توماس على متن سفينة متجهة نحو بورسعيد لنقل دفعة مفتشين جدد لوزارة الداخلية، وقد نجحت الإطلالة النيلية لبيت ماتشيل، ورحلات صيد البط في قرى الجيزة، والرقص في ملاهي القاهرة، بإقناعه بأنه وجد ضالته ليعود في العام التالي كمتدرب في مستودع خفر السواحل بالمكس.
وبين السير بمحاذاة الشاطئ والاختباء بين الصخور في انتظار مهربي الحشيش والعمل في قسم المنشية واللبان، يحكي راسل عن المواقف التي واجهها في شهوره الأولى أثناء محاولته التأقلم مع اللغتين اللتين لم يدرسهما، العربية والتركية، قبل تعيينه كنائب مفتش بمحافظة البحيرة.
يمكن ملاحظة الهوى الاستشراقي في مذكرات راسل، التي تقدم نفسها كقصص بوليسية مثيرة ذات خلفية سياسية واجتماعية لحياة غير اعتيادية، يرويها رجل متقاعد يعصر فيها ذاكرته بأسلوب البطل الأبيض الذي يكتشف أماكن غامضة ساحرة غير متحضرة.
يتنقل راسل بين القصة والأخرى حسب الموضوع لا التسلسل الزمني، ويتفاخر بأنه زار كل مديريات مصر من أسوان إلى الإسكندرية لأداء واجباته الوظيفية. وبجانب ذلك، زار كل الصحاري لأنه لم ينس هواية العائلة المفضلة: الصيد. وقد ساعدته تلك الجولات في التعرف الدقيق على الجغرافيا والسكان وأصولهم وعاداتهم ووسائل النجاة. وبالتوازي مع ذلك، منحته الغرفة الدائمة في بيت ابن عمه ميتشل بالزمالك الفرصة للاقتراب من عالم المسؤولين البريطانيين رفيعي المستوى، مثل السير وليم جارستين والسير إلدون جورست وغيرهما ممن يعتبرون الذراع اليمنى للورد كرومر، ومنحه ذلك الدنو القدرة على رؤية مصر من نافذتين مختلفتين.
التشريح الاجتماعي
يقدم راسل نفسه كضابط شرطة غير تقليدي يغلب على تفكيره الطابع التحليلي والإبداعي، ويلجأ إلى حلول غير تقليدية. ورغم موقعه السلطوي، إلا أنه يطرق أبوابًا بعيدة عن وعي السلطة التقليدية، فنراه في بداية مسيرته التي قضاها بين الأرياف والصعيد يصطدم بقضايا القتل، فيحلل الأرقام ليصل إلى أن هناك جريمة قتل تقع في الريف كل ثلاث ساعات، إذن لماذا يقتل الريفيون؟
يحلل راسل كذلك ظروف حياة الفلاح اجتماعيًا واقتصاديًا، ويصفه بأنه: "شخص بائس، مسالم، يعمل بجدية ولديه حس عظيم بالفكاهة"، ولكنه قادر على التحول لقاتل في ثوانٍ، ويُعيد الأمر إلى ابتعاده عن "التحضر" واعتماده على قوانين اجتماعية داخلية تنظم مسألة الثأر وتورثه كفخر اجتماعي.
وخلال كل هذا، يجب التذكر والتنبه إلى أن راسل في النهاية عضو في جهاز إداري لدولة محتلة، ورغم تمييزي لقدراته كإنسان ذكي وغير تقليدي، ولكن تحليله أحيانًا ينتهي إلى تصورات استشراقية، فيرى الأمر مقصورًا على وصول الحضارة لتلك العزب والقرى المنعزلة، وأن الأمر يكمن في القضاء على فردية الفلاح ودمجه في المجتمع الحديث، ونراه في مقاطع أخرى يتحدث عن غالبية الفلاحين بوصفهم: "أغبياء غير قادرين على التفكير"، في تجاهل لمئات السنوات من الإقطاع والتعذيب والسخرة التي أفقدتهم الثقة في الدولة والمجتمع، وجعلته: "لا يثق بأحد سوى نفسه وعائلته" كما يقول في موقع آخر.
يظهر راسل في القصص كموظف مثالي دؤوب يعمل داخل نظام لا يحكم بقواعد قاطعة تحسم أصغر التفاصيل، مما يعطيه مساحة التصرف الفردي بقوة السلطة الواسعة، التي يتمتع بها المفتشين البريطانيين في مديريات مصر، فهم ليسوا رجال أمن وحسب، بل لديهم اختصاصات متباينة مثل المرور على الحقول لمتابعة عمل جامعي الدود، والعمل مع الأطباء لفحص ماشية الفلاحين، والدخول للصحراء عند هبوب الجراد لتنظيم قوات مكافحته.
هذا التوسع في المسؤوليات في بلد ضخم المساحة ناسب المزاج الاستكشافي لصياد مثل راسل، وظهر في الدراسات التي جمعها عن فئات اجتماعية فرعية، مثل حواة الأفاعي، والغجر، وقصاصي الأثر. وقد مكّنت تلك الحرية راسل من إدخال آليات جديدة للنظام الأمني والنيابي المصري، مثل إقناعه النيابة في 1907 باعتماد قص أثر الأقدام في الصحراء كدليل جنائي يساوي بصمات اليد بعد تجربته في مطاردة سارقي الحيوانات في عبر صحاري الصعيد، فيما كان ينفذ الأوامر حتى لو امتلك موقفًا ضدها.
نرى هذا التضارب في 1904 عندما طارد سارقي أحواض الملح في الصحراء الشرقية، لكنه ينتقد الحكومة بعدها بأربعين عامًا لمنحها شركة أجنبية الحق الحصري باستخراج الملح، مما حول السكان لمجرمين. كما يتصرف كمصلح اجتماعي في 1908، فيقيم صلح بين قبيلتي المعزة والعبابدة لإنهاء موجة من القتل. ومن مراقبته للأحداث، يظهر إعجابه باحتفاظ سكان الصحراء بتراثهم وعادات أجدادهم، وينعى بحزن انتهاء مظاهر تلك الحياة البرية ودخول السيارات للصحراء وتلويثها الأرض "بالزيت الأسن والبترول".
ويمكننا ملاحظة التناقض بين تقييمه للفلاحين والعرب رغم بُعدهما عن "التحضر"، وتشاركهما مسألة الثأر وتجاهل سلطة الدولة، وأنه يمتلك تلك النوعية من الآراء المتناقضة أحيانًا.
المجتمع السفلي للقاهرة
استيعاب عالم القاهرة صعب للأغراب، ولا يتغير هذا القانون كثيرًا عندما تعيدنا القصص لمائة عام للخلف، عندما تم نُقل راسل في 1913 من منصب نائب حكمدار الإسكندرية لشغل المنصب نفسه في القاهرة واعتبرها ترقية، ولكنه سرعان ما اكتشف أن سلطاته مبتورة. وبالنسبة لرجل يبحث عن القيادة والسلطة، فالأمر ليس هينًا، إذ كانت القاهرة تحت سلطة ليو هارفي باشا الذي يصفه بالإسكتلندي الشجاع، وكان ذراعه الأيمن رجل شامي يدير مكتب البوليس السياسي، الذي سيتصادم معه راسل بعد وصوله العاصمة بفترة ويشتبك معه في صراع طاحن، وستكون تلك القضية بمثابة تقديم أوراق اعتماده لكسب ولاء أفراد الشرطة ليتوّج في 1917 بمنصب حكمدار القاهرة خلفًا للمتقاعد هارفي باشا.
يحّدثنا راسل عن المجتمع السفلي للقاهرة أوائل القرن، سيتذكّر الدعارة والمناطق الأكثر صيتًا مثل وش البركة بالأزبكية، وحي النسوة الأوروبيات العاملات بالجنس، والوسعة أشهر مناطق الدعارة المحلية للنسوة المصريات والسودانيات والنوبيات، وكانت تحت إدارة الرجل النوبي الغامض إبراهيم الغربي، الذي يتحدث عن غموضه فيصفه جالسًا فوق أحد الدكك الخشبية أمام منزله بملابس نسائية وشعر مستعار، ويد مثقلة بالذهب مرخية للطريق ليقبلها المارة، الغربي ليس مجرد قواد عادي، بل صاحب ثروة ونفوذ ممتد حتى النخب السياسية المحلية ومجتمع الصفوة ولديه سيرة ذاتية غامضة، ولكنه انضم لقائمة الأقوياء الذين أسقطهم توماس بشكل أو بآخر.
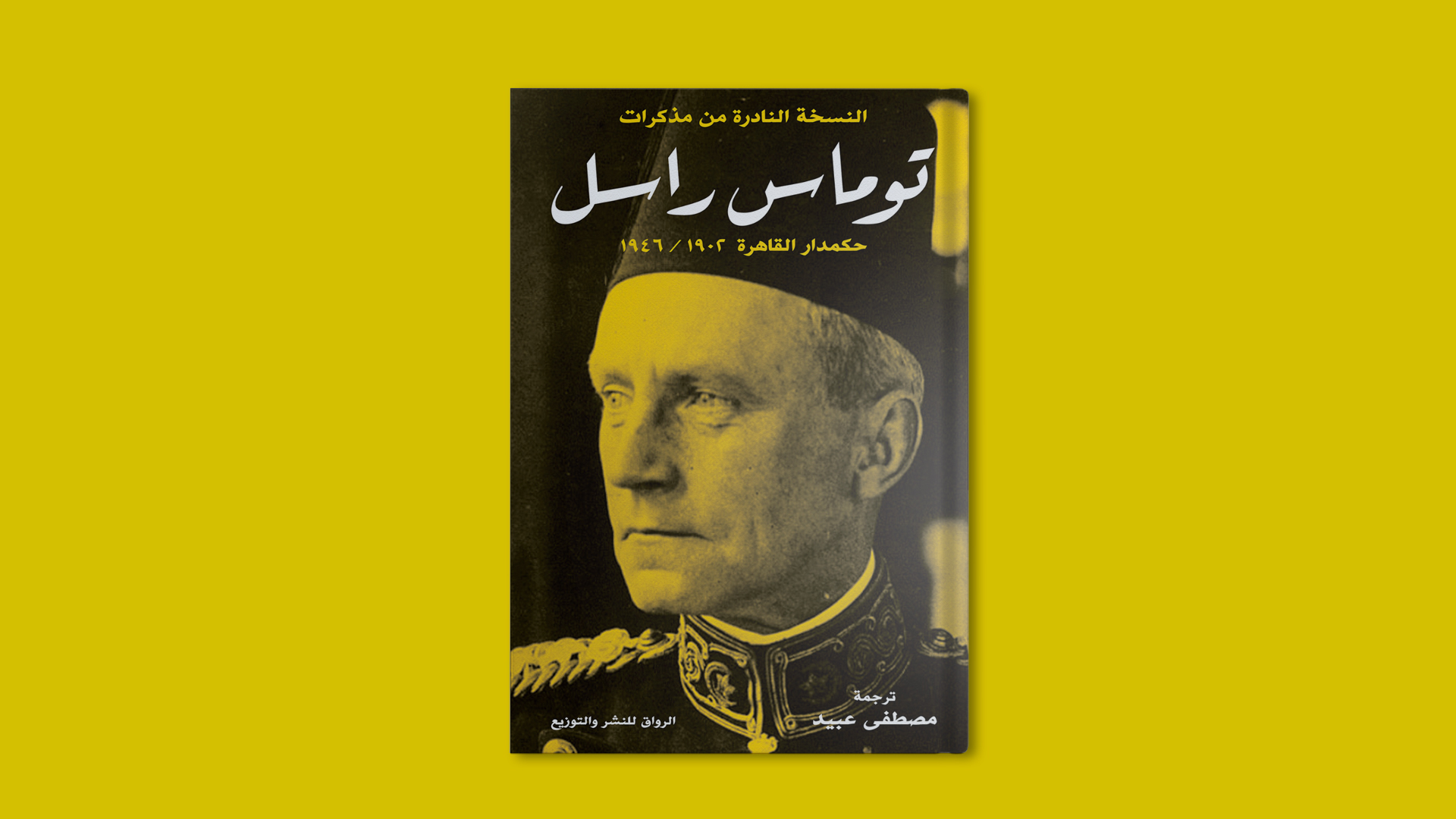
دراسات راسل الجانبية تظهر في مواضع مفاجئة وسط الأحداث وتمتد لأوجه غير مألوفة، مثل طلبه من وزارة التضامن الاجتماعي إعداد بحث بأحوال رجال الشرطة المادية والاجتماعية لتحسينها، وسؤاله لأحد المتورطين في جريمة سياسية، قبل إعدامه، عن أفضل الطرق لتثبيط منفذي الاغتيالات لحل مشكلة عدم قدرة الشرطة على مواجهة الاغتيالات ضد الوزراء المصريين.
لقد خرج أشراس المدينة
تمكننا المذكرات من محاكاة التواجد في شوارع العاصمة أثناء ثورة 1919 التي روى عنها في فصلين. الأحداث أشبه بيوميات تبدأ من 7 آذار/مارس حتى نهاية نيسان/أبريل، حيث نتحرك في شوارع وأزقة القاهرة لنرى تكتيكات راسل في التعامل مع مظاهرات طلبة الأزهر ومحاولات قمعها.
الملاحظ في أدائه أثناء الثورة أنه يتصرف كإصلاحي في حكومة متطرفة مهمته تخفيف وطأة القرارات القادمة من القيادة الإنجليزية، فيعطل قرار اللورد اللنبي باحتلال الجامع الأزهر، ويظهر بعض الحكمة عندما يصف سعد زغلول بالبطل الوطني الذي عومل بطريقة غير حسنة من بريطانيا، ويصف دور مكتبه أثناء الثورة بالدور المسؤول غير المقبول، لأن رجل الشرطة: "يجب أن يقف دائمًا في صف القانون والأوامر، بعد أن يتعاطف مع موقف المصريين بقوة". ومن جديد تخونه قدراته التحليلية عندما يصف مظاهر العنف التي انفجرت في العاصمة بالغوغائية، ويصف الوضع في يوم 9 نيسان/أبريل في رسالة لوالده، بالقول: "لقد خرج أشراس المدينة ليقطعوا أسلاك الهاتف ويحصنوا الشوارع وينشروا النهب".
ويتعجب راسل من الغضب الهستيري الذي أصاب شوارع وملامح سكان القاهرة ضد بلاده، ويتبنى التحليل الاستشراقي البسيط بأن العالمين بأحوال الشرق يدركون كيف للجموع أن تشتعل، ذلك التقاطع البراغماتي في منظوره تجاه الثورة يفصح عن وجه آخر لشخصيته وهو وجه أقرب للسياسيين من رجال الأمن ويصادف أن يلعب دورًا سياسيًا من موقعه الأمني في 1932، أثناء معركة بين إسماعيل صدقي رئيس الوزراء والوفديين بقيادة مصطفى النحاس عندما منعته الحكومة من القيام بجولات سياسية في المحافظات لتحديد تأثيره.
لكنه لم يخضع للقرار وقرر السفر بالقطار، وتجاوز الوفديون كردون الشرطة الهزيل أمام المحطة و قفزوا في القاطرة الأولى، ولكن إدارة السكة الحديد فصلت القاطرة عن القطار ليغادر دونهم ويتحرك قطار آخر بهم، ليقرروا الاعتصام وعدم مغادرة القاطرة ويتعقد الموقف بحيث اضطر راسل لتحريك القطار إلى طرة والذهاب بنفسه لقيادة مفاوضات الأزمة وإنهائها بحنكة سياسي.
كوكايين وحشيش وهيروين
تقدم المذكرات خريطة للمخدرات في مصر أوائل القرن المنصرم، فتقسمها لمخدرات بيضاء مثل الكوكايين والهيروين والمورفين، ومخدرات سوداء كالحشيش والأفيون. وتروي قصص التهريب التقليدية والغريبة للمخدرات القادمة من أوروبا وليبيا سوريا ولبنان. كما تؤرخ ظهور الكوكايين والهيروين في مصر كعقار يباع في الصيدليات بحرية أثناء انشغال الإدارة الأمنية بالحرب العالمية الأولى، ثم ثورة 1919 والاغتيالات السياسية، مما أفسح المجال للمخدر الأبيض للانتشار السريع في مصر.
وبمجرد خفوت الاهتمام بالسياسة، عدّل راسل استهدافه صوب المخدرات، وساهم في إصدار قانون 1925 كأول قانون موجه للمخدرات الجديدة، ويقدم راسل في هذا الفصل دراساته الجانبية عن التجار المحليين والأجانب ومصانع الإنتاج في أوروبا.
ويذكر الحشيش مخدر المصريين المفضل، ويصفه بأحد رذائل المصريين، حيث أنشأ راسل مكتبًا مركزيًا لاستخبارات المخدرات بميزانية عشرة آلاف جنيه، ووجه استراتيجية المكتب لاستهداف التجار الأجانب ومنافذ التهريب مثل الموانئ والصحاري. وفي 1946، عندما كتب المذكرات، فسّر راسل إنهاء التغول العنيف للمخدرات الإدمانية في مصر لإلغاء الامتيازات الأجنبية.
تقدم لنا المذكرات صورة عن مصر أخرى، وتكشف لنا عن شخصيات وقصص غريبة واستثنائية وتنوع عرقي واسع، تبدأ بحكايات متناثرة في كل نواحي مصر حتى واحة سيوة، ثم تعود للقاهرة التي يعزي راسل فهمها للفترات التي قضاها في الريف والصعيد، والتي مكنته من دراسة المصريين لمحاولة فهمهم، مما ميزه عن رفاقه الذين لم يغادروا العاصمة.
ويصف مذكراته بأنها ليست تسجيل لحياة شرطي، بل لجانب كبير من تاريخ الناس ويتمسك بوصف مسيرته كمساعدة لخدمة المصريين لاتخاذ طريقهم للحكم الذاتي، الذي تحقق بالاستقلال ليضيف تناقضًا آخر لسيرته. فهو لا يتصرف كمحتل في أي موقع من المذكرات، ويصف المصريين في النهاية بالكرام الذين لم يخذلوه أبدًا. وبهذه العواطف المركبة، ينتهي راسل بوصف مصر بالبلد ذات الفتنة والجمال كخاتمة استشراقية تقليدية لمستشرق غير تقليدي.